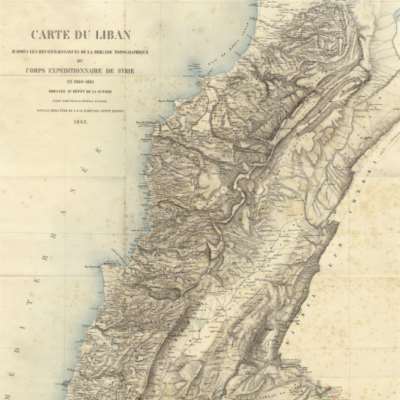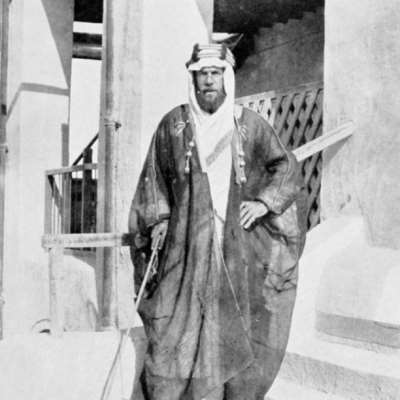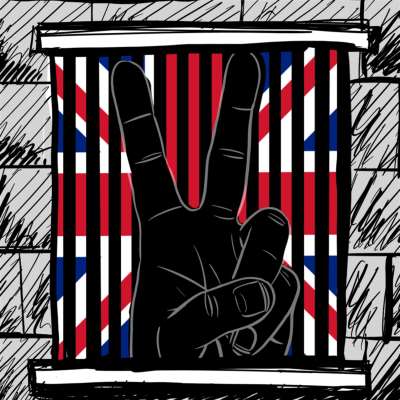في أثر الرسولالطريق ما بين مكّة والمدينة وَعِرَة تتخلّلها جبالٌ قاسية. وعندما هاجر الرسول مِن مكّة إلى المدينة، اختار مِن الطرق أكثرها وعورةً ليعرقل الذين اقتفوا أثره ويتخفّى منهم في الجبال والكهوف. لنتذكّر أنّ هذه الدعوة بدأت كدعوةٍ ثورية ضدّ قوى الأمر الواقع، وأنّ زعيمها عليه الصلاة والسلام كان هارباً وخارجاً على القانون (وبينما كان للدعوة السلميّة وحتّى المهادنة والصبر على الأذى وقتها، فإنّ رسول الله لم يكن مقاوماً «غاندياً» أو «سقراطياً» يذعنُ للقانون ويسلّم نفسه لقوى الأمر الواقع، وإنما قرّر أن يخرج على القانون ويهرب مِن النظام القائم قبْل أنْ يعود إليه غازياً وفاتحاً). طبعاً، لحظة الدعوة والتأسيس تختلف عن لحظة الانتشار وعن مدة الاستقرار بعد ذلك، ولكن يجب أن نسأل دائماً ما الذي نخسره مِن ديننا عندما نختزله في أمرٍ واقعٍ قائم، وكيف يصبح في يد البعض أداةً للتدجين والرضى بالوضع القائم على عكس ما كان عليه في بدايته.
وعندما عاد الرسول أوّل مرّة إلى مكّة حاجّاً، لمْ يسمح له النظام القائم بالدخول. في هذه اللحظة جاءه وحيٌ مِن الله بالمهادنة، ولكن هذه المهادنة كانت توطئة لفتح مكّة بعدها بعامين. أكتبُ هذه السطور بينما تأتي الأخبار عن عددٍ غير مسبوق مِن الوفيّات بيْن الحجّاج، أكثر مِن نصفهم مِن فقراء مصر. الذريعة التي يسوقها النظام الرسمي، في المملكة العربية السعودية وفي مصر، هي أنّ هؤلاء لم يكونوا حجّاجاً رسميين ولذا انتفى حقّهم في الخدمات، وصولاً إلى خدمة الإسعاف التي لمْ تنجدهم في الوقت المناسب. طبعاً الأعمار بيد الله وعسى أن يكون موت هؤلاء في الحجّ تعظيماً لمنزلتهم، ومسألة الحجّ غيْر الرسمي مسألة لست مؤهّلاً للخوض فيها (على الأقلّ حتى لا أسهم في تزيين مخاطرة قد تودي بحياة الإنسان ولا أبرّئ شركات السياحة التي تاجرت بتقوى عملائها وبحياتهم)، وموقف الرسول نفسه وقتها قد يُستنبط منه جواز التحلّل والرجوع لِمَن حِيل دونه والحجّ، ولكن ليتذكّر الذين يتذرّعون بالتصريح الرسمي أنّ رسول الله عندما ذهب للحجّ أوّل مرّة لمْ يعطوه تصريحاً رسمياً. ثمّ ليتذكّروا، وهم يمرّون جوار جثث الأموات أو يستمعون إلى نحيب أقاربهم، هرولةَ الأمّ المذعورة التي ننتسب إليها.
على خطى أمٍّ فزعة على مصير ابنها
عندما ترك نبي الله إبراهيم هاجر وإسماعيل (عليهم السلام جميعاً) «بوادٍ غيْر ذي زرع» أخذَت تهرول بيْن الصفا والمروة وهي تدعو الله حتّى تفجَّر بيْن يديها ماءُ زمزم الذي ما زال مباركاً في عرفنا معشر المسلمين، وما زلنا نسير، حرفياً، على خطاها.
نحن أمّة تنتسب، في ما تنتسب، إلى دعاء أمٍّ مكلومة وإلى خوفها على ابنها، أو هذه إحدى البدايات (طبعاً مسألة البدايات دائماً موضع التباس وجدل وحتّى إنْ دخلنا في مسألة أبناء سارة وأبناء هاجر التي لا أحبّ الخوض فيها لأنها تسطّح الصراع مع الصهيونية وتمنح المستوطنين اليهود الأوروبيين رابطاً لا يستحقّونه مع تراث هذه المنطقة، فإنّ لنا أنْ نتأمّل في انتسابنا إلى الجارية التي وَجَدَتْ نفسها وابَنها مهجّرَين في الصحراء وكيف يستحيل أنْ نكون أمّةً وسطاً تشهدُ على الناس لو كانت حكايتنا بدأتْ بسيّدة الدار التي هجّرتها).
لا يكفي أن ننتسب إلى هذه الحكاية التأسيسية، بل إنّ إعادة تمثيلها وتمَثُّلها ركنٌ مِن أركان الإسلام. إذ نسعى بيْن الصفا والمروة في الحجّ والعمرة، يَذهَلُ بعضنا عن المعنى الكامن في هذه الطقوس (خاصّة وأبراج التسوّق والساعة القبيحة تغزو الحرم وتهيمن على مشهديته) ويغرق بعضنا في حركة الطقس دون معناه، ولكنّ الطقس ضروريٌّ مِن أجْل احتواء هذه الذاكرة في ممارسةٍ مستمرّة: وعندما يتحوّل السعي إلى هرولة، ونحن نردّد الدعاء «ربّ اغفر وارحم...» فنحن نستحضر شعور الأمّ المفزوعة على ابنها ونعيد تمثيله. وليس مِن المنطقي في هذه اللحظة أنْ ننفصل شعورياً عن مشاهد المكلومين والمذعورين على مصير أبنائهم وأهاليهم، بالذات في فلسطين والسودان، ولا يمكن أنْ تغيب أحداثُ الأمّة عن هذه الطقوس: لأنّ هؤلاء المكلومين هم أهلنا، وأيضاً لأنّ هذه الطقوس تعلِّمنا أنْ نستحضر محنتهم. في هذه الظروف، ينبغي أنْ يصبح الحجّ والعمرة لا تذكرةً مستمرّة بوحدة هذه الأمّة فحسب، ولكن أيضاً انحيازاً مستمرّاً للمكلوم والمهجّر والمظلوم.
* باحث عربي
تأمّلات في شعائر الله