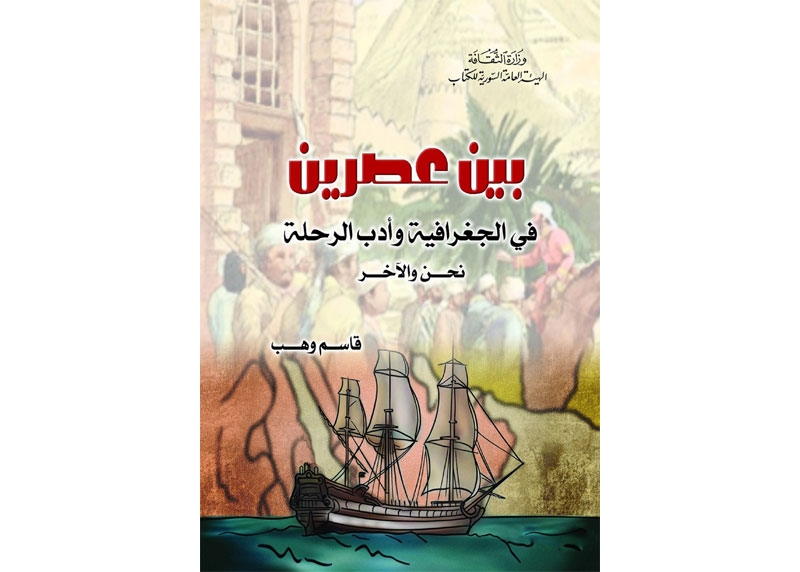يبحر الباحث السوري مع أبرز الرحّالة العرب ونظرتهم إلى الآخر، وفي مقدمهم المسعودي
ركاكة التعبير تشير إلى أن من دوّن وقائع هذه الرحلة هو أحد مرافقي الأمير. هكذا استأجر الأمير وحاشيته ثلاثة مراكب «بخمسة آلاف ذهب» لكل مركب، وأبحروا جميعاً، وصولاً إلى صقلية ثم مدينة بيزا التي أذهل برجها المشهور الأمير وحاشيته (وفي وسط المدينة المذكورة ثلاثة جسور عظام، وفي هذه المدينة «المادنة العوجا» معلقين فيها النواقيس لأجل معرفة الساعات، ولإحضار الصلوات. وانعواج هذه المادنة أمر عجيب من صناعة البنايين). يصف مدوّن الرحلة عجائب المدن الإيطالية، وتقاليد المجتمع هناك، والأمور التي تخص النساء «عاداتهم ما تحتجب النسوان عن الرجال لا في الرقص، ولا في الزقاقات، حتى إذا غاب الرجل تقعد المرأة تبيع في الدكان عوضه». وينتبه إلى طريقة تنظيف الشوارع بقوله «وكل يوم يكنس قدام داره لوسط الزقاق، وبيعمله كومه، وتجي دواب على كيس المدينة تنقله، وتشلحه برّات المدينة». ويتوغل في طبائع العيش اليومية، وأنواع الطيور والحيوانات، والبمارستانات ونظامها، والأديرة، والبنوك، والضرائب، والطباعة. ومن المفارقات أن يطلب ملك إسبانيا من الأمير في رسالة اعتناق النصرانية مقابل أرضٍ تعادل المنطقة التي كان يحكمها في بلاده. وكان ردّ الأمير: «ما جينا هذه البلاد لا كرامة دين، ولا كرامة حكم». تنطوي هذه الرحلة على مفارقات كثيرة في طريقة التدوين، وعلى تعطّش الأمير إلى امتصاص مفردات الحضارة الأوروبية بحلم استثمارها في الشرق. النظرة نفسها سنجدها لدى رفاعة الطهطاوي في كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، إذ دوّن انطباعاته عن باريس القرن التاسع عشر، من موقع الإعجاب بقوانين ونظام الحكم، كما نبّه إلى أهمية الفنون في تهذيب الأخلاق: «لو لم تشتمل التياتر في فرنسا على كثير من النزعات الشيطانية، لكانت تعد من الفضائل العظيمة الفائدة» يقول. ويلتفت إلى أسباب التقدّم في العلوم والفنون والصنائع، معوّلاً على أهمية محبة العمل وكره الكسل. وسوف يكمل أحمد فارس الشدياق في رحلته «كشف المخبا عن فنون أوروبا» (1866) ما تجاهله الطهطاوي برؤية متوازنة، كاشفاً عن مزايا العيش في بلاد الإنكليز وصعوباته، فيما سينبهر رحّالة آخر هو خير الدين باشا التونسي بالتقدّم الأوروبي، في مذكراته «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» (1879)، كأنه يدعو إلى عولمة من نوعٍ ما، فالعالم من وجهة نظره «بلدة متّحدة تسكنها أمم متعددة حاجة بعضهم لبعض متأكدة». ورأى أن الأخذ عن الغرب لا يتعارض مع الإسلام، وأن التحديث يحتاج إلى القوانين الناظمة للعدل والحرية، وهما من أصول الشريعة الإسلامية.
رحّالة آخر هو فرنسيس المراش، غادر حلب إلى باريس مفتوناً بالحداثة الأوروبية، وأهمية العلم باعتباره «التتويج الأمثل للعقل». سيصف باريس في كتابه «رحلة باريس» (1867) بأنها «مركز مجد العالم وأعجوبته ومصب أنهار العجائب وموقع أنوار التمدّن والآداب». وكان المرّاش أول من كتب رواية عربية بعنوان «غابة الحق» (1865)، متأثراً بالأفكار التنويرية والتبصير بأهميتها، وفيها يدعو إلى الانتقال من «مملكة التوحّش والعبودية إلى التمدّن» بتطبيق شرائع التمدّن وقوانينه، بعيداً عن أغراض الدين.
من ضفة أخرى، سيضيء جورجي زيدان صاحب مجلة «الهلال» المصرية، في رحلته إلى أوروبا (1912) أسباب النهضة ومتطلباتها بنبذ أمراض الشرق، والإفادة من النهضة الأوروبية مبيّناً «ما يحسنُ أو يقبح من عوامل تلك المدنيّة بالنظر إلى طبائعنا وعاداتنا وأخلاقنا». وإذا كان هؤلاء الرحّالة قد قاموا برحلاتهم بقصد اكتشاف الآخر، فإن الهجرات السورية اللاحقة إلى أميركا وأوروبا، في منتصف القرن التاسع عشر، كانت لأسباب اقتصادية في المقام الأول، بالإضافة إلى اضطهاد المسيحيين في ظل تعسّف الحكم العثماني. وسوف ينشأ أدب المهجر القائم على الحنين وحس الاغتراب، وصولاً إلى كتابة المنفى التي مثّلها بامتياز إدوارد سعيد كصورة نموذجية عن الاقتلاع، و«الشرخ الذي لا التئام له بين الذات، وموطنها الحقيقي». ورأى صاحب «الاستشراق» أنّ الثقافة الغربية في جزء كبير منها هي «نتاج المنفيين، والمهاجرين واللاجئين»، وتالياً فإن النفي تحوّل من عقوبة مختارة وحصرية لأفراد محدودين إلى عقاب جماعي لشعوب وجماعات بكاملها كمحصّلة للحروب والمجاعات وضروب الاضطهاد. على المقلب الآخر، نجد نموذجاً مضاداً يمثّله أمين معلوف في دعوته إلى الاندماج، ذلك أنّ خصوصية عصرنا جعلت من كل البشر مهاجرين وأقليّة «فالجميع مجبرون على العيش في عالم لا يشبه الأرض التي درجوا عليها».
الإحساس بالتمزّق والانشطار والشعور العميق إزاء الهوية المضطربة لدى إدوارد سعيد تقابله الدعوة إلى الانفتاح على الثقافة الإنسانية من دون عقد، وفقاً لتوجهات وكتابات أمين معلوف.
ولكن ماذا بخصوص مهاجري الألفية الثالثة ومدوناتهم المؤجلة؟