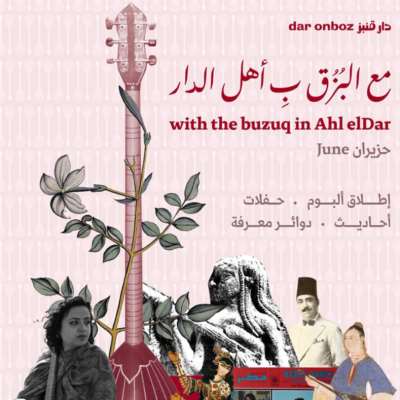لقد ارتبطت شاعريّة الحكيم بمكوِّنينِ أساسيّين؛ لغته الفارسيّة النقيّة وعلاقته الوثيقة بتاريخ بلاده. فكانت رائعتُه «الشاهنامة» (كتاب الملك) أعظمَ ما كُتبَ عن مرحلةٍ تاريخيّةٍ ممتدّةٍ من الإمبراطوريّة الفارسيّة، بلغةٍ فارسيّةٍ أصيلةٍ وصفها بعضهم بالعنصريّة لخلوّها من الاشتقاقات العربيّة التي لم تكن قصيدةٌ فارسيّةٌ تخلو منها في العادة. ستّون ألف بيتٍ يحكي قصّة تاريخٍ من الصراع السياسي والاجتماعي على شكل ملحمةٍ شعريّةٍ زاخرة بالصور الوجدانيّة رغم قسوة الحرب. أبياتٌ أخذت من عمر الشاعر ثلاثين عاماً حتّى أُنجزت، فاستحقّت أن تكونَ إحدى هويّاتِ الإيرانيّين الوطنيّة الثقافيّة، واستحقّ الحكيم أن يخصّص الوطنُ له يوماً في السنة لتكريمه، فكان 15 أيار (مايو) يوم الفردوسي الحكيم، ويوم اللغة الفارسيّة التي عشقَها، فراح يوظّفها لتأريخ مجد بلاده من «كيومرث» حتى «فريدون» و«كاوه» وصولاً إلى مقتل البطل «رستم». فهو لم ينظم الشعر في أساطير بلاده، وإنما وقائع حقيقيّة هي جزءٌ من تاريخ شعبه، فتمحورت رائعته حول جوهر إيران وروحها، رغم أنّها عابرةٌ لحدود الزمان، فيشعر القارئ في كلّ زمانٍ، أنّها تتعلّق بأحداث زمانه. وليس عبثاً إذن، أن يُقالَ في أثرها المؤسّس للوحدة الوطنيّة بين الإيرانيين، إنها بمقام الإلياذة للشعب الإغريقيّ، وإنّ الحكيم هو هوميروس بلاد الفرس، الذي يعود إليه الفضل الأوّل في استعادة كرامة الأدب الفارسي بعد التهديدات التي تعرّضت لها الثقافة الفارسيّة على يد الحكومة العبّاسيّة بعد سقوط الإمبراطوريّة الساسانيّة. في تلك المرحلة، شهد الفردوسي على تعذيب أتباع الديانة الزرادشتيّة التوحيديّة، وعلى حرق المكتبات، ومحاربة اللغة الفارسيّة بعد اعتماد اللغة العربية في البلاد. فكان الحكيم من الذين نهضوا لنجدة حضارة بلاده ولغتها العريقة، وكان قبله الشاعر دقيقي الذي بدأ بكتابة الشاهنامة على شكل منثورٍ ولم يكملها، والرودكي السمرقندي من روّاد الناظمين بالفارسيّة الأصيلة، بعد قرنين من الصمت أمام تهديدات الاحتلال. حفظ الحكيم إرث بلاده، وتأثّر بمنثور دقيقي وعزمَ على استكماله على شكل منظومةٍ ملحميّة. يقول في الشاهنامة، في قتال كاووس مع هاماوران:
«إنّها إيرانُ أرضي هل علِمت؟
أحكمُ العالمَ طُرّا، هل علِمت؟
نحن شعبٌ واحدٌ والله واحد
حسنٌ تاريخُنا لسنا نخاف»
بيدَ أنّه ربّما فات كثيرين، في غمرة الكلام على رائعته الشاهنامة، وعلى لغته الزاخرة بالدلالات وجمالية البيان وبلاغة القول، وعلى رسائل النصح والحكمة التي تنبّه الإنسان إلى غدر الزمان ومكائد الدهر، فاتَهم أن يحكوا قصّة فقره في أواخر عمره وإجحاف الملك محمود الغزنوي بحقّه. لقد كان أبو القاسم في شبابه مترفاً، ورث عن أبيه الثروة واستطاع بفضلها التفرّغ لتحصيل العلوم وإنجاز القراءات الواسعة في تاريخ ملوك الفرس والفلسفة والأدبين الفارسي والعربي والحضارة الإسلاميّة. إلا أنه في المراحل اللاحقة من حياته، فقدَ ثروته الماليّة، وراح ينظم «الشاهنامة» حتى أنجزها وقدّمها إلى السلطان محمود الغزنوي علّه ينال جائزته الماليّة كما كان قد وعدَه. إلا أنّ السلطان محمود تجاهله وردّه خائباً. وبعد مدةٍ وجيزة، اطّلع على «الشاهنامة» بتمعّن، وندمَ على معاملته السيّئة له، وأدرك قيمة هذا الرجل الحكيم وفرادة إبداعه، فأرسل في طلبه، إلّا أنّ الموت كان قد سبقه إليه. وفي هذا الأمر تفصيلاتٌ وردَت في عدّة مصادر حول تعامل السلطان محمود تجاه الحكيم ومنظومته، والمتّفق عليه أنّ الحكيم قضى أواخر عمره في ضيقٍ ماديّ وحسرةٍ على جفاء الملوك تجاهه وإجحافهم بحقّ إبداعه. ومن أهمّ الأسباب التي خلّدت الشاهنامة في ذاكرة الإيرانيّين، القصّة التراجيديّة لبطل «الشاهنامة»، رستم، وهو من أبطال إيران الذين قاتلوا الشياطين والملوك، غير أنّه في إحدى المعارك، يقتل ولدَه سهراب بالخطأ بطريقةٍ مأساويّة، قبل أن يدرك بأنّه ابنه.
يقول الحكيم في أحد أبياته:
«ثلاثونَ عاماً من أسى عمري مضى
عزائي بأن أحيَيتُ شعبي بآدابي
ومن نظميَ المكتوبِ قد شيّدتُ قصراً
متيناً فلا تُثنيهِ ريحٌ ولا مطرُ»
ويقول في دوره الكبير في حفظ اللغة الفارسيّة الأصيلة:
يخرُّ على الدهرِ كلُّ بناء
بقَطرِ السحابِ وحَرٍّ ذُكاء
بنَيتُ من الشعرِ صَرحاً أغرّ
يُمِلُّ الرياحَ ويُعيي المطر