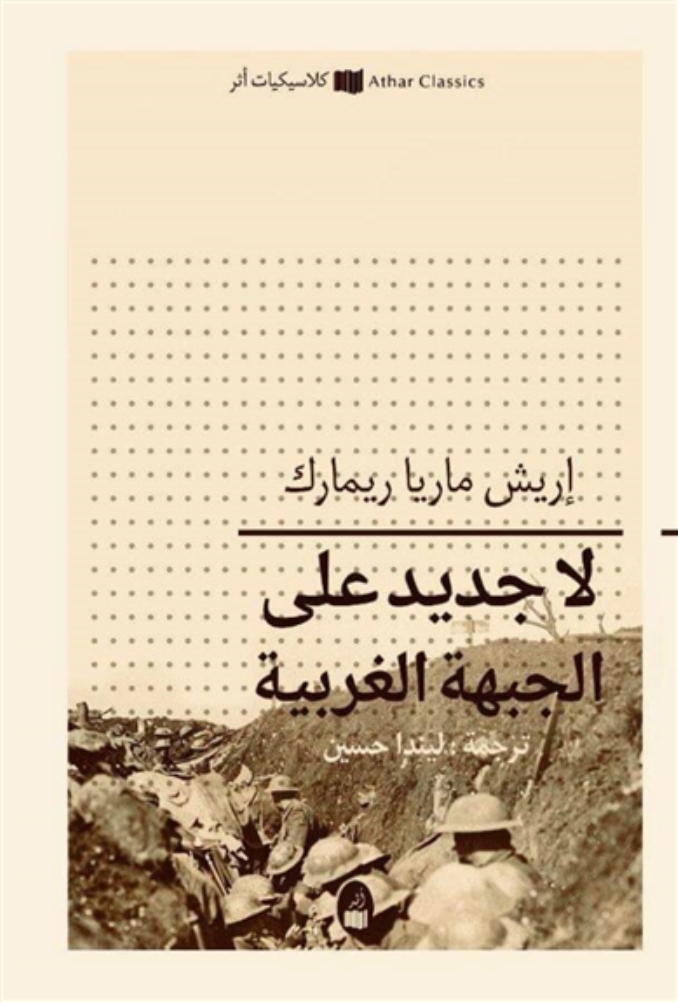
يبحث الإنسان في روايات إريك ماريا ريمارك ـــ برغم كل ما يحيط بها من حروب ودمار ـــ عن الحب والصداقة. كأن الحياة برغم كل مآسيها وحروبها، يجب أن يتواجد فيها الحب، كأنه مكافأة لما يلحق بالإنسان من أضرار، إذ أنّه برواية «ثلاثة رفاق» (الصادرة أيضاً عن «دار أثر»)، يصور رفاهية من نوع آخر، رفاهية المشاعر رغم الحطام والدمار، وفي الوقت ذاته يمنح من يقتل من أجل الوطن فرصة أن يقول ما يريد ويعبر عما يشاء من دون أن يؤثر عليه أحد، فريمارك لا يمارس أي سلطة أبوية على أبطاله، كي لا يجعلهم نسخاً لا تشبه الواقع ولا الخيال، نسخاً مشوهة، لا بوصلة تقودها للحقيقة، ولا خيال يشفع لها ما ستقوله.
يعرف ريمارك متى يكتب عن الألم، وعن الحب، وعن الصداقة. يعرف متى يجعل القارئ يستوعب فكرة الصداقة ضمن إطارها المعين، ومتى يجعل الحرب فكرة غير مستساغة، لكنها تقرأ كتجربة حياتية سيتأثر بها كل واحد فينا. سيتأثر قارئ ريمارك في عصرنا الحالي بالحروب، لكنه سرعان ما يدرك أن ما كتبه ريمارك ذلك الوقت، ما زال موجوداً إلى الآن. باق ويتمدد، فقط اتخذ أسماء عدة، فالإنسان اليوم، ما زال يموت بالوحشية ذاتها، فبشاعة الحرب صارت الآن صورة نراها في كل المواقع، ونتحسس جراحها جرحاً جرحاً، وإن شعرنا بالعجز، لكنه كاف برأيي ليجعلنا دائماً على قيد إنسانية باتت تحتضر.
يكتب: «ريمارك ما لا يريده الناس أن يكتب... فهو يكتب ضد الزمن» على حد تعبير أحدهم، ولعل هذا التعبير دقيق بما يكفي ليعبر عن كتابات ريمارك التي تتناول الحرب بطريقة مختلفة تماماً، ولربما بشيء من العمق في الطرح يتجاوز السطحية التي يخوص فيها من اعتاد الكتابة عن أي شيء. ريمارك لا يكتب الحرب بل بجعلك تعيشها، يقول: «هذا الماء الخفيف العكر المتسخ هو ما يبحث عنه الأسرى، يغرفونه بنهم من الحاويات النتنة، ويحملونه تحت ستراتهم مبتعدين».
تحيلنا قراءة روايات ريمارك في هذا العصر، الذي يشهد تطوراً تكتنولوجياً كبيراً، وفي الوقت ذاته تعدد أوجه الحرب فيه، إلى قول والتر بتيامين: «لكي تكتب التاريخ، يجب أن تستشهد به، لكي تكتب الماضي، عليك مواجهة التاريخ». فرواية «لا جديد على الجبهة الغربية» تجعلك في مواجهة التاريخ ومستشهداً به أيضاً، وفي الوقت ذاته تستقرئ تباعاته في هذا الزمن.
أما رواية «ثلاثة رفاق» الصادرة أيضاً عن «دار أثر» هي الأخرى، فتعدّ تجسيداً لصورة الحرب روائياً، إذ أن ريمارك أراد أن يقول إنّ الحرب ليست أجواءها فحسب، بل ما بعدها أيضاً، وكيف يمكن للإنسان الذي تشبّع بآمال وأحلام كثيرة أن يصطدم بواقع ومآلات أسوأ، تجعله في تفاوض مستمر مع إنسانيته، وأحياناً يقايض ما تبقى منها كي يعيش.
كما أنه يوضح من جهة ثانية أن الحرب ليست وحدها المسؤولة عن الشر الكامن داخل بعضهم، بل أحياناً هي مجرد وعاء يسكب فيه هؤلاء شرورهم. إنّها أيضاً رواية عن الحب الخالص، والصداقة الخالصة، رواية تذهب بعيداً إلى تقصي جوانب حياة بشر اعتدنا أن نحاكمهم من دون شفقة ولا رحمة.
هنا الرواية أخذت أبعاداً أوسع وأعمق من رؤية الواحد فينا للمومس، والحب وللحرب، ولهذا وجد الفن الروائي، ليعالج ما لا يمكن أن يفعله الشخص العادي، أو الكتابة المجردة. فالأدب يمنح الإنسان تسامحاً، لن يعرف مكمنه في روحه حتى يتحد مع فعل القراءة شيئاً فشيئاً.



