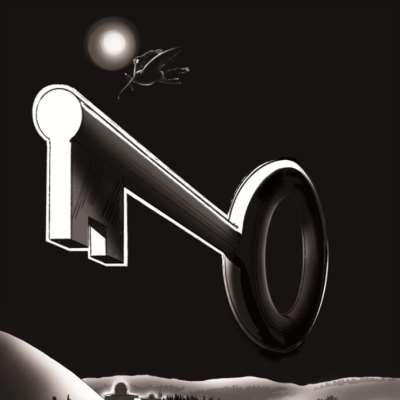نحن، في العالم العربي، تعوّدنا على أنظمة تفترق عن العقيدة بسرعة البرق إذا ما كان ذلك في مصلحة استمرار النظام. كيف يمكن لنا أن نفسر الصراع الدموي الذي استمر عقوداً بين جناحي «البعث» في سوريا والعراق فيما اعتنق النظامان عقيدة الوحدة العربية؟ وكيف لنا أن نفهم تأثير العقيدة في مسار السياسة الخارجية لسوريا أو العراق فيما قرّرَ النظامان، في مراحل مختلفة، الابتعاد عن المفهوم القومي العربي والنزوع نحو الهويّة القطريّة أو حتى العشائريّة؟ لكن مرَّ علينا في التاريخ العربي المعاصر أنظمة التزمت بالعقيدة حتى لو شكّل الالتزام خطراً على استقرار النظام وديمومته. نظام صلاح جديد في سوريا، مثلاً، كان صارماً في التزامه بتأييد العمل الفدائي والصراع مع إسرائيل واعتبر غريمه حافظ الأسد في ذلك تهوّراً قد يطيح بنظام الحزب القائد. نظام معمر القذافي كان في السبعينيات حتى الثمانينيات ملتزماً بالعقيدة القومية العربية ودعم العمل الفدائي.
ويمكن قياس عقائدية نظام ما في التاريخ العربي المعاصر بنسبة عداء التحالف الغربي-الإسرائيلي له. النظام الناصري كان ملتزماً حقيقة بالقومية العربية والوحدة العربية وبالعمل على الإعداد للصراع مع إسرائيل، وكان هذا سبب الهوس الغربي الإسرائيلي بخطر عبد الناصر إلى درجة أنهم شكّلوا تحالفاً ثلاثياً للعدوان عليه في عام 1956. هذا لا يعني أن النظام العقائدي قد لا يساوم أو يقدّم تنازلات في مراحل ما لكن قد يكون ذلك إما لأن استقرار النظام يعلو على ما عليه من عوامل أو أن التنازلات الآنية يمكن أن تخدم المصلحة العقائدية على المدى الأطول. قبول جمال عبد الناصر بمبادرة روجرز كانت مرتبطة بإعداد الجيش لتحرير الأرض في مرحلة لاحقة أو أنها كانت مرحلة التقاط الأنفاس بعد الهزيمة الماحقة في 1967. وهناك طبعاً إمكانية بأن تتطابق مصلحة العقيدة مع مصلحة النظام. إنّ خوض النظام السوري حرب 1973 كانت في مصلحة العقيدة كما أنها كانت في مصلحة النظام لأنه لم يكن يمكن للنظام أن يستمرّ ما لم يخض حرباً ثأرية عن هزيمة 1967 بصرف النظر عن نتائج الحرب.
لو أن إيران أرادت أن تبتعد عن عقيدتها الدينية والسياسية المتعلقة بدعم فلسطين، والتي دشّنها عهد الخميني، لكان التنازل قد بدأ وظهرَ على الفور في شأن السياسة الخارجية نحو إسرائيل ونحو فلسطين، وهذا ما لم يحدث
في مقاربة السياسة الخارجية الإيرانية، عمد غسان سلامة، كما يعمد غيره من المحللين في الغرب، إلى الإشارة إلى الواقعية الشديدة في تعاطي النظام الإيراني مع الحكومة الأميركية أو أنه يحرص على عدم خوض مجابهة مباشرة، أو أنه لا يريد أن يفتح الحرب الكبرى. لكن هذه قد تقاس من زاوية حرص النظام على سلامته أو أنه يعمل على خطة كبرى أبعد مدى وذلك يحتم تأجيل فتح الحرب الكبرى. وهذا يسري على سلوك حزب الله في هذه الحرب مثلاً. إنّ تجنّب حزب الله فتح الحرب الكبرى مع إسرائيل لا يعني أبداً أنه أجّلَ أو وضعَ جانباً ما يعد به من ناحية العمل على تحرير فلسطين والقضاء على كيان الاحتلال في إسرائيل. إنّ الالتزام بالعقيدة لا يعني أن تنفيذ بنود العقيدة لا يجب أن يخضع لحساب الربح والخسارة. على العكس، إنّ الحساب الدقيق لتنفيذ الأهداف العقائديّة يكون نتيجة التزام مبدأي بالعقيدة، ولا يكون على طريقة صدّام حسين أو القذافي في التحوّل في السياسة من دون كسب ضمان الأمان من الغرب.
الجوانب الواقعية في السياسة الخارجية لإيران لا تنسف أهمية، أو حتى مركزية، العقيدة في السياسة الإيرانية. إنّ ثبات التحالف الغربي-الإسرائيلي في عدائه للنظام الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية دليل على أن العقيدة الدينية السياسية، والتي تتضمّن العداء لإسرائيل بنداً أساسياً فيها، تحرّكُ السياسات الإيرانية. إنّ الجوانب البراغماتية الواقعية في السياسة الإيرانية، مثل التفاوض حول الملف النووي أو التهدئة مع دول الخليج أو غيرها من الدول العربية، لا يعني أن إيران قد حادت أو ابتعدت عن العقيدة المؤيدة لمشروع محاربة إسرائيل. المقياس هو بسيط في هذا الصدد: هل أن إيران تهاونت أو خفّضت أو فاوضت على منسوب تسليحها وتمويلها لحركات المقاومة في المنطقة العربية؟
من الطبيعي أن يكون النظام يريد الحفاظ على استقراره وعلى ديمومته، ومن الطبيعي أن يكون مستعداً للانخراط في مفاوضات مع دول الغرب بشأن المشروع النووي الذي ليس في صلب العقيدة وإنما هو رادع يحفظ الأمن القومي للنظام. لكن في كل مسار التفاوض مع أميركا لم تتهاون إيران مرة بشأن دعمها لحركات المقاومة ولم تقبل بوضعه على جدول التفاوض، باعتراف المفاوضين الأميركيّين. النظام الليبي مثلاً أوقف دعمه لحركات المقاومة عندما تهدّد النظام كما أن النظام العراقي انخرط في مفاوضات تهدئة وابتعد عن مواقفه الرفضية في شأن فلسطين عندما احتاج إلى الدعم الأميركي في حربه مع إيران. والنظام السوري كان يستجيب لطلبات أميركا أحياناً بالنسبة إلى رفع الدعم عن أبو نضال، أو حتى الطلب من حركات المقاومة بعد 11 أيلول أن تتوقف عن النشاط السياسي (كما طلب منهم عبد الحليم خدام). النظام الإيراني لم يفعل أياً من ذلك خصوصاً عندما نتذكّر أنه ليس من نظام عربي واحد اليوم يجرؤ على مدّ أي حركة مقاومة برصاصة واحدة ولا حتى النظام الجزائري الذي لا يزال الأكثر ارتباطاً بعقيدة جبهة التحرير الجزائرية المؤسِّسة. تسليح حركات المقاومة في السياق العالمي الخاضع لهيمنة أميركا هو نقيض البراغماتية والواقعيّة.
المسألة بكل بساطة هي التالية: لو أن إيران أرادت أن تبتعد عن عقيدتها الدينية والسياسية المتعلقة بدعم فلسطين، والتي دشّنها عهد الخميني، لكان التنازل قد بدأ وظهرَ على الفور في شأن السياسة الخارجية نحو إسرائيل ونحو فلسطين، وهذا ما لم يحدث. على العكس من ذلك، فإنّ السياسة الإيرانية لم تترجم التفاهم النووي الذي تم في عهد أوباما عبر تخفيض منسوب دعم حركات المقاومة في المنطقة العربية. لقد دفعت إيران ثمن وقوفها إلى جانب حركات المقاومة وفي معاداة إسرائيل أكبر الأثمان، ومنذ اندلاع الثورة. لا يمكن التوفيق بين نظريّة الواقعيّة في السياسة الخارجيّة الإيرانيّة وبين وقوف إيران إلى جانب فلسطين. يستعمل غسان سلامة (وكل الكتّاب العرب في إعلام الخليج) عبارة «استثمار إيران في القضيّة الفلسطينيّة». هذا التعبير يتناقض مع المنطق: الاستثمار يعود على المرء بالربح، لا بالخسارة، ولم تجنِ إيران من دعمها لفلسطين إلّا الحروب السرّية ضدها والعقوبات التي لا تنتهي من قبل كل دول الغرب، بالإضافة إلى حملات تشنيع ضد إيران والشيعة في الثقافة السياسيّة العربيّة على مرّ العقود.
لو أن إيران تخلّت عن حزب الله (كما تخلّى حافظ الأسد عن أوجلان بعد تهديد تركيا) لقلنا إن سياسات إيران تنبع من الواقعيّة لا من الإيديولوجيّة في السياسة. لم يتعوّد العالم العربي، منذ الحقبة السعوديّة التي تلت وفاة عبد الناصر، على نظام يلتزم بمبدأ أو عقيدة (مهما كان رأيك بهذا المبدأ وهذه العقيدة). لكن تحليل سياسات إيران بمنظار الواقعيّة يتناقض مع تكريس اللوبيات الإسرائيليّة حول العالم لحصار إيران والعمل على إسقاط نظامها. لو أن إيران تتخلى عن المقاومة، لزال الاعتراض الخليجي على سياساتها. نقارن بين تصالح أنظمة الخليج مع واقعيّة سياسات الشاه الصهيونيّة وبين معاداة الخليج لسياسات إيران الفلسطينيّة. إنّ التخلّي عن فلسطين أقصر الطرق لعودة إيران لحضن ما يسمّيه حلف شمال الأطلسي ودعاته بيننا: «المجتمع الدولي». كتاب تريتا بارسي، «التحالف الغادِر: التعامل السرّي بين إيران وأميركا وإسرائيل» أُسيء فهمه في الإعلام العربي (وعن قصد) وغاب عن ذهنهم أن مؤلّف الكتاب هو مؤسّس لتحالف يسعى إلى تحسين العلاقة بين إيران والولايات المتحدة. هو أراد في الكتاب تعزيز النظر إلى عنصر الواقعيّة في سياسات إيران لأن الغرب لا يرى في دوافع سياسات إيران إلا العقيدة (بعكس النظرة العربيّة الخليجيّة. والنظرتان تخدمان مصالح إسرائيل، بحسب الجمهور في الغرب والشرق).
عقائديّة إيران تثير قلق إسرائيل فيما تريد أنظمة الخليج الترويج لواقعيّة السياسات الإيرانيّة وبراغماتيّتها لأن قبول عقائديّتها يضع كل الأنظمة العربيّة في موقع حرج.
* كاتب عربي - حسابه على «اكس»
asadabukhalil@