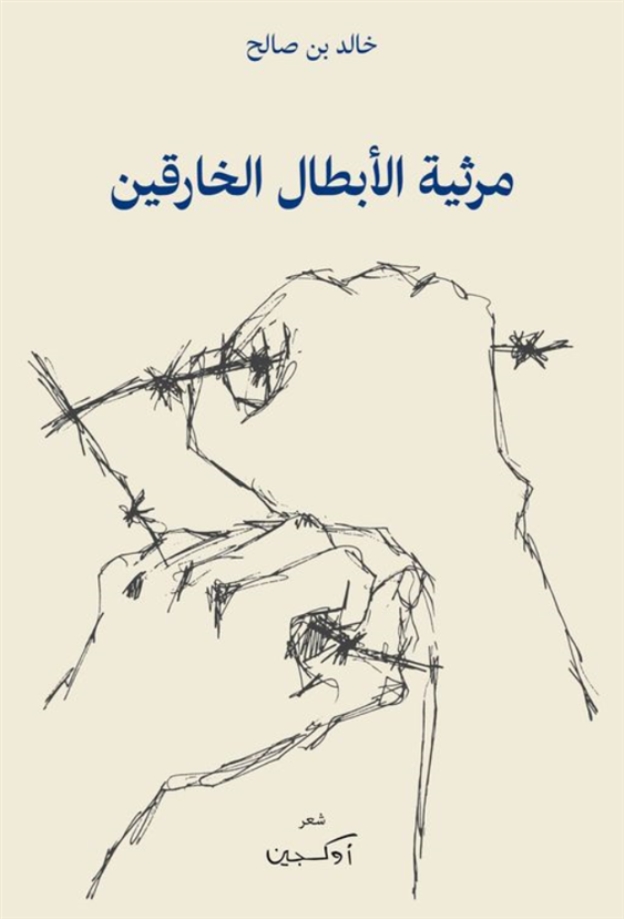
تحيط قصائد خالد بن صالح بالوجهتين؛ هي صوت ناشز لذات شذّت عن لحن «الأوقات المظلمة»، وهي أيضاً كتابة تلك «الأغنية» التي كانت تصدح الحناجر بكل ما تحويه أبياتها من بؤس «ما الذي يجعلك لا تبوح بسر الرفاق؟ لا تبيع المناضلين الأحرار؟ وأنت تُجر إلى بوتقة السعير تلك/ مكان التعذيب... محاط بالأشجار والعصافير والأسلاك الشائكة» ومصائر كامدة «لم يقتل التعذيب على طريقة «الخوذة الألمانية» الرفيق بشير الحاج علي، لكنه أفقده ذاكرته في آخر سنوات عمره/ طرق التعذيب ذاتها الموروثة من زمن الاستعمار مورست عليهم زمن الاستقلال». نحن إذاً أمام مرثية مؤلفة من مقاطع شعرية أشبه بمونولوجات جنائزية تلقيها الذات كما لو أنها تقرع أجراس التشييع «أنا آخر السكارى في ليل المدينة/ أنا عبارة غير مصقولة في سطرٍ أخير. لافتة تئن/ أنا رجلٌ وحيد آخر الليل». ومن أبيات تذكارية عن أبطاله الخارقين، يكتب صاحب التعسف: «تعرضت للتعذيب، للمرة الأولى في حياتي، ذات صبيحة جميلة ومشمسة، من شهر سبتمبر، زادها بهاءً في عينيّ خليج الجزائر ببياضه وضوئه المزهر». وبين الشاعر وأبطاله تماهٍ لا انفصال. سيرة المكابدة واحدة و«الأغنية» (كانت) واحدة، بينما الفارق الوحيد هو المصير؛ الأبطال في حالة غياب قهريّ ولو كانوا حاضرين في الذاكرة والتفاصيل الصغيرة، فيما الشاعر بقيَ وحيداً في خضم الخراب، مقتَلَعاً من زمنه لا ينتمي إلى الحاضر «ماذا يفعل الجزائري حين يشعر أن ظلالاً قاتمة تلاحقه؟».
كأن الكتابة هنا تتخطى فعل التذكّر، وتصبو إلى تخليد الحكاية عبر قصها وإعادة تلاوتها. كتابة حكايات شخوص تشبه من حيث فضاؤها مناخ الملاحم، فتبقى دامغة قاهرة للنسيان. تغدو كتابة المرثية إهداءً مضمراً يمنحه الشاعر «للرفاق»، رفاقه المتظاهرين، والمعتقلين، والقابعين في السجون والذين خسروا الكثير، من بينه أنفسهم، لأن الكتابة عنهم هي بالدرجة الأولى الكتابة لهم «في اختبار الرعب الذي صنع ذاكرتنا، تطفو مرة أخرى الأغنيات، كرسائل قصيرة تذكّرنا بما نحن عليه، وبأي فأس قطعنا أحلامنا الخضراء اليانعة!». غير أنّ الكتابة في الحالة هذه، لكي تستقر على ما ترمي إليه، ويكتمل معنى الإهداء، فإنها تشترط لغة «الرفاق»، ولعلّ أهم ما يجب الاستحواذ عليه لغوياً هو ظلّ «الرفاق»؛ أي الأسلوب. على هذا النحو، سنرى عدة عناوين تعرضت للشطب؛ حذف العنوان المكتوب والإبقاء عليه مشوّهاً، وكأن الرسالة الدالة تكمن في (إظهار) هذه التورية. هذا اللعب الشكلي الذي مارسه بن صالح ليس عبثياً، إنما هو توظيف شعريّ، حيث الخطوط والأرقام وعلامات التنقيط رموز ناطقة. يلج بن صالح داخل مشهدية سبق أن رسمها بالكلمات «وأنتَ تستبدل الهواء الخانق بكلمات تكتبها على «ورق التواليت» وتهربها خلسةً زوجتك «لوسات»، في علب الدخان الفارغة». يكتب قصائده كمن يهرّب مناشير إلى داخل السجون. عنوان «1 مايو 1999 (علامات)» أو عنوان آخر كـ«25 أغسطس 2020 (عيد ميلاد)» حيث الشطب يطال عيد ميلاد و1 مايو، سيحيلاننا من دون شك إلى تحسّس اعتكاف الشاعر عن الاحتفال في الأعياد، بل توكيد على كآبة لا تنفع المناسبات في تأليب السعادة عليها، إلا أن تلك القصائد بما تفصح عنه («هناك دائماً ما نقوله عن الوطن الذي تم تدميره على شاكلتنا») تشي بأنها تتقصّد أحداً، كأنها تعدو إلى مكانٍ تعرف وجهته جيداً. كأنّ الشاعر يغمز القارئ ليتواطأ معه، يروم إلى خلق نوع من حركة داخلية من شأنها أن تقول: هذه القصائد ستتسرب «إليهم». فالسجن في «مرثية الأبطال الخارقين» هو الأسوار الجغرافية للوطن؛ الوطن الذي انتصرت فيه «الأزمنة المظلمة» حيث الشاعر الذي «يسرّب» قصائده، ويتوجه إلى «رفاقه» القابعين خلف الأسوار، لا يزال رغم كل شيء يرغب بالبوح إلى «الرفاق»، ومتعلقاً بزمنٍ انقضى، والأهم أنّه يقحمنا في مناخ خاصٍ يجعلنا نستشفّ أنّه بدوره مسجون. ولأنه كذلك، فإن قصيدة بن صالح بوجهتها الأخرى؛ أي عندما ينحو صوب ضمير المُتكلم، سنرى أن الشاعر الذي يرثي غير محيّد عن مرثيته بل ذائب فيها. تلك الذات المتقهقرة لا تنفصل عن سيرة هؤلاء «الرفاق» «خسرنا الكثير ولا بأس أن نخسر بضعة أعوامٍ أخر»، باستثناء أنه كان لها حظ «البقاء». هذه فرصة استثنائية حتى تروي اختبارها وتقدّم الشعائر إلى أبطالها.
على أنّ هذا «البقاء» سيدفع ثمنه صاحبه في بلاء العيش، ولعنة السأم («كما بودلير «في سأم باريس»: وجودي هنا لا شفاء منه»)، والاجترار القاتل. عندما تأخذ الذات حيّزها وتطلق العنان لنفسها، سنرى أنها منصهرة في قاعة العزاء الكبير. انعطاف بن صالح من سيرة الرفاق نحو الأنا، لن يجعل الشعر ينزوي أو يخفت أو ينفلت من الرثاء، إنما سنرى إفصاحاً غزيراً عن ذات هائمة في مدينةٍ وفي سياقٍ زمني مهما تغيّرا، إلا أنّ شيئاً جوهرياً يبقى ثابتاً يرزح الشاعر تحت وطأته. ثمّة نزعة بوهيمية تفيض عند الشاعر التي ابتلعته الهزيمة، كأنها احتجاج على هذا «البقاء». بوهيمية تجعله يواجه الكثير من الذكريات التي كثيراً ما تراوده بسخرية واستهزاء: «جدتي التي تنبّأت بأني سأكون صحافياً، ماتت قبل أن تراني مقيداً تحت شمس مدينة أخرى، في فمي سيجارة غير مشتعلة وعلى كتفي العلم الوطني» أو «سنضحك بشكل هستيري على أنفسنا ونحن نتراشق بالكلمات، هذا كل ما نملكه في الحقيق».
خسرت الأغنية أمام «الأزمنة المظلمة» إذاً، والشاعر يمكث في مرحلة ما بعد الغناء، حيث الحاضر يماثل الماضي ولم يبقَ من تلك الفرصة الضائعة، أي «الأغنية» المنشودة، سوى الحسرة والتفجع «تقولين متسائلةً: متى قررنا البقاء هنا؟». ثمّة عطبٌ وجوديٌ عند بن صالح مردّه «الخارج» أو أقلّه مصنوع من «هناك». ثمة رفض لما هو قائم ومترسخٌ في الواقع «تلاشي الطبقة الوسطى. وقت الكرنفال المتلفز. أحوال الطقس في بقية الوطن. الأرائك الممزقة في صور العائلة» إلى حد النفور البصري من كل ما يمت بثقافة العصر «تتدافع ماركات الشركات الرأسمالية في مساحة بطنك المنتفخة». ذاك أن مرثية بن صالح قبل كل شيء، هي قصيدة سياسية طويلة، تبغض «البنية الفوقية» بكامل أفعالها ومصطلحاتها «متخلصاً من حشد أفعال بالية: قام، قال، زار، أكد، وما تلاها من أكاذيب». تلك البنية يُنسب إليها شكل واقع وكانت بالأصل سبب خسارة «الأغنية» التي صارت الآن رثاء وهجاء.
ماذا يفعل الجزائري حين يشعر أن ظلالاً قاتمة تلاحقه؟
يقارع الشاعر هذه الصلابة، فيجيء سيالاً «من تحت». يسير عكس السائد «إن المحاكاة هي أن يقتلك البرابرة». لا فرق بين الشاعر والثائر في هذه الحالة. وكونه على نقيض من السائد، وضد المماثلة وغريباً عن الحسّ العام، يلملم بن صالح عباراته مما طُرد وحُيِّد ودُفن، ويدفعه إلى خلق عالمٍ أقل هدوءاً، يعبّر عنه لماماً عندما تستكين النبرة الشعرية. عالم مصنوع من «خارج» آخر؛ «الخارج» هذا هو الطبيعة التي تقتحم عناصرها حقله الجمالي «إن الشعر كائن أخضر مغمور بالطحالب والرطوبة والرائحة» أو «لا أحلم بأكثر من غسيل منشور تداعبه نسمات خريفية في باحة منزل صغير». مهما غاصت مرثية بن صالح في الحداد، يبقى الشعر فيها هائجاً لا يخمد، كثورةٍ دائمة غير قابلة للإجهاض. شعرية بن صالح طافحة، تنبثق من الأصدقاء، والغرباء، والميكروفون، والزنزانة وأغاني الراي، في قصيدة لا تأبه بالتقطيع العمودي، والنقطة ثم العودة إلى السطر، وكليشيهات القصيدة المعاصرة، بل تراه يكتب مقاطعَ قد تبدو شذرات، أو شعراً منثوراً، أو مقاطع خارجة من بث مباشر، وكذلك كالرسائل.
نميل منذ البداية إلى التعامل مع قصائد بن صالح على أنها رسائل موجّهة ومكتوبة لأحد. غير أن بن صالح يتعمّد كتابة شعرية آخذاً فيها من شكل الرسالة نسقه، هكذا يصبح الشعر مباشراً ومكشوفاً وشفافاً. أشباح تلاحق الشاعر ويبدو أن الرسالة وسيطٌ تمنحه الاحتكاك المطلوب مع الغائبين، إذ هي تعيد ربطه بحبكة ضائعة، «بالأغنية»، وبالمغنين، أي «الرفاق» من جهةٍ، ومن ثم هي تعويل على خلاص لم يأتِ بعد، في محادثة مع غائب آخر يمثّل الرجاء المنتظر في خضم هذا الرثاء. يكتب بن صالح في قصيدته الأخيرة «العالم الذي لن ينتهي قبل أن نلتقي صباح يوم بارد ومنعش، نشرب قهوتنا على مهل، ونخطط للثورة». الثورة إذاً، بما هي حركة تجري في الخارج وتقوم ضده في انقلابها عليه بإمكانها بالتالي أن تطيح استبداد الحالة وتُعيد خلق العالم. تخلص قصيدة بن صالح إلى دعوة ثورية تنشد إصلاح هذا العطب الوجودي في تغيير العالم. مرثية بن صالح تأريخ للهزيمة، وتدوين لحاضر عقيم، وتحية إلى أبطاله الذين غنوا «في الأوقات المظلمة»، لكنها تحريض أيضاً للغناء «عن الأوقات المظلمة» من جديد.


