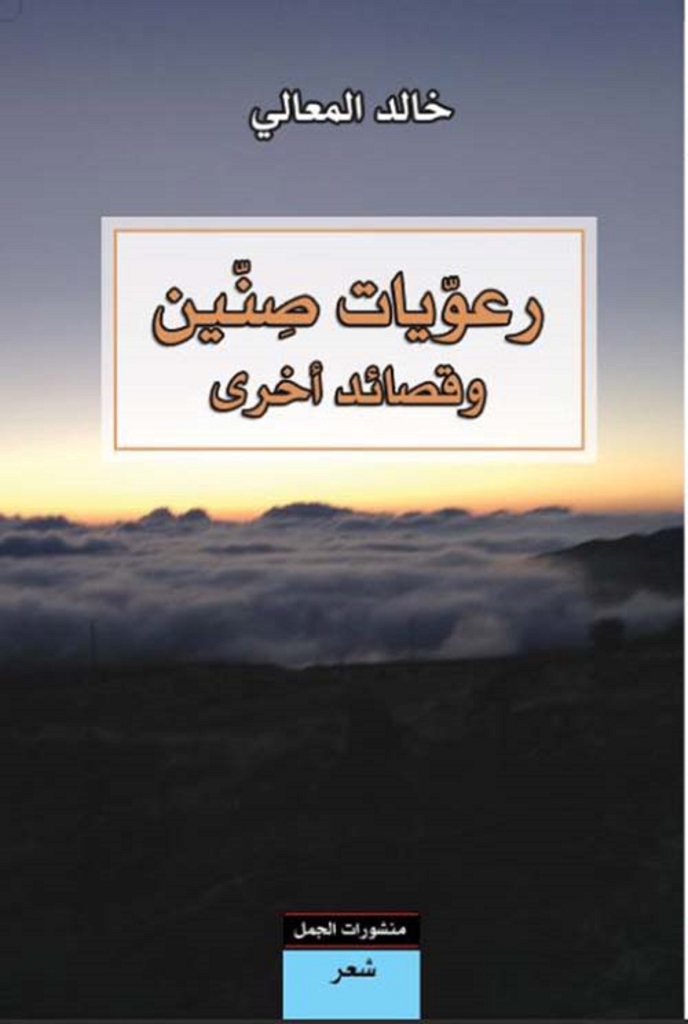
ثم جاء فرجيليوس في الإنيادة الخالدة ليجعل لهذا الفن أهدافاً جديدة تأثّر بها شعراء العصور اللاحقة وصولاً حتى روبرت فروست وشعر اللانداي عند نساء البشتون في أفغانستان... الفن الذي اتخذ عبر العصور تسميات مختلفة تجاورت مع المفردة الشائعة Pastorale، لنسمع بالإيديليات les idylles عند ثيوكريتوس، والوصفيات Bucoliques عند فرجيل، والرعويات الصغيرة pastourelles التي ظهرت في فرنسا في القرون الوسطى، وغيرها من التسميات. إلا أن الجامع المشترك بينها هو نشدان براءة الأماكن الأولى والطفولة والحنين إلى فردوس مفقود (عادة ما كان الشاعر ميلتون يختار أبياتاً من رعويات فرجيليوس ليفتتح بها أعماله). هذه النوستالجيا التي تمتد أمام عين الشاعر كـ «سراب يبدو من بعيد»، من السماوة العراقية القصية في الذكريات كما تشير إحدى القصائد بوضوح: «يعرفها حقّاً/ كان في أحلامه يراها/ خيطاً مُدّ من بعيد/ فيما شبّاكه مغلق/ والظلام ما زال مخيّماً/ تدعوه ليأتي/ وحش الطفولة/ وقد تلاشى في ظلها/ كلبها النابح دائماً/ فيما كان يعدو ويعدو».
إنها نوستالجيا لا تريد أن تعترف بالواقع المرير، بكل ما شكلّه المؤقت والعابر والمنفى بعد النواة «الرعوية» الأولى للذكريات التي تدور حول نفسها، وعناصر المكان الأول التي لا تريد من يزاحمها في قلب الشاعر وفي لغته: «ليله لم يزل/ أنفاسه تنبض/ يداه مرخيتان/ وكأن الذكريات تدور حول نفسها/ متى كان هذا؟/ أين؟/ لم يعد يدري/ شارداً/ في ثوبه الرثّ/ وقد حال لونه/فيما أقدامه كلها جراح/ تخطو في الحقل الواسع/ متى كان هذا؟/ أين؟/ بيضة القطا تلوح/ نمشُها يُظهر ويُخفي/ وخياله تاه/ لا مياه/ بل سراب يبدو من بعيد».
يأوي الشاعر إلى جبل يعصمه من مرارة الواقع، وينادي أثناء الصعود في الجبل أصدقاءه جميعاً، لنرى القصائد وقد أهدى بعضها إلى آدم فتحي، وفاضل عباس هادي، وحسين علي يونس وعبد العظيم فنجان. وحين لا يحضر الصديق كما حين غاب أدورنو عن «محاورة الجبل» لبول سيلان الذي قدّمه خالد المعالي في ترجمة عن الألمانية لقرّاء العربية، فإن الشاعر يصل إلى قمة الجبل متعباً ووحيداً وقد أضاع كل شيء في الرحلة: «كان قد ضيّع زاده في الطريق/ فقسّم الأمل الذي لديه قطعاً صغيرة/ وبيده مسحَ الغبار عن بوابة الذكريات/ فسارت حياته وكأنها لم تكن هناك/ جمع أحلامه من الدروب المثيرة التي سارها وحيداً إلا من ظِلّه/ يحمل كلماته تمائم وشرابه اليأس مرّاً/ فحتى اليأس أضحى إليه يعود كلما غربت شمس النهار لكي يبقيه ساهراً يراقب النجوم»... ليصل إلى صنين وقد تحول إلى جبل من الشعر، شعر مفرداته من التلقائية والبساطة الأشبه بالوادي الذي يرافق المتنزّه إلى الأعلى، إضافة الى شعور المرارة المروّضة التي نتقبّلها عن طيب خاطر. إحساس نشعر به في كل خطوة قدم في القصيدة: «كان يكلّم نفسه/ في الليل الممزّق/ تاركاً حان الطريق وراءه، عابراً سرب الدخان/ كل الرؤى تهلّ عليه الآن/ حتى الأسى حطّ بين يديه كطائر السعد في الحكايات»، ليعلن بوضوح في قصيدة «رعويات صنين» أنه وصل إلى القمة ليكتب لنفسه أولاً وآخراً: «كان يكتب رسائل إلى نفسه التي لم يعد يراها إلا لماماً/ هناك في الأعالي حيث تبرك الأحجار كأشخاص جمدوا في المكان/ كأنما كانوا بانتظار الرسالة»، في إشارة واضحة إلى ذاتية التجربة الشعرية، وفردانيتها كتجربة ممغنطة على عوالمه الداخلية أولاً، وهو ما يبعدها عن تجارب شعرية لامست الشعر الرعوي الجماعي في نطقها بحنين الجماهير إلى أرض مسلوبة كقصائد محمود درويش الأولى، وسميح القاسم، وكنعانيات عز الدين المناصرة، إذ تكفي المعالي مفردة أو اثنتان مجردتان من الحمولة الأسطورية أو الإيديولوجية ليصنع عالمه الرعوي: «يكتبها/ فيما تمرق الغيوم تحته/ أو تبركُ قليلاً/ حتى تخطر الصورة في خياله/ ها هم الأقوام هناك/ يكفي أن تتركها تسيح حتى يكفوا عن الصيرورة ويرتاحوا».
نشدان براءة الأماكن الأولى والطفولة والحنين إلى فردوس مفقود
لكنّ الشاعر يكون دائماً في المكان غير المتوقّع أو خارج الموضع الذي نراه فيه، ويعيش خارج ساعته كما يعنون إحدى مجموعاته الشعرية: «يرى الأسى من بعيد مخيّماً بانتظاره/ باب بيته مشرع/ تراقصه الريح/ فيما هو يسير ببطء/ ملبياً الدعوة يومها/ تاركاً كيس أحلامه على الأحجار». تحضر صيغة الغائب كلما تراءت الذكريات الرعوية لـ «جمعة يعود إلى بلاده»، كأنها صلاة الغائب على الأشياء الماضية يضمنها كل حرارة الإيمان القديم، أمام صيغة الحاضر التي يستعملها المعالي بشكل أقل كلما أراد أن يصف أنه «خارج المكان» بحسب عنوان إدوارد سعيد الشهير: «لم أعد أعرف الدفء/ ناري خبت والريح تهب/ الرؤى التي راكمتها حجاراً صارت تراباً». إنه حاضر الأسى حيث «اليأس يحطم النوافذ/ وكلما سبرته رأيتني عاجزاً أمسك الفأس والحطام/ كم سرت حافياً/ كم توهمت نهايتي ورميت الذكريات بكيسها وحلمت بالرقاد/ حيث تكسّرت هواجسي وكفّ فمي عن الغناء». لكنّ صاحب «الهبوط إلى اليابسة» بعد أن يفاقم قليلاً من جرعة اليأس (كان عائداً من الحرب/ شبه ميت/ كل ما لديه حطام/... أضاعوه... وأي فتى أضاعوا... وغرباء أوصلوا الجنازة إلى بيته المهجور)، يترك لنا في قلب اليأس كوة للأمل، أشبه بنجمة خجولة بين غيوم صنين أو تلك الشمس التي إذا طلعت، تزاور عن كهف النائمين لتوقظهم يوماً ما بدفء الأمل: «أتيه/ أطرق الأبواب ليلاً ثم أغنّي/ عسى نلوح للحياة من جديد/ كأقوام يرقد النوم عندهم/ والشمس تسري إليهم».


