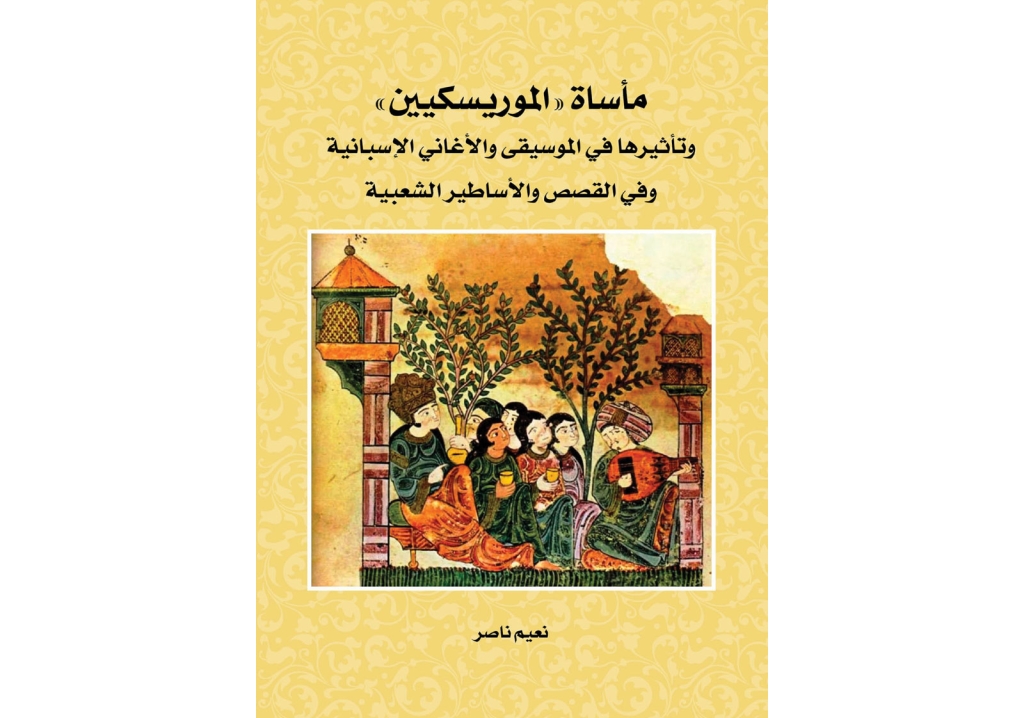
لم يكتفِ المسلمون الإسبان بذلك، بل ابتكروا لغة جديدة خاصة بهم عُرفت باسم «الألخميادو»، وهي لغة رومانية قشتالية كُتبت بأحرف عربية، لحفظ موروثهم الديني الإسلامي، بحيث لو اقتحم عساكر محاكم التفتيش بيوتهم، لن يفقهوا محتواها. كما ابتدع يهود الأندلس، لغة خاصة بهم، هي خليط من العبرية القديمة ومن اللغة القشتالية، عُرفت باسم «لادينو» حفظوا بها تراثهم الديني. توسع استعمال كلمة «الموريسكي»، التي تعود إلى الكلمة الإسبانية «مورو» (Moros)، ليشمل جميع المسلمين الذين حلوا في الأندلس، بمن فيهم الإسبان الذين اعتنقوا الديانة الإسلامية، وانسحب الأمر كذلك، على مسلمي جنوب شرق آسيا، وبخاصة مسلمي الفيليبين بعدما احتلّها الإسبان. وتقلص استخدام هذا الاسم لاحقاً ليقتصر على المغاربة بعد «حرب تطوان» التي نشبت بين المغرب وإسبانيا عام 1859. وما زال الدهماء من الإسبان يطلقون على الإنسان العربي لقب «المورو» من باب التحقير.
مع ذلك، لقد أثّرت الحضارة العربية والإسلامية، عبر 800 سنة من حكم المسلمين للأندلس وجنوب البرتغال، تأثيراً كبيراً في مقومات الحضارة الإسبانية الكاثوليكية الثقافية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والإنسانية، وما زال بعض سماتها يطبع ماهية العنصر البشري الإسباني.
وهذا يمكن تلمّسه في اللغة الإسبانية، التي حوت الآلاف من المفردات العربية، وفي الموسيقى والتراث الإسباني المعاصر، وفي بعض العادات والتقاليد الاجتماعية. كذلك، فإنّ انصهار العنصرَين العربي والأمازيغي مع العنصر الآري الإسباني، عبر مئات السنين من حكم المسلمين لإسبانيا، تولّدت عنه مجموعات سكانية تعود أصولها إلى أقوام عربية ومسلمة، ما زالت تكنّى حتى اليوم بأسماء عربية، مثل كنية «ابن أمية» وغيرها. وقد أنجبت كفاءات علمية واقتصادية وسياسية وفنية وأدبية إسبانية، أورد منها الكاتب، على سبيل المثال لا الحصر 12 اسماً، تعتبر، حسب المراجع الإسبانية، أحفاد الخليفة عبد الرحمن الداخل مؤسس الخلافة الأموية في الأندلس عام 756م. وهؤلاء موزعون في إسبانيا وفي المستعمرات الإسبانية السابقة في أميركا اللاتينية.
وتقديراً من مكونات المجتمع الإسباني، السياسية والاجتماعية والثقافية، لبعض ملوك وشخصيات الأندلس العربية والمسلمة، تم تكريمهم بإقامة تماثيل لهم في الساحات والميادين العامة في بعض المدن الإسبانية، منهم 13 ملكاً وعالماً وشاعراً. لم يكتفِ الإسبان بتخليد من مر ذكرهم، وإنما خلّدوا العديد من الشخصيات العربية والإسلامية واليهودية التي تركت بصماتها في تاريخ الأندلس والعالم في جميع المجالات، عبر إصدار طوابع بريدية إسبانية، أورد الكاتب في مؤلفه 11 شخصية مؤثرة في تاريخ الأندلس.
ويسجّل للإسبان أيضاً أنهم احتفظوا بالأسماء العربية لبعض المدن التي أنشأها العرب والمسلمون، وإن اختلفت في نطقها حسب مخارج الحروف الإسبانية، أورد الكاتب منها أسماء عشر مدن في مقدمها مدريد، وهي بالعربية «مجريط». ما تقدم يشير - حسب الكاتب - إلى اعتزاز بعض الإسبان بتاريخهم الحضاري الذي امتزج، في شكل أو آخر، بتاريخ العرب والمسلمين، الذين حكموا بلادهم ثمانية قرون، رغم محاولات بعضهم طمس هذا التأثير، معتبرين أن العرب والمسلمين كانوا غزاة لبلدهم ولم يكونوا أصحاب حضارة، مثلما فعلت محاكم التفتيش الكاثوليكية الإسبانية التي عملت جاهدة على تزوير هذا التاريخ. ولكن الحقيقة كانت متجلّية في مناهل الحياة الإسبانية بشتى صورها العمرانية والاجتماعية والثقافية والفنية، والتي ما زالت ماثلة لكل زائر لهذا البلد العريق.
كان الموسيقيون المسلمون واليهود الأندلسيون يحيون حفلات في بلاطات الممالك المسيحية
ورغم المآسي التي لحقت بالمسلمين واليهود الإسبان في الأندلس، والمعاناة الشديدة التي مروا بها، إلا أن هؤلاء لم ينسوا البلاد التي ولدوا وترعرعوا فيها أباً عن جد، وبقيت ذاكرتهم تعجّ بتراثهم الثقافي والحضاري على مر السنين. وما زال أحفاد هؤلاء في عصرنا يحافظون على هذا التراث الذي ورثوه ودوّنوه بلغتهم الإسبانية، تاريخاً وأدباً وفناً، وبخاصة ما يتعلق بالشعر والموسيقى والأغاني، التي غلب على طابعها الحزن والأسى والبكاء على أطلال الممالك الإسلامية الأندلسية في إسبانيا، وبخاصة مملكة غرناطة وآخر ملوكها أبو عبد الله الصغير.
وتعد الموسيقى الأندلسية من أبرز المعالم الثقافية للمسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال). ارتبطت في شكل وثيق بنوعين من الشعر: الموشحة والزجل الذي كان يُغنّى باللهجة العربية الأندلسية، وكلاهما انتشر في الأندلس بين الخاصة والعامة على حد سواء. والموسيقى الأندلسية، عموماً، مزيج حضاري فريد، جمع تفاعل مسيحيي شبه الجزيرة الإيبيرية مع العرب وحضارتهم الشرقية، ومع الأمازيغ (البربر) وحضارتهم الإفريقية، ومع اليهود الذين سكنوا الجزيرة مع المسيحيين قبل حكم المسلمين.
وبعد قرون، وفي القرن الثاني عشر الميلادي بالتحديد، بدأت تظهر موسيقى ذات طابع أندلسي متميز، بفضل الفيلسوف والموسيقي الأندلسي ابن باجة، الذي مزج الموسيقى الإسبانية بالموسيقى الشرقية، وقدم نوعاً جديداً ذا طابع أندلسي مال إليه الناس، لأنه كان ينسجم أكثر مع مزاجهم الأندلسي. وأغلب الظن أنه كان مرتبطاً بالموشحات، التي هي ابتكار أندلسي خالص. هكذا، اتّخذت أغاني الأندلس نمطين: إما قصائد على النمط الشرقي توضع لها الألحان المناسبة، وقصائد على النمط الأندلسي، أو موشحات وأزجال كتبت لتُغنّى. وكان الكثير من الموسيقيين المسلمين واليهود الأندلسيين يذهبون طوعاً إلى بلاطات الممالك المسيحية، ليحيوا حفلاتهم، حيث كانت الموسيقى الأندلسية تستقبل باحتفاء حتى القرن الخامس عشر للميلاد مع بداية عصر النهضة الأوروبية.
وحافظ «الموريسكيون» الذين هُجّروا من بلادهم على الموسيقى الأندلسية، فنقلوها معهم أثناء إقامتهم في شمال أفريقيا والمشرق العربي، وما زالت آثارها حية إلى اليوم، ويطلق عليها «الملحون» في المغرب، و«الحوزي» في الجزائر، والقدود الحلبية في سوريا.
وإلى جانب ذلك، ظهر في الأندلس وخارجها نوع من الموسيقى عرف بـ «الفلامنكو» اشتهر الغجر الإسبان بأدائه. وبحسب أبو القومية الأندلسية، بلاس انفانتي، فإن اسم فلامنكو مستمد من العبارة العربية «فلاح منكوب»، ويُقصد بها الفلاحون المسلمون الفقراء، الذين اضطروا للهرب من عسف محاكم التفتيش الكاثوليكية الإسبانية والالتجاء إلى حيث يقيم الغجر الإسبان.
ويُعتبر الفلامنكو من الفنون النادرة التي تعبّر عن الألم والمعاناة، حيث تتكاتف الصرخات المؤلمة لمؤديها لتنسجم مع تصفيقات المتفرجين المتناغمة، وشهقات إعجابهم، التي تنبع من الفؤاد (أوليه... أوليه Ole.. Ole) وهي كلمة يعود أصلها لكلمة «الله» العربية، وهي عبارة تُستعمل للتعبير عن الإعجاب. ولأهمية هذا النوع من الفنون الغنائية والموسيقية، صُنِّف الفلامنكو كفنٍّ من التراث الثقافي المعنوي للإنسانية.
والفلامنكو ليس فناً فحسب، بل هو جزء من تراث الأندلس وتاريخها. إنه ملحمة تروي تاريخ إنسان طبع بقوة بصمات ثقافية على أرض الأندلس. فن يروي كيف تخبطت جيوش الحنين في الطين، وكيف وصل «الموريسكي» (المسلم) بخيباته وفجائعه حد الرقص، وكيف استمد صوته من آهات العذاب ليرقص رقصاً لا يجيد الرقة، وإنما الخشونة والألم.
هذه العلاقة بين الموسيقى الأندلسية «الموريسكية»، والموسيقى الغجرية، وُجدت كذلك في الحفلات التي تميز بها «الموريسكيون» وكانت تُعرف بـ «الزامبرا» (Zambra). وأصل هذه الكلمة عربي مصدرها «زمْر» بسبب الجلبة التي كانت تحدث في الحفلات «الموريسكية» من رقص وموسيقى. تابع «الموريسكيون» هذه الاحتفالات إلى أن قام الإمبراطور الإِسباني كارلوس الخامس في القرن السادس عشر الميلادي بمنع «الزمر» والحفلات الليلية وإقامة الأعراس.
وبعد قرون، عادت كلمة وفعل الـ «زامبرا» إلى الواقع الإسباني على يد الغجر الغرناطيين القاطنين حالياً في أعلى منطقة في مدينة غرناطة المعروفة بـ «ساكرومونتي»، أي الجبل المقدس. وما زالت حفلاتها تعتبر من الأنشطة الثقافية التي تقدمها مدينة غرناطة في عصرنا الراهن لسياحها، ولا سيما الأجانب منهم.
تضمن الكتاب 28 أغنية إسبانية، بعضها أداها مغنون إسبان، والبعض الآخر غلب عليه الأداء الجماعي، بوصفها أغنيات تراثية حية في المجالين الإسباني والبرتغالي، وهو ثمرة التزاوج التراثي والحضاري بين الثقافتين الإسلامية والمسيحية، اللتين تعايشتا في تلك الحقبة على امتداد ثمانية قرون. وما ميز القصص والأساطير الإسبانية، وعددها 22 قصة وأسطورة، التي وردت في الكتاب، أنها ما زالت شاهدة على الأحداث التي احتوتها، عبر الأماكن والمعالم الإسبانية، التي ما زالت ماثلة أمام الناظرين إليها، ويحمل بعضها معاني وأسماء إسلامية، مثل أساطير قصر الحمراء في مدينة غرناطة، وبخاصة بهو الأسود، وأسطورة «المورو الأعور» (المورو كناية عن المسلم)، وأسطورة «صخرة المسلم»، وأسطورة «الملكة المسلمة»، وأسطورة «كهف المسلمة»، وأسطورة «مسلم جبل المنارة بمدريد»، وقصة «كنيسة القديسة فطيمة» في البرتغال، وغيرها من القصص والأساطير المستندة إلى فترة الحكم الإسلامي للأندلس وجنوب البرتغال.


