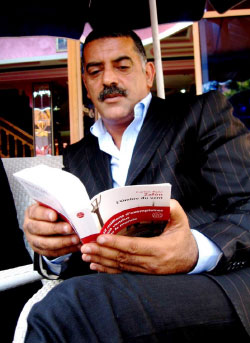يشتغل محمد آيت لعميم أستاذاً للتعليم العالي، ومديراً لمهرجان قصيدة النثر الذي يشرف عليه «مركز الحمراء» ويرأسه زميله الشاعر نور الدين بازين. من مؤلفاته: «بورخيس أسطورة الأدب»، «المتنبي الروح القلقة والترحال الأبدي»، «القراءة لفانسون جوف»، «قصيدة النثر: في مديح اللبس»، «بورخيس صانع المتاهات». كما يصدر له قريباً «قصيدة النثر العربية، إيقاع المعنى وذكاء العبارة» وترجمة لكتاب بيار بايار «كيف نتحدث عن كتب لم نقرأها».
عقب اختتام «مهرجان قصيدة النثر» في أجواء جميلة جمعت بين الشعر والجاز حيث قرأ الشعراء وغنوا ورقصوا أيضاً، التقينا بمحمد آيت لعميم وفتحنا معه النقاش حول راهن الكتابة والترجمة، وعما إذا كان المغرب فعلاً بلد نقد، وعن سرّ ميل النقاد المغاربة إلى السرد على حساب الشعر.
■ لنبدأ من كتابك الجديد «بورخيس صانع المتاهات» (المركز الثقافي العربي ـ 2017)، وكنت قد أفردت له كتاباً آخر قبل سنوات، ما هي دوافع اختيار بورخيس؟
أنجزت كتابين عن بورخيس الأول نشرته عام 2006 وكان عنوانه «بورخيس أسطورة الأدب»، والثاني بعنوان «بورخيس صانع المتاهات» صدر أخيراً عن «المركز الثقافي العربي». هذا الاهتمام بهذا الكاتب الساحر والفريد من نوعه مردّه إلى أنني وجدت فيه شيئاً منّي. كلانا عاش في مكتبة أبيه، وأعجبت بموسوعيته، إذ لدي نزوع جبِلي إلى الموسوعية والإدمان على القراءة. لما وقعت يدي عام 1983 في مكتبة «جامعة القاضي عياض» في مراكش على كتابه «محاضرات»، واطلعت على محاضرته حول «ألف ليلة وليلة»، أدركت للتو أنني أقرأ لكاتب ذي ذكاء ملتهب يعرف وجهته أثناء القراءة، ويقود القارئ إلى أرض مجهولة، ويتقن فنّ السؤال حول مسائل لا تخطر على بال القارئ. إنه فعلاً يعلم الذكاء. وجدت فيه شيئاً من الجاحظ، وموسوعيته، وانتحال النصوص وتزييفها، والاهتمام بالحيوانات الواقعية والمتخيلة وتبجيل الكتب والمكتبات. فبورخيس تولى إدارة المكتبة الوطنية في بيونس آيرس، وكان وقتها قد دخل عالم الظلال والعتمات، فقد وصف حالته في قصيدته «الهبات»: أعطاني الظلام والكتب. والجاحظ الذي أتخيله وقد برزت عيناه من فرط التحديق في الكتب، كان يبيت في دكاكين الوراقين. يلتهم الكتب ويفلي النصوص ويفتشها، فكانت نهايته وسط الكتب وقد انهالت عليه. فقد ساقت الأقدار صاحب الروح الفكهة إلى أن يموت داخل مكتبته. ما جعلني أهتم بهذا الكاتب المؤثر في كل من جاء بعده، أنه جمع أشياء تفرقت في أسلافنا، وكان لديه اهتمام بالغ بثقافتنا. فيه موسوعية الجاحظ، وملحمية المتنبي (فقد استشهد ببيتين للمتنبي) وريبية المعري (كلاهما تخيلا الجنة مكتبة ونادياً أدبياً)، تحدث بورخيس عن الغزالي وابن رشد وعن إخوان الصفا وعن «منطق الطير» لفريد الدين العطار. وكان تأثره بـ «ألف ليلة وليلة» حاسماً. هذا الكتاب الخالد الذي يشتمل على كل اللغات والثقافات والزمن كله، سيستخلص منه جوهر مذهبه في كتابه الذي يتمحور حول محو شخصية الكاتب الذي يتحول إلى نساخ، وأن الكتابة ما هي إلا إعادة كتابه داخل مكتبة متاهية شبيهة بالأدراج وبالدمى الروسية. كل هذه الأفكار أوحيت له من خلال تأملاته الدقيقة في معمار «الليالي». في كتابي حول بورخيس، سيجد القارئ العديد من الأفكار حول قصص بورخيس ومقالاته وحواراته وشعره. لقد كان لقائي مع زوجته ماريا كوداما عام 1996 حاسماً في إنجاز كتاب عن بورخيس وعوالمه الذكية والغنية، فهي التي حفزتني للكتابة عن زوجها الذي زار مدينتي مراكش مرتين في 1975 وعام 1985، وحدثته نفسه بالإقامة فيها لأنه وجد في ساحة جامع الفنا تجسيداً لأحلامه الطفولية. وهو الذي كان يوقع مقالاته في بدء أمره اسمين بمرجعية مغربية وعربية: المعتصم المغربي، وأبو القاسم الحضرمي.
■ الكتاب في جزء كبير منه هو بمثابة ترجمات لمقالات كتبت عن بورخيس، وفي الصدد ذاته يأتي سؤالنا عن راهن الترجمة في المغرب، وأنت طبعاً أحد المترجمين عن اللغة الفرنسية. هل أنت مطمئن لحركة الترجمة في المغرب؟ سواء الترجمة النقدية أو الأدبية؟
عرفت الترجمة حركية في الثمانينيات، وكان ممارسوها من الجامعة، وكانت منصبة حول ترجمة النقد والمناهج النقدية. وقد أحدثت هذه الحركية تميزاً في الممارسة النقدية وتحليل النصوص. ظهر ذلك جلياً في فتوحات عبد الفتاح كيليطو حول أشكال السرد القديم، ومحمد مفتاح في تشريحه للنصوص الشعرية القديمة والحديثة، وفي قراءات أحمد اليابوري، ومحمد برادة للنصوص الروائية. جاء بعدهم نقاد آخرون هضموا المناهج المرتبطة بالبنيوية واللسانيات وعلم النص والخطاب، وبالدراسات المرتبطة بالمتخيل والمندمجة مع الأفكار الفلسفية، سواء التفكيك عند دريدا، أو ما ترجم من أعمال لهيدغر، وأيضاً ما ترجم من أبحاث سيميائية. كل هذا أسعف النقاد والدارسين أن يكتسبوا مهارات في تحليل النصوص، فمن نقاد هذه المرحلة نذكر القمري بشير الذي فكك رواية «التجليات» للغيطاني، ومحمد علوط الذي اشتغل على المتخيل، وتمكن من التعاطي مع نصوص مستعصية كما فعل مع شعر بنطلحة. ومن النقاد الذين ينحتون اسمهم بتؤدة وعمق فكري، هناك الناقد خالد بلقاسم الذي استفاد كثيراً من الإرث الصوفي ومن فلاسفة الاختلاف وأفاد من فتوحات هيدغر وموريس بلانشو، ووظف كل ذلك في قراءة النص الشعري المغربي وشعر أدونيس. إن حركية الترجمة النقدية ميزت النقد المغربي بالغور والتدقيق في المفاهيم واكتساب مهارة عالية في التحليل. وهناك ميزة أخرى أن النقد المغربي يسعى إلى أن يكون أدباً، لا خطاباً واصفاً في أفق إنشاء خطاب إبداعي، وهذه سمة جعلت المتتبعين في العالم العربي يقرون للمغاربة بعلو كعبهم في هذا المضمار. إن ترجمة النصوص المؤسسة في النقد والمناهج والأدب (نصوص الشكلانيين الروس، جاكبسون، بنفنيست، رولان بارت، جوليا كريستيفا، تودوروف، أصحاب نظرية التلقي، ميشيل فوكو، أعمال أمبرتو إيكو، خورخي بورخيس) أحدثت نظرة مغايرة للأشياء. لكن يبدو كما لو أنّ هذه الظاهرة قد انحسرت، ولم نعد نسمع أو نرى مثل هذه الأعمال اليوم. وإذا كانت الترجمة قد حققت بعضاً من أهدافها، فما كان ينقص الترجمة هو ترجمة النصوص الإبداعية، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة انفتاح المغاربة على ترجمة بعض النصوص الروائية بتكليفات من دور نشر انتبهت لحرفية التراجمة في المغرب. لكن يبقى الفعل الترجمي في المغرب ضئيلاً وبطيئاً يقوم به أفراد ولا تحتضنه مؤسسات كبرى بمشاريع واستراتيجيات واضحة.
الرواية المغربية جنس فتي لم تراكم ما فيه الكفاية
من نصوص
■ يفترض أن المغرب بلد قريب جغرافياً وتاريخياً لإسبانياً. لكننا نحسّ أنه ليس بلداً رائداً في ترجمة الأدب الإسباني سواء القديم أو الراهن. بل هو على العكس منشغل دائماً بترجمة نتاج الثقافة الفرنسية. أعرف أن السياق الكولونيالي حاضر هنا، لكن ماذا عن الجارة إسبانيا؟ وماذا عن البرتغال أيضاً التي كانت هي الأخرى بلداً مستعمراً للمغرب في فترة معينة؟
بخصوص ترجمة الإبداع في المغرب، أريد أن أشير إلى أنّ ما ترجم في البداية كان من اللغة الإسبانية، فمن النصوص الأولى التي ترجمت في الثلاثينيات رواية دون كيخوتي لـ «سرفانتس» أنجزها التهامي الوزاني صاحب أول رواية سيرية مغربية بعنوان «الزاوية»، وبورخيس في ما بعد ترجمه إبراهيم الخطيب، وترجم أيضاً أعمال خوان غويتوسولو، في حين ترجم الشاعر المهدي أخريف لاحقاً أعمال بيسوا عن البرتغالية «راعي القطيع» و«اللاطمأنينة» و«يوميات»، وترجم لأكتافيو باث «اللهب الأزرق». واستأنف الترجمة عن الإسبانية كل من الشاعر خالد الريسوني والشاعر مزوار الإدريسي وبنعبد الواحد الذي ترجم أنطولوجيا القصة القصيرة جداً، نشرت ضمن مجموعة البحث للقصة القصيرة. إن ترجمة الإبداع في المغرب من نصيب اللغة الإسبانية، وترجمة النقد والفكر من نصيب الفرنسية. لكن ما ينقصنا هو الترجمة عن الإنكليزية والألمانية. وكم كثيرة هي الأشياء التي لا نطلع عليها إلا بعد فوات الأوان.
■ كيف تقرأ حركة الكتابة الروائية في المغرب اليوم قياساً مع العقود السابقة؟ لا أقصد الحضور والتداول فقط، وإنما تحولات الكتابة نفسها: التيمات والتقنيات؟
إن الحديث عن الرواية المغربية يقودنا إلى الإشارة إلى أنّها جنس فتي لم تراكم ما فيه الكفاية من نصوص. بداية الرواية المغربية كانت مرتهنة لسؤال الهوية وللأسئلة السياسية والأيديولوجية للمرحلة كانت فيها الرواية تكتب بواقعية سطحية في الغالب، ولقد كانت الرواية المغربية تضيق الخناق على نفسها، ولا تتنفس هواء يأتيها من جهات العالم. هذا الوضع نلمس أنه بدا يتغير، لا سيما أنّ الرواية المغربية بدأت تطرح سؤال الكتابة كسؤال جوهري لتطورها. وكان هناك انتباه لنواقص الرواية في المغرب، فبدأنا نلمس تحولات في التيمات والتقنيات. ظهرت عندنا رواية الجبل مع أحمد التوفيق وطارق بكاري، رواية البحيرة والنهر مع اسماعيل غزالي، الرواية المناقبية والعرفانية مع بنسالم حميش وأحمد التوفيق وعبد الإله بن عرفة، وروايات سنوات الرصاص والمصالحة عند كل من أحمد لويزي ويوسف فاضل. وقد تفاعلت الرواية أيضاً مع التشكيل والأوساط الثقافية الأوروبية والأميركية كما فعل حسن نجمي في «جيرترود»، وأيضاً كما كتب محمود عبد الغني في «معجم طنجة». وبدأت الرواية المغربية تتجاسر لتعرية أعطاب الشخصية المغربية كما هو الحال في رواية «المغاربة» لعبد الكريم الجويطي، و«هوت ماروك» لعدنان ياسين. وهناك ميسم آخر أسهم في تطوير اللغة الروائية في المغرب هو هجرة الشعراء إلى أرض السرد، فقد حملوا معهم كل طاقاتهم الشعرية وشحنوا بها عوالمهم التخييلية، فللشعر ترفع القبعة.
■ وأنت تورد قبل قليل أسماء نخبة من نقاد المغرب، ماذا أيضاً عن حركة النقد؟ هل تؤمن فعلاً بأن المغرب بلد نقد؟
ما يميز النبوغ المغربي منذ القديم إلى اليوم هو النزوع نحو الاستنباط، والميل إلى البحث عن الغرابة والمختلف، منذ ابن رشد والشاطبي وابن طفيل وابن البناء وحازم القرطاجني والسجلماسي، وصولاً إلى الجابري والعروي وطه عبد الرحمان وكيليطو وسعيد بنكراد وعبد السلام بنعبد العالي ومحمد مفتاح وسعيد يقطين ونور الدين أفاية ومحمد الدكالي وعبد الإله بلقزيز. واللائحة طويلة لقامات فكرية مؤثرة بصمت في المشهد الفكري والنقدي في العالم العربي. هذا النزوع النقدي متأصل في البنية الذهنية المغربية، ما ينقصه هو عقلية الخلف وتأسيس مدارس، مما يؤثر سلباً في الاستمرارية. ومع ذلك، هناك أسماء لها وزنها في الساحة اليوم وتسعى إلى أن تترسخ وتقنع.
■ مال جميع النقاد تقريباً لنقد السرد، الرواية تحديداً. أنت من القلائل الذين انشغلوا بنقد الشعر، وقد ألّفت عنه كتابين مهمين. ما السر في اختيارك؟
بخصوص انشغال النقد المغربي بالسرد قديمه وحديثه، هذا الأمر خرج من الجامعة ومن شعب المناهج، لا سيما أنّ الآليات النقدية التي تم التعامل معها كانت تنتمي إلى حقل السرد. وبذلك تم توجيه البحث في النصوص السردية القديمة وفي الرواية لتجريب فعاليات المناهج والنظريات السردية. لست الوحيد الذي اهتم بالشعر وحده، فاهتمامي متعدد. لدي اهتمام بالشعر والسرد، واشتغلت على المتنبي من منظور نظرية التلقي ونقد النقد، محاولاً بذلك الإجابة عن سؤال استمرارية المتنبي في الزمن، وأيضاً تقويم الحصيلة النقدية حوله في الزمن المعاصر، وتمدداته في التجارب الشعرية العربية الجديدة. كنت منشغلاً في الأساس بمفهوم القراءة وإعادة القراءة، وكان لبورخيس دور كبير في توجيهي صوب هذا الموضوع، وأيضاً قراءتي لكتاب إيتالو كالفينو (لماذا نقرأ الأعمال الكلاسيكية؟). فاشتغالي بشعر المتنبي، في كتابي «المتنبي الروح القلقة والترحال الأبدي»، كان مرتبطاً بنظرة تجديدية للنظر في المدونة النقدية التي تراكمت عبر سنوات من القراءة.
تمتع بورخيس بموسوعية الجاحظ، وملحمية المتنبي وريبية المعري، وتحدث عن الغزالي وابن رشد وعن إخوان الصفا وعن «منطق الطير»
■ ما السر في اختيار قصيدة النثر كموضوع لإنجاز أطروحتك المهمة؟ هل يتعلق الأمر بانتصار لجمالية معينة؟
يعود اهتمامي بقصيدة النثر إلى عام 1988حين امتحنت فيها في مباراة السلك الثالث في «جامعة محمد الخامس» في الرباط من خلال الفصل الذي هاجمت فيه نازك الملائكة القصيدة وخونت كتابها. منذ ذلك الحين وأنا أتعقب مقترفيها، فأدمنت على قراءتها رغم شح منشوراتها السرية. قرأت الماغوط، حسين مردان، عقيل علي، جماعة كركوك (مؤيد الراوي، صلاح فائق، سركون بولص، جان دمو)، وديع سعادة، ديوان «لن» و«الرأس المقطوع» لأنسي الحاج. قرأت «مهن القسوة» لبسام حجار، «مدية واحدة لا تكفي لذبح عصفور» لسيف الرحبي، «دفتر سيجارة» لبول شاوول، «ممر معتم يصلح للرقص» لإيمان مرسال، «أثر العابر» لأمجد ناصر، «حياة صغيرة» لحسن نجمي، «على درج المياه العميقة» لمبارك وساط، «دفاتر الخسران» و«أبداً لن أساعد الزلزال» لأحمد بركات، «حجرة وراء الأرض» لمحمود عبد الغني، «هدنة ما» لحسن الوزاني، «لا أحد في النافذة» لعزيز أزغاي، «مانكان» لياسين عدنان، «مثل أربعاء قديم» لسعد سرحان، «أخيراً وصل الشتاء» و«أنظر وأكتفي بالنظر» لعبد الرحيم الخصار. وقرأت كل ما تحصلت عليه من مجلات ومنشورات: «الأربعائيون»، «جراد»، «إضاءة77»، «فراديس»، الغارة الشعرية»... بعد هذا التراكم والاستئناس بعوالم القصيدة، فكرت في أن أنجز أطروحة دكتوراه، وكانت القصيدة لمَّا تدخل إلى مؤسسات الجامعة إلا نادراً. وجدت في «جامعة سيدي محمد بن عبد الله» في فاس أستاذاً غاية في الفهم هو د.أحمد زكي كنون. لم يتردد حين اقترحت عليه الموضوع، فأنجزت أطروحة سميتها «قصيدة النثر العربية: إيقاع المعنى وذكاء العبارة» نالت إعجاب اللجنة التي ناقشتني لمدة ست ساعات مسترسلة.
■ تديرون ملتقى لقصيدة النثر. هل هذا ترجمة ميدانية لأفق انشغالكم النقدي؟ وما الذي قدمه هذا الملتقى لقصيدة النثر؟
بعد حصولي مباشرة على الدكتوراه، أسسنا «مركز الحمراء للثقافة والفكر» بمعية نور الدين بازين ومنتصر دوما ومحمد بندوري، وتكلفت بإدارة الملتقى الدولي الأول لقصيدة النثر تحت شعار «قصيدة النثر والوعي الحر» شارك فيه شعراء من دول عربية وأوروبية ومن المغرب ومجموعة من النقاد. نجاح الدورة الأولى جعلنا نتشبث بهذا المنجز، فأقمنا الدورة الثانية، دورة محمد الماغوط. لقد كان لهاتين الدورتين وقع كبير جعل المجتمع الثقافي يثق في مشروعنا بعيداً عن الادّعاء والمهاترات. نفخر أنّه من خلال هاتين الدورتين، أنجز شعراء ونقاد أطاريح دكتوراه حول قصيدة النثر من أمثال الباحث محمد العناز، ورشيد الطالبي اللذين حضرا أشغال الدورتين. وللإشارة، فالجمهور الغفير الذي صاحبنا تعرف مباشرة إلى قصيدة النثر، وأسرّ لنا كثيرون أنّ ما سمعوه هو الشعر، لأنه فاجأهم بذائقة جديدة لم يكن لهم قبل بها. أما الدورة الثالثة، دورة سركون بولص، فكانت مفاجأة السنة، لم يخطر في بالنا أنها ستحقق مثل هذا النجاح المبهر. الشاعرات الأميركيات قدمن شعراً عميقاً، وقد أصبن بصعقة الاندهاش أمام أصوات الشعراء المغاربة والعرب الذين كانوا في الموعد، ناهيك عن الفضاءات التي قرئ فيها الشعر «قصر الباهية» الخلاب و«رياض الجبل الأخضر» الحميم. لقد قدم ملتقى قصيدة النثر الكثير لشعراء هذا النمط في الكتابة، لا سيما أنّ الندوات النقدية توجهت نحو معاينة النصوص للنفاذ إلى جوهر جمالية هذه القصيدة، والابتعاد عن المناقشات البيزنطية العقيمة.
■ أنت من الذين يؤكدون على ضرورة التسلح بالمعرفة النظرية للجنس الأدبي الذي يختاره الكاتب، والاستناد أيضاً إلى مرجعية قرائية لمتنه الإبدعي. ألا ترى أنّ الموهبة وحدها تكفي؟
إن التزود بالمعرفة شرط ضروري لإبداع نصوص ستصمد أمام تعرية الزمن، فالموهبة وحدها لا تكفي، ولنا في تاريخ الكتابة شواهد لا يكذبها أحد. فالقراء الكبار وأصحاب المواهب والذكاءات هم الذين بصموا تاريخ الكتابة، وكانت لديهم القدرة الهائلة على تغيير مسارات الكتابة والأدب والتفكير. فقد يكتب إنسان موهوب بدون مرجعية حقيقية وقد يعجبنا ما يكتب، لكن سرعان ما تذهب ريحه ورائحته. ذلك أنّ الكتابة تتغذى على الكتابة، والكتابة الحقيقية هي في جوهرها إعادة كتابة.