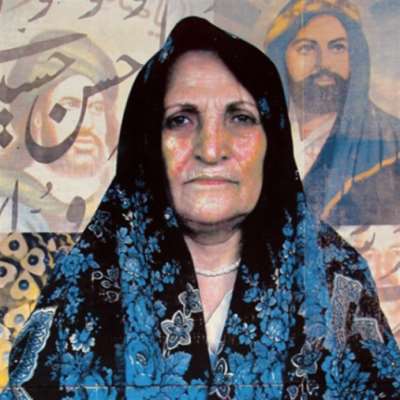درست في الجامعات الفرنسية والكندية والإيطالية وتتابع تحوّلات الرأي العام في أوروبا، كيف تقرأ تراجع الدعم للاحتلال الإسرائيلي في ظلّ ما يحدث في غزّة؟
ـــ يظلّ الإعلام الغربي الرسمي، متبنّياً للسرديّة الإسرائيليّة. وإذا ما أتاحت الفرصة أحياناً للبعض للحديث والتحليل من الذين يحاولون أن يطرحوا القضيّة بصفة موضوعيّة باعتبارها مسألة تتعلّق باستعمار شعب واغتصاب أرضه وتهجيره والتنكيل به لمدّة سبعة عقود، فيكون ذلك على حياء و لذرّ الرماد في العيون وللإيهام بالموضوعيّة. غير أنّ أهمّ تحول حدث في السنوات الأخيرة يتمثل في الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال الاجتماعي التي تشكّلت في جزء منها على هامش الإعلام الرسمي، وأتاحت الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم، وكشف المستور بالصورة الدامغة التي تعتّم عليها عادةً وسائل الإعلام الرسميّة التي كشفت عن بشاعة ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفّة الغربيّة وإنْ بدرجة أقلّ. هذا ما أسهم في إنارة الرأي العام الغربي، خصوصاً لدى شرائح مهمّة من الشباب كطلبة المعاهد والجامعات.

وما يحدث الآن في الجامعات الأميركيّة لم يسبق له مثيل إلا في حرب فييتنام في أواخر الستينيات، من تظاهرات مساندة للفلسطينيين والتنديد بالإبادة الجماعيّة التي يتعرّضون لها ومنابر للحوار للتعريف بالقضيّة الفلسطينيّة وتفنيد السرديّة الإسرائيليّة والأميركيّة الرسميّة. جزء من هؤلاء الشباب ينتمون إلى الحزب الديموقراطي الحاكم الآن أو يصوّتون له عادة. هم غاضبون هذه الأيّام وسيكون لصوتهم شأن في الانتخابات الرئاسيّة القادمة، والأرجح أنّهم سيحجمون عن التصويت هذه المرة، ما يخدم مصلحة دونالد ترامب. إلى أيّ حدّ سيكون لهؤلاء تأثير في السياسة الأميركيّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة في قادم السنوات؟ هذا ما ستخبئه الأيّام ولكن هناك كثير من الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا التحوّل بما في ذلك الدروس التي ينبغي أن يتعلّمها العرب والمسلمون. الدرس الأوّل أنّه رغم بشاعة ما يحدث في غزة والذي لم يشهد له تاريخ البشريّة الحديث مثيلاً، فإنّه ما زال في إمكاننا أن نتحدّث عن ضمير إنساني، عن بذرة الميل إلى العدل والإنصاف التي لم تمت في الإنسانية. لكن ثمّة دروس أخرى هي الأهم لا بدّ من أن نستخلصها، ولكن لن يكون ذلك سهلاً حتى لدى هؤلاء الذين يقودون المقاومة الفلسطينيّة اليوم، وهي أنّ القضيّة الفلسطينية قضيّة إنسانيّة قبل أن تكون إسلامية. فهي بقدر ما هي قضية المسلمين، هي قضية كلّ الشرفاء من الملل والنحل المختلفة. هي كذلك قضية المسيحيين، وجزء مهم من الفلسطينيين ومن مناصريهم هم من أتباع هذه الديانة، بل هي قضيّة اليهود، كل هؤلاء اليهود الذين تجرّأوا على قول كلمة حقّ وتعرّضوا للثلب والمحاصرة والتهديد من بني ملّتهم ووصلت تصريحاتهم بالصوت والصورة متبرّئةً من الجريمة التي يقترفها الكيان الصهيوني باسمهم. لكن هيهات أن يقتنع بذلك الكثير من أهل ملّتنا المسلمين بسبب عمائهم العقائدي الذين يجعلهم يحصرون هذه القضيّة في زاوية ويجرّدونها من طابعها الإنساني ويخدمون تبعاً لذلك من دون وعي منهم الكيان الصهيوني. خلال الأشهر الماضية، تابعت الكثير من الفيديوهات لشخصيات يهودية من كل الأعمار مناصرة للفلسطينيين ومندّدة بإسرائيل متبرّئة ممّا ترتكبه من جرائم مشينة تناقلها العرب المسلمون على صفحاتهم في الفايسبوك. معظم التعليقات هي ذاتها. أستحضر رسالة بالصورة والصوت لطالبة يهوديّة أميركية ساخطة على دولة إسرائيل متهمةً إياها باغتصاب أرض فلسطين ومكيلةً لها أبشع النعوت. تقول في رسالتها إنّ عائلتها قد طردتها وتبرّأت منها وأنّ بعضاً من أصدقائها اليهود قد هجرها، بل ذهب بعضهم إلى تهديدها وأصبحت تعيش ما يشبه العزلة والخوف من التعرّض لمكروه. لكن هذا لن يثنيها كما تضيف عن نصرة الحق مهما كلّفها ذلك. عشرات التعليقات على رسالتها تردّد «اللهم انصر الإسلام والمسلمين»، متناسية أنّ الفتاة يهودية. لا أحد ذكرها بخير ونوّه بموقفها وأثنى على شجاعتها ودعا إلى نصرتها. جحود لا مثيل له وانغلاق مخيف يشكّل خطراً حقيقياً على القضيّة الفلسطينيّة بتحويلها إلى قضيّة دينيّة. بهذه الطريقة، نفقد البوصلة ونقدّم خدمةً إلى إسرائيل التي سعت في العقود الأخيرة إلى تحويلها إلى قضيّة دينية: أي مسلمون غالبيّة ضدّ يهود أقليّة في عالم عربي إسلامي مترامي الأطراف يحاصرها وقد نجحت في ذلك. المشاعر الدينيّة المتأجّجة قد تخدم القضايا العادلة حتى مقاومة الاستعمار كما يعلّمنا التاريخ، ولكنها تؤجّل متاعب أخرى كبيرة إلى ما بعد التحرير، إلى مرحلة بناء الدولة التي إذا ما بنيت على أسس إسلامية في مجتمع فلسطيني متعدّد الديانات، فقد تهدّد باندلاع فتن طائفيّة ولنا في تاريخ لبنان الحديث ما يحذّرنا من ذلك.
كتابك «الزعيم في المخيال العربي الإسلامي» الصادر قبل ثلاثين عاماً، ما زال مثيراً للجدل. كيف انتقلت من صورة «الزعيم» إلى الحكاية الشعبية؟
ـــــ انشغالي بالمخيال العربي الإسلامي انطلق من المدوّنة العالمة الرسمّية القديمة عبر كتابي «الزعيم السياسيّ في المخيال الإسلاميّ» ليصل إلى المدوّنة الشعبيّة بانشغالي بالحكاية الشعبيّة التونسيّة أولاً عبر كتابي «أنتروبولوجيا الحكاية» قبل أن أوسّع مجال مدوّنتي، ليشمل حكايات شعبية عربيّة عبر «الأمّ الرسولة» ومؤلّفات أخرى.
دافعي للانشغال بالمخيال كان أثناء حرب الخليج الثانية بسبب ما لاحظته مندهشاً من التمجيد الأسطوري لصدام حسين لدى شرائح مهمّة ليس من العوام العرب فحسب، وإنّما أيضاً من نخبهم المثقفة. أذكر أنّني شاهدت ـــ غير مصدّق ـــ رسماً في جريدة يوميّة تونسيّة لصدّام حسين يمتطي صهوة جواد أبيض يهمّ بدخول القدس، قيل إنّه تجسيد لحلم شيخ من شيوخ الدين في فلسطين تحدّث عن شعرة قيل إنّها موجودة في ثنايا سورة البقرة في مصاحف القرآن الكريم تثبت الصفة الخارقة لصدّام حسين في استعادة غير واعية بالطبع للأيّوبي صلاح الدين مع إعادة تشكيل الصّورة، ليصير صدّام كأنّه المهديّ المنتظر يعود بعد غيبته إلى الأرض – مثله مثل المسيح – ليملأ الدّنيا عدلاً بعدما مُلئت جوراً.
انهمك بعضهم بما في ذلك أساتذة وباحثون في الآداب والعلوم الاجتماعيّة ــ وقد كنت شاهداً على ذلك بنفسي في المكتبة الوطنيّة التونسيّة ــ وكذلك معلّمون وأطبّاء ومهندسون وإعلاميون في البحث عن هذه الشعرة في المصاحف، وادّعى بعضهم أنّه وجدها، والبعض الآخر أنّه رآها ولكنّه لم يستطع لرهافتها الخارقة أن يمسكها بإصبعه. علاوة على ذلك، شاع وسرى خبر الحمل الذي ولد ومكتوب على بطنه اسم «صدّام»، ونشرت صورة هذا الحمل في صحيفة يوميّة تونسيّة لم أعد أستحضر الآن اسمها. ومن الواضح أنّ ربط صدّام بالحمل والولادة هو إدغام له في الطبيعة، إذ لم يعد يستمدّ شرعيّته السياسيّة من الحيوان النّاطق وإنّما كذلك من الحيوان الأبكم. لقد رسم مخيال المقهورين والخائبين تاريخيّاً لصدّام صورة الكبش المنشود الذي في إمكانه أن يجدّد القطيع العربيّ وينمّيه ويبعث بفحولته الحياة في أمّة شاخت وهرمت ولم تعد قادرة على الولادة؟ لقد تأكّد لي بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ التصدّي للمخيال العربي الإسلامي هو ضرورة ملحّة وليست ترفاً أكاديميّاً لأنّ المخيال وهو يرسم صورة زعيم عربي بمثل هذه الملامح، إنّما يسهم بدرجة كبيرة في تأبيد الاستبداد والتخلّف وصنع الأوهام.
عدد كبير من المثقفين العرب هلّل لـ«الربيع العربي»، كيف ترى حصيلة هذه المرحلة؟
ـــ ثمّة أسئلة ملحّة ينبغي طرحها على النخب العربيّة بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على اندلاع ما سُمّي بالربيع العربي. هل أنّ استنساخ الديمقراطيّة الغربيّة وإسقاطها على شعوبنا بصفة آلية من دون تروٍّ أو تفكير هو الحلّ الأمثل؟ هل الديمقراطية الغربيّة صالحة لنا وتتلاءم مع مجتمعاتنا؟ نعم قال مَن انخرط من النخب العربيّة في ما سُمّي عبثاً بـ «الانتقال الديمقراطي»، ومَن بشّر به وهيّأ له. وهنا أنطلق من التجربة التونسيّة ليس فقط لأنّني أعرفها أفضل من غيرها وإنّما لكونها كانت المنطلق لما حدث في بلدان عربيّة أخرى. انخرط «مثقفون» وسياسيون على اختلاف مشاربهم من التيارات الكبرى من اليسار الماركسي والقومي ومن الإسلاميين، أي من كلّ أولئك الذين ضاقت بهم السبل ولم يجدوا من الحلول إلّا ركوب موجة «الديمقراطية» الغربيّة لتحقيق بعض أحلامهم المهدورة. المفارقة تكمن في كون هؤلاء لا يؤمنون في أدبياتهم الأصلية بالديمقراطيّة الليبرالية على الطريقة الغربيّة لكون بعضهم يعتبرها حيلة رأسمالية لتأبيد هيمنتها على الطبقات الكادحة، والبعض الآخر يراها تتناقض مع التقاليد السياسيّة الإسلامية التي توجب أن يكون في الأمّة راعٍ مسؤول عن رعيّته يساعده في ذلك «أهل الحلّ والعقد» من النخبة العالِمة لسياسة عوام الأمّة تارة بالعصا الغليظة وطوراً بالمزمار كما أطلقت عليها وبيّنتها في كتابي «الزعيم السياسي في المخيال الإسلامي» (1992). وما ملاءمة الإسلام للديمقراطيّة إلّا محاولة ترقيعيّة تلفيقيّة هدفها استمالة الغرب بحثاً عن دعمه للوصول إلى الحكم.
انخرط في ذلك جزء مهمّ من النخبة المثقفة والسياسيّة التونسيّة الفاعلة في الشأن العام وبعضها انتهازي تحيّن الفرصة عطشاً للمناصب والسلطة، هذا إذا صحّ بالطبع أن نطلق عليها صفة «مثقفة» لأنّ هذه الصفة تتطلّب من المرء «التمحيص والتدقيق وإعمال العقل» وليس الانسياق وراء الشهوات والتهويمات. استيراد نظام سياسي من الخارج يجب أن يعير أوّلاً الاهتمام للعوامل الموضوعيّة: السياق التاريخي والثقافي والاجتماعي- الاقتصادي إذا ما كانت ملائمة أم لا لاستقبال هذا الوافد الجديد وتوطينه، كما المزارع الذي يرغب في استيراد نبتة من خارج أرضه وينبغي له معرفة ما إذا كانت تربته صالحة لها أو ينبغي أن يهيّئها في أفضل الحالات لاستقبالها حتّى تنمو وتترعرع وتثمر فلا تذبل ولا تموت.
لم ينفتح هؤلاء على تجارب إنسانيّة أخرى في الحكم وظلّوا منحبسين في أدبيات الديمقراطيّة الغربيّة. لو انفتح بعض هؤلاء مثلاً على الأدبيات الصينيّة، وأنا أتحدّث عن النزهاء والصادقين منهم، لكان لهم رأي آخر ولجنّبونا هذه الورطة، والسقوط في هذه الهوّة التي تردّينا فيها ولا أحد يعرف كيف يمكننا الخروج منها. على عكس النخب التونسيّة والعربيّة من دعاة الديموقراطيّة الغربيّة، قال المثقفون الصينيون لا لديمقراطية مستوردة ومسقطة من الخارج. ولا تظنّن أنّ هؤلاء من مثقفي الحزب الشيوعي الحاكم كما يمكن أن يتبادر إلى الأذهان للوهلة الأولى، وإنّما يشاطرهم في ذلك المثقفون الليبراليون الذين سجن الحزب الشيوعي بعضَهم في مدة من مدات حياتهم وغالبيتهم أساتذة جامعيون ومفكّرون وفيهم من حصل على جوائز في الغرب.
ملاءمة الإسلام للديمقراطيّة محاولة ترقيعيّة تلفيقيّة هدفها استمالة الغرب بحثاً عن دعمه للوصول إلى الحكم
لماذا يقول هؤلاء «لا» لتقليد أعمى للديمقراطية الغربيّة؟ لعوامل عدّة ولأنّ عرضها كلّها بالتفصيل يتطلّب كتاباً كاملاً نكتفي بعاملين: إنّ الشعب الصيني غالبيته (800 مليون) من العمّال والفلّاحين وفيهم نسبة كبيرة نزحت إلى المدن وهؤلاء منقادون بطبعهم (لثقافتهم المحدودة جدّاً) لشهواتهم وغرائزهم ويسهل التلاعب بهم، وحتّى شراء أصواتهم. ولذلك لا ينبغي إشراكهم في صنع حاضر البلاد ومستقبلها. تشريكهم بتعبير خلدوني حتى وإن كانت الفكرة صينية «مؤذن بخراب العمران» وحتّى الليبراليين الأكثر تطرّفاً في ليبراليتهم، يرون أنّ هؤلاء لا ينبغي تمتيعهم بحق الانتخاب قبل أن يتحوّلوا إلى مواطنين حقيقيين واعين بمسؤولياتهم كي لا ينتخبوا حكّاماً سيئين. وثانياً لأنّ تقاليد المجتمع الصيني وثقافته كما يقول أحد المفكرين الصينيين وهو لي كيانغ «لا تسمح لنا في الظروف الحالية أن نستورد الديمقراطيّة الغربيّة». ما الحلّ إذن: في الاستبداد والدكتاتوريّة. لا. يقول هؤلاء. هناك طريق ثالث: ما هو؟ انتصاب أقلّية مثقفة واعية في الحكم تقود الشعب نحو الأفضل واتباع سياسة المراحل في إدماجه في تقرير مصيره - بتثقيفه - وتعليمه وتربيته على احترام القانون وتقديس العمل لمصلحة الشأن العام.
يقول الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2010 ليو كسايوبو «أمام التفاهة السائدة في المجتمع التي تتجسّد في غلبة المصالح الخاصة الضيقة، ليس ثمّة أنبل من هذه المهمّة أن تنهض بالأمّة أقليّة مستنيرة وطاهرة تغلّب المصلحة العامة على المصلحة الشخصيّة والقطاعيّة والحزبيّة». ويشاطره في ذلك يو كبينغ، أحد أشهر الليبراليين الصينيين في الغرب الذي يقول: «إنّ الديمقراطية بالنسبة إليّ ليست تمثيلية وانتخابات، وإنّما حوكمة رشيدة يسهر عليها تكنوقراط نزهاء وصادقون». وخلاصة القول، إنّ المثقفين الصينيين على اختلاف مشاربهم سواء من الليبراليين أو المحافظين مجمعون على أنّ مصلحة شعبهم ليست في ديمقراطية تنسخ المنوال الغربي وإنّما في أن مَن يقود لا تغريه المصالح «المادية السافلة أو السفليّة للحياة» أي ملذاتها وأموالها. ليس مصادفة في شيء إذن أن نرى الصين، وهي التي تمتلك مثل عقول هؤلاء المثقفين، أن تتربّع اليوم سيّدة العالم في رخاء ونماء وازدهار مستمرّ. أما نحن الذين ابتلينا بمثقفين وما هم بمثقفين لا يقرأون وغير مطلعين على تجارب الشعوب، فيما قِبلتهم الوحيدة هي «المركزية الغربيّة»، فقد رأينا عاقبة ذلك في تونس من تخريب وتدمير لكلّ المكتسبات التي رعتها الدولة في السنوات العشرين الأولى التي تلت الاستقلال.
خلاصة الأمر ما يقوله المثقفون الصينيون في توصيف مجتمعهم ينطبق تماماً على مجتمعاتنا العربيّة وأنا أتبنّى رؤيتهم للحكم في استبعاد العوام: «الجمهور والجماهير» من المشاركة في السلطة ودعوتهم لانتصاب نخبة مستنيرة من «التكنوقراط» ونزيهة تعمل للصالح العام. لا خير في ديمقراطيّة تساوي بين العالم والجاهل.
هل تعتقد أنّ الحكايات هي خزّان الشعوب؟
ـــــ إنّ اهتمامي بالحكاية الشعبيّة العربيّة يعود كما قلت إذن إلى اهتمامي القديم بالمخيال العربي الإسلامي. لكن قد تترجم العودة إلى خرافات الجدات والأمهات بجمعها وحفظها ودراستها عن رغبة غير واعية في العودة إلى الحضن الدافئ للأم والجدّة بعدما ضاق المرء ذرعاً باغترابه في الثقافة المكتوبة الرسمية، الثقافة البطريركيّة المتسبّبة في ما نعانيه من تخلّف وانحطاط. أعتقد أنّ الأنثروبولوجية الفرنسيّة كاميّ لاكوست دو جاردان كانت على حقّ عندما لاحظت أنه ليس من المصادفة أن يتحمّس الكثير من الباحثين العرب للأدب الشفوي جمعاً ودراسة. فبحوثهم في علاقة تواصل وثيقة بأمّهاتهم اللواتي يبثثن هذا الأدب، ومن ثمّة فهم مشغولون بهاجس الرفع من شأن هؤلاء الأمّهات اللواتي ظللن مهمّشات بل مبعدات أكثر من أيّ وقت مضى عن التطوّرات التي تشهدها مجتمعاتهنّ. الدروس التي تقدّمها حكايات الجدّات والأمّهات كثيرة، ومن المؤسف أن يظلّ هذا التراث مهملاً ومبعداً في عدد من الجامعات العربية إلى اليوم باستثناء قلّة منها لها تقليد عريق في ذلك. لكن ما يبعث على التفاؤل هو الاهتمام الذي توليه بعض المؤسسات العربيّة في جمع التراث الشفوي بما في ذلك النسوي.
على عكس النخب التونسيّة والعربيّة من دعاة الديمقراطيّة الغربيّة، قال المثقفون الصينيون لا لديمقراطية مستوردة
وهنا لا بدّ من التنويه بالعمل الذي يقوم به «معهد الشارقة للتراث» في هذا الاتجاه. لقد بدأ هذا الاهتمام بالتراث الشفوي في الغرب منذ القرن التاسع عشر والأعمال التي أنجزت حول الحكايات الشعبية في أوروبا وأميركا كثيرة. وليس من الغرابة أن يهتمّ كبار علماء التحليل النفسي والفولكلور بذلك. لقد همّشت الجامعات العربية عموماً التراث الشعبي إلا في ما قلّ وندر من الحالات لأسباب أيديولوجية لا علاقة لها بالعلم وترتبط بهموم الدولة الوطنية التي كان شغلها الشاغل الحفاظ على اللغة العربية الفصحى وتدعيم أركانها في الجامعة، ولذلك أُبعد التراث الشفوي لأنّ لغته هي العامية الدارجة التي نظر إليها بوصفها خطراً يهدّد الفصحى عوض أن ينظر إليها باعتبارها رافداً من روافدها وعاملاً من عوامل إثرائها وحيويتها.
ماذا عن كتابك الذي سيصدر قريباً «الرجل الذي حبل: السلطة، الولادة وتأنيث الوجود من خلال الحكاية الخرافيّة الشعبيّة العربيّة»، وهو عنوان مثير للدهشة والاستغراب؟
ـــ في هذا الكتاب، تناولت حكاية خرافيّة شعبيّة تتبعتها خلال السنوات العشرين الماضية وجمعت عشر روايات لها في العالم العربي: تونس، والمغرب، ومصر، وفلسطين، والسعودية والإمارات واليمن وعُمان. ملخّص هذه الحكاية التي تناولتها بالتحليل أنثروبولوجيّاً مع مقارنتها بما يشبهها في التراث العالمي، يتمثّل في حبل رجل كما تحبل امرأة لأكله تفاحة أو ترنجة أو سمكة الحبل في غفلة منه عوض زوجته العاقر، فيتوحّم ويشتهي المأكولات الطيبة، فتخفيه زوجته عن الناس مخافة الفضيحة. وعندما يحين موعد ولادته، يخرج إلى الخلاء ويلد تحت شجرة بنتاً يتركها لحالها فتحملها الطيور إلى أعشاشها وتربّيها وتغذيها حتى تصبح فتاة بارعة الجمال فيفتن بها ابن السلطان ويتزوجها. في كلّ الروايات العربيّة العشر لهذه الحكاية، ليس هناك رواية واحدة يلد فيها الرجل الذي حبل ذكراً. يلد دوماً بنتاً، وهذا قد لفت انتباهي وحلّلته في الكتاب وأشرت إليه في العنوان بـ «تأنيث الوجود» مستلهماً هذا التأويل من الشيخ الأكبر محيي الدين عربي الذي أعار الأنوثة مكانة متميّزة في فكره. هذا الكتاب هو الأوّل في العالم العربي الذي يطرق هذا الموضوع الشائك والمعقّد الذي يجمع بين الجدّ والهزل.