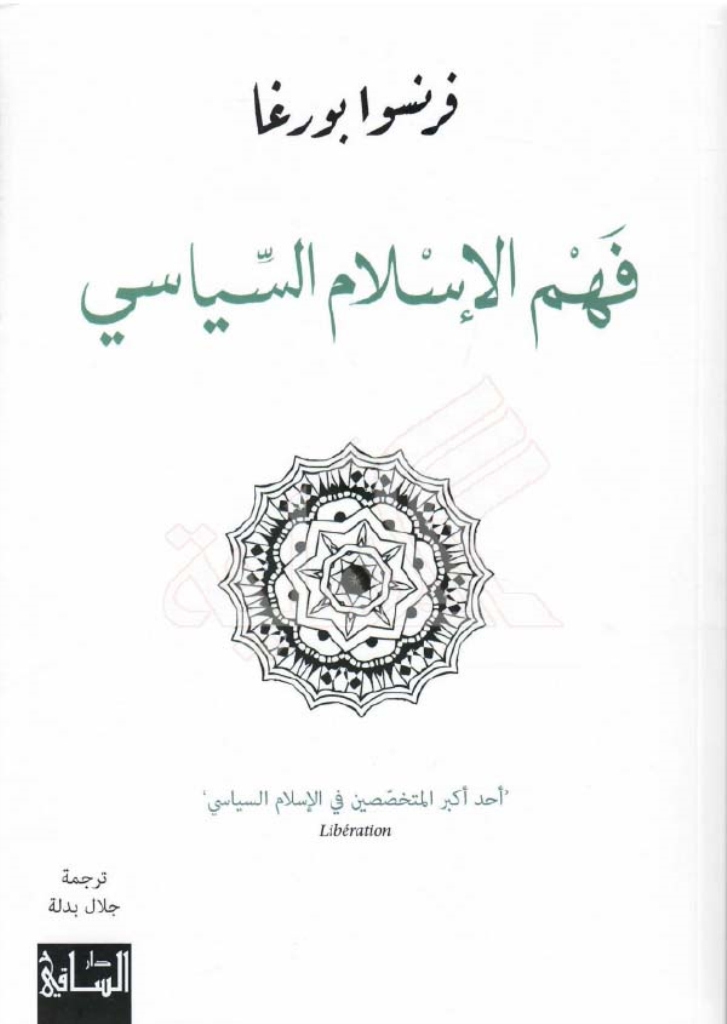
ليس العرض عرضاً مجانياً، بل هدفه التذكير أن وسائل الإعلام الفرنسية تحديداً، هرولت خلف نظرة تبسيطية للحدث الجزائري، لفهم الإسلام السياسي، منذ انتصار الثورة الإيرانية. وستشكل الفبركة الإعلامية المناهضة للإسلام السياسي ركيزة أساسية في الإعلام التبريري الذاتي للأنظمة الاستبدادية. إلى هذه الإشارات، يُحسب له إصراره على ضرورة تجنّب الاكتفاء بمراقبة التصرفات السيئة للفاعلين الإسلاميين، ويقترح تضمين تلك الصادرة عن الأطراف المقابلة أيضاً، على مستوى دولي، التي لا تتخذ من الإسلام مرجعية سياسية، وبشكل أوسع الأطراف غير المسلمة. على عكس الماينستريم، يعتقد بورغا أن الأصولية السياسية هي التي تقود إلى أشكال مختلفة من أصوليات إسلامية وليس العكس. سيعارض التيار السائد مرة جديدة، في مسألة أكثر حساسية. في رحلة إلى تل أبيب، سمع خطاباً مهولاً، يشبه خطاب المستعمرين الفرنسيين في الجزائر «عندما كانوا يشرحون أنهم لم يواجهوا أي مشكلة مع الفلاحين المأجورين وأن الذين ينشرون العداوة كانوا يأتون من بعيد». رغم إقامته في القدس منتصف التسعينيات لأسباب بحثية، فإن بورغا هو واحد من المثقفين الفرنسيين القلة الذين يفهمون الصلة بين الاحتلال الإسرائيلي وبين طبيعته الاستعمارية، ويرفضون الاعتراف بشرعية هذا الوجود.
يتجاوز الباحث الفرنسي نزعاته الابستيمولوجية أحياناً، يستأنف التنقيب في رحلاته الشخصية، فيتذكر بيروت في 1966. كان يجهل أن الشاعر ألفونس دو لا مارتين وصف المدينة عند وصولها بأنها «البوابة الكبرى لسوريا». وعندما يسترجعه الباحث ويزجه في مقدمة نصه عن بيروت، فإنّ ذلك يحمل دلالة. الدلالات ستتضح له تباعاً، وفي 2011 ستبلغ الذروة. للأسف يضع الباحث الفرنسي منهجيته على الطاولة، ويؤخذ بموجز لأحد مستشاري رئيس الجمهورية اللبناني. لا يمكن اتّهام بورغا بنزعة استشرافية كامنة، لكن هذه النزعة تظهر عندما يبدو معجباً بما أخبره إياه المستشار: «لبنان هو بداية تاريخ الهيمنة السياسية للمسيحيين الذين من أجلهم أوجد الفرنسيون هذا البلد. وهو لاحقاً تاريخ البروز السياسي للسنة. نحن الآن نعيش في المرحلة الثالثة التي تم تأجيلها دوماً: مرحلة الحضور الشيعي». وليس مفهوماً كيف أن باحثاً كبورغا، يأتي من خلفية ماركسية، ويفهم التركيبة الحقيقية للمجتمع، يصدّق كلاماً تبسيطياً مثل هذا الذي نقل له عن أحكام الطوائف. لكن «النوستالجيا اللبنانية» لا تنسحب على الأحوال العربية. خلال السنوات الطويلة، لم تكن رحلاته سهلة دائماً. في ليبيا، لم يكن الوصول إلى المعارضين الناجين من القمع سهلاً. كان الأمر شبيهاً بالقمع البعثي في سوريا وفي العراق أيضاً. في 1983، همس في أذنه أحد المارة: «نعيش في بلد يحكمه كتاب لا يساوي ثمن الورق الذي طُبِع عليه». وبطبيعة الحال، كان يتحدث عن «الكتاب الأخضر». لكن هذه تبقى معاينة شخصية، لا تقدم أي إضافة للقارئ العربي، الذي لا يفهم دهشة بورغا، وسيعرف أن الذي همس في أذته سيتوارى عن الأنظار سريعاً. ما يميّز بورغا ربما هو فهم العلاقة بين الخطاب والمكان، والعلاقة بين الزمن والخطاب. فالعداء القذافي للغرب، ظل قابلاً للاستخدام في أنظمة مشابهة. وجد بورغا هذا العماء الطوعي نفسه في 2011 في سوريا... «فنهج بشار الأسد المناهض للإمبريالية سيحميه من تعبئة جزء واسع من الرأي العام العربي ضده». وحدوث هذه التعبئة من عدمه يستدعي نقاشاً منفصلاً خارج موضوع «الإسلام السياسي». لكن ما يفترضه بورغا هو أن «المناهضين البافلوفيين للإمبريالية» سيدعمون أي خطاب ضد الإمبريالية، من دون بحث أو تدقيق.
الفرنسيون لم يروا من الربيع العربي إلا عالماً يوافق أحلامهم، أي أحلام الغربيين
بعد محاولاته لسبك كتاب يراوح بين السيرة والمعاينة من جهة والابستيمولوجيا من جهة أخرى، يصل إلى خلاصات متوقعة. لا نعرف إذا كان عنوان الخاتمة مقصوداً، لكن يبدو أنه كذلك. «وهلأ لوين». هفوة أخرى للباحث الذي يحاول التماهي مع الشرق الذي يدرسه، فينسى عدته المنهجية ويستعير العنوان من الشريط السينمائي الذي قام على التسطيح. وإن كانت الاستعارة لغوية صرف، فذلك سيكون أقل وقعاً. في خلاصة محاولاته لفهم الإسلام السياسي، يعرف بورغا جيداً أن الفرنسيين لم يروا من الربيع العربي إلا عالماً يوافق أحلامهم، أي أحلام الغربيين، وهي أحلام تبدو له مجنونة، وغير واقعية. عالم مطهر من كل تجلٍّ للآخرية العربية والمسلمة التي على تناقض من المصالح الغربية. لقد رأوا عالماً ملائماً لهيمنة الغرب الثقافية والسياسية، رأوا ما كانوا يبحثون عنه. بمعنى ما، أرادوا من الثورات العربية أن تنتج ما أنتجته الأنظمة على مستوى خطابها الذي ساير الغرب لوقت طويل: «عالم بلا ملتحين ومن النساء المحجبات، عالم خالٍ من الشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية والمناوئة للغرب».
فهم الإسلام السياسي ما زال أصعب مما يتصور كثيرون. لوقتٍ طويل، لم يقم هذا الفهم على قاعدة منهجية، ولهذا ربما تبدو أهم فرضيات بورغا على الإطلاق تلك التي تحاول تحديد العلاقة بين الإسلام والسياسة: التطرف في السياسة هو الذي يسبب تطرفاً في الدين، وليس العكس.


