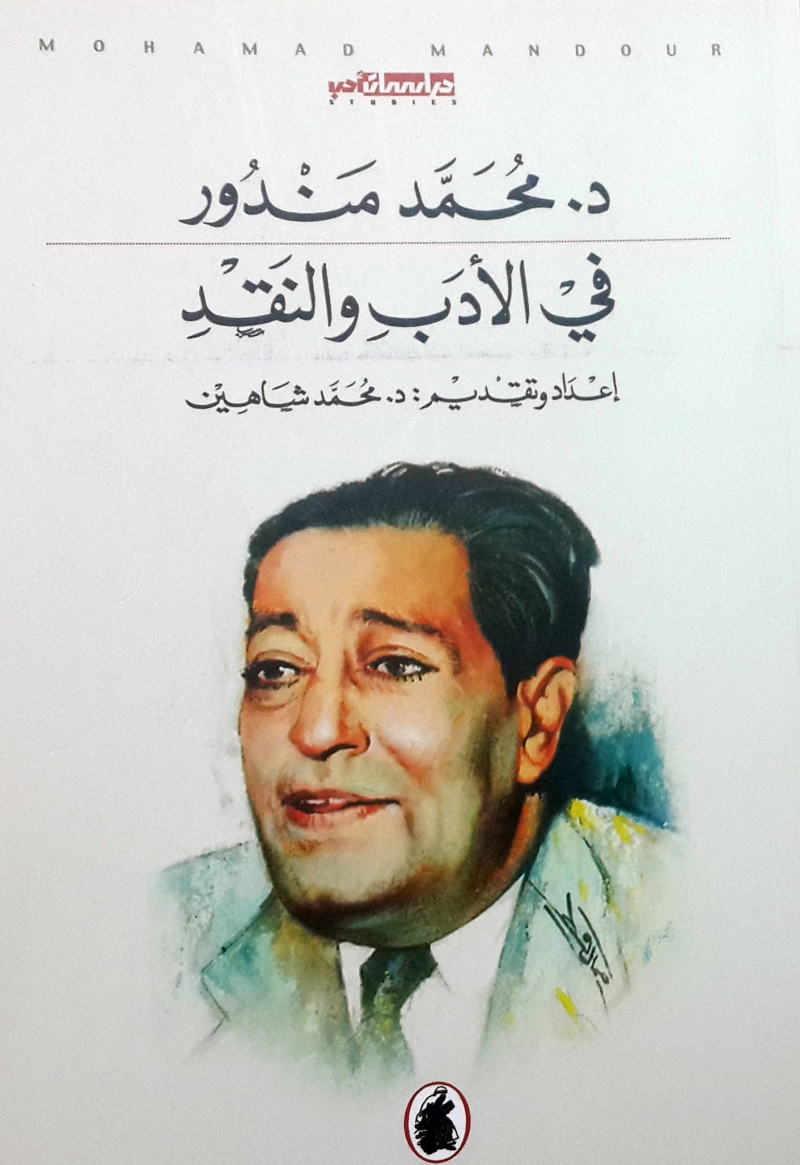يمرر المعلومة بسهولة فذة ويميل إلى الكتابة الشارحة المسهبةطُبع هذا الكتاب «النقدي» (يقع على 172 صفحة من القطع المتوسط على امتداد أربعة فصول) بعدما أقيمت احتفالية دولية في العام الفائت حول مندور بعنوان «محمد مندور بين النقد الأدبي والفكر السياسي» وكان هذا الكتاب واحداً من أوراق البحث الرئيسة فيها. منذ بداية الكتاب، يقدّم مندور الفكرة خلف الكتاب بأنّها «صيرورة» النقد، فمن «المعلوم أن شعراء العرب أنفسهم في الجاهلية كانوا نقاداً، وقد ضربت للنابغة (يقصد النابغة الذبياني) خيمة يحكم فيها بين الشعراء. كما كان أول نقاد اليونان أرستوفان شاعراً روائياً، وقد خصص روايةً بأكملها لنقد شعراء التراجيديا الثلاثة أسكيلوس وسوفوكل ويوربيدس». لذلك فهو يصر على أنَّ النقد الأدبي سبق الأدب بحدّ ذاته أحياناً، فهو ببساطة كان معاصراً لخلق الأدب في حد ذاته، ولو أنَّ التاريخ الأدبي «لا ينشأ عادةً إلا بعد أن يجتمع لكل أمةٍ تراث أدبي يستحق أن يؤرّخ».
يشرّح الفصل الأوّل تأريخ النقد الأدبي، متناولاً أبرز أنواع النقد الأدبي متحدثاً عن النقد الاعتقادي، والنقد العلمي، والتاريخي، وأخيراً اللغوي، من دون أن ينسى ارتباط ذلك كله بالأخلاق والآداب العامة والحياة الاجتماعية وبالتأكيد علم النفس لاحقاً. كل هذه الأمور يتناولها الفصل في إطار تركيزه على «التأريخ» في حد ذاته. بعد ذلك، يعطي الناقد المصري لمحاتٍ من تاريخ النقد، فيأخذ أمثلةً من بدايات الآداب مع الإغريق، فيتناول النقد مع الفيلسوف اليوناني أرسطو، لينتقل بعد ذلك إلى العصور الوسطى، ثم إلى الناقد الفرنسي سان بوف (شارل أوغستان سان بوف) ثم إلى أسماءٍ عدة أسهمت في «كسر الكلاسيكية» وخلق إطار نقدي متطور مثل فرنسيس سارسي، فردينان برونوتيير، وإميل فاغيه وصولاً إلى النقد المعاصر لتلك المرحلة. في الفصل الثالث، نلحظ تناولاً مهماً للمذاهب الأدبية، فينطلق في رحلةٍ كانت شديدة الأهمية في تلك المرحلة للتعريف بتلك الأنواع: الكلاسيكية، الرومنطيقية، الواقعية، الطبيعية، الرمزية، والفنية. في الفصل الأخير، يتناول الكاتب النقد المسرحي مقدّماً بحثاً في طبائع المسرح اليوناني، واللاتيني، ثم ينطلق إلى المسرح في القرون الوسطى، ولاحقاً في عصور النهضة لما لتلك المدارس «التاريخية» من أثر على المسرح وعلى نقده بشكلٍ خاص.
طبعاً تقنياً، يبدو الكتاب من «وقتٍ آخر» حيث يميل إلى الكتابة الشارحة المسهبة التي تذكّر كثيراً بأمهات الكتب، والمصادر والمراجع الأولى، إذ يكتب مادةً تقنيةً لكن بلغةٍ مبسّطة، وهو يختلف جذرياً عن الكتب التقنية «المعتادة» في المجال، وخصوصاً تلك التي أتت في أزمنةٍ لاحقة التي «يتباهى» كتّابها بالتعقيد واستعمال لغةٍ أشبه بالطلاسم؛ وهذا أمرٌ يحسب للكتاب. في النقطة عينها، يمكن أيضاً الإشارة إلى أسلوب الكاتب الذي يمرر المعلومة بسهولة فذة كذلك، وهي نقطة أخرى لصالح الكتاب. ما يعاب عليه ككتابٍ «مرجعي» ــ إذا ما أردنا تصنيفه كذلك- أنه لا يحوي أي هوامش أو مصادر أو مراجع، وهو خطأٌ كبير يمكن الوقوف عنده كثيراً، فهل النسخة الأصلية بلا هوامش ومصادر نهائياً؟ وهذا لا يمكن أن يكون، إذ لا يمكن أن يكون صاحبه قد ألّفه بكامله مع ما فيه من إشارات واستذكارات من دون «مصادرٍ» من أي نوع. هذا الخطأ يجعل الكتاب ناقصاً وبشكلٍ فعلي، ويجب حل هذه المشكلة عاجلاً أم آجلاً من خلال إضافة هوامش الدراسة ومراجعها ومصادرها من دون أن ننسى بالطبع استعماله لأسماء بعض الكتّاب الأوروبيين من دون أسمائهم الأولى مثلاً، وهي عادةً كانت تستعمل في الكثيرٍ من كتب تلك المرحلة ولاحقاً تم التخلّص منها. وكان يجدر بمنقّحي الكتاب التنبه إليها، فضلاً عن أخطاء في ترجمة أسماء كتابٍ كثيرين (مثل سان بوف الذي ورد في الكتاب سانت بيف).