لن يختلف حداد في أن تعريف «الطائفية» الذي يقدّمه الباحثان يسلّط الضوء على أبعاد صائبة للمسألة، لكنه، وضمن نموذجه وإطاره المعرفي الذي يقدّمه في كتابه، سيرى فيه قصوراً، كجميع التعريفات المقترحة، حيث استعرض كتابه مسحاً شمل جملة من محاولات وضع تعريف للمصطلح. ينطلق هذا القصور بأحادية أبعاده، وهي أحادية تأتي، كما يجادل حداد، من أن الهوية الطائفية متميزة عن الأوجه (العرقية، والجندرية، والعشائرية، والطبقية) التي تشكّل هوية الإنسان، فالهوية الطائفية بحد ذاتها مركّبة ومتعددة الأوجه. وعليه، يقترح هنا إطاراً معرفياً مختلفاً لفهمها، قائماً على أربعة أبعاد متداخلة ومترابطة ويؤثّر كل بعد فيها في فهمنا للآخر، كل ضمن سياقه، وهي: البعد العقدي، وما دون الوطني، والوطني، والعابر للحدود. (المفارقة أن المطلع على بحث الكاتبين السعوديين سيكتشف أنه وعلى الرغم من عدم تبني النموذج النظري لحداد إلا أنه وعملياً غطى بحثهما الأبعاد الأربعة جميعها).
يضيف حداد إشكالية أخرى في تبني مصطلح «الطائفية»، وهو تعزيزه للنظرة الجوهرانية والغرائبية للمنطقة العربية، حيث تضلل فوضوية هذا المصطلح النظر إلى الأسباب المادية، كشبكات الفساد والمحسوبيات المرمّزة بعناوين طائفية على أنها نتيجة حصرية للهويات والولاءات الطائفية، في تجاهل للمشكلات البنيوية لضعف مؤسسات الدولة والفساد المستشري وانعدام الشفافية وما إلى ذلك. فيتساءل حداد، لماذا يطلق مثلاً على خطاب دونالد ترامب، مصطلح الشعبوية، بينما خطاب زعماء المتمركزين حول طوائفهم يعبّر مثالاً على «الطائفية»؟ ولماذا تختزل الشبكات الزبائنية في لبنان مثلاً بـ«الطائفية»، والأمر ذاته في ممارسات التمييز في التوظيف والتي وبمجرد أن يشارك فيها السنة والشيعة تتحوّل إلى «الطائفية».
إن المسألة التي يريد أن يوضحها الكاتب هنا، أن ليس كل تفاعل وعلاقة بين السنة والشيعة هي انعكاس لديناميكيات طائفية. وحتى إن كانت كذلك، فيجب فهم دور الهويات الطائفية ضمن سياقها وحجمها الصحيح، وليست عملية اختزال، بأن كل ذلك يختصر بلفظ «الطائفية».
يقتضي التخلّص من هذا الاختزال، تبنّي مفردات لغوية مختلفة، يقترح حداد حزمة مفردات مفتاحية، كالتعامل مع مفردة «الطائفية» كصفة وموصوف: التعايش الطائفي، العلاقات الطائفية، التعاون الطائفي، النزاعات الطائفية. ثم يستدرك الكاتب هنا بأن هذا التعامل قد يفشل في بعض الحالات في نزع الصبغة السلبية للمصطلح، فلو أطلقنا على رموز تعبّر عن طقوس وممارسات عقدية لفظ «الرموز الطائفية»، فهنا لن نتخلّص من صلافة اللفظ وشحنته السلبية. وعليه، يتبنى حداد لفظ الرموز الخاصة بطائفة (Sect-specific)، حيث يمنح هذا اللفظ مساحة من الموضوعية لمستخدمه. كذلك، مع مفردة الحزب الطائفي أو فلان الطائفي، التي تسبب خلطاً بين «نعومة» و«خشونة» طائفية هذا الحزب أو الفرد، إذا ما استعرنا من الإبراهيم والصادق، ولذلك يكون لفظ حزب متمركز حول طائفة (Sect-centric party) أكثر عملية. وحين الحديث عن عنف أو صراع طائفي، يكون وسمها المقترح بصراعات وعنف مرمّز طائفياً (Sect-coded)، حتى يتسنى لنا إدراك الأبعاد الأخرى لهذه الحرب والصراع.
يقسّم الكتاب الأبعاد الرئيسية والمتداخلة لفهم الهوية الطائفية إلى أربعة أبعاد، خصص لشرح ثلاث منها فصلاً واحداً، وهي: الأبعاد العقدية، وما دون الوطنية، والعابرة للحدود، بينما خصص فصلاً مخصصاً للبعد الوطني، بحث العلاقة بين الهوية الطائفية والدولة العربية الحديثة، ولعل هذا البحث من بين أهم الإضافات المعرفية التي يوفرها الكتاب.
البعد العقدي
(Doctrinal Dimension)
على خلاف الشائع عن تضخيم دور ومركزية البعد العقدي والمذهبي في الديناميكيات الطائفية اليوم، أي تصوّر أن الصراع الطائفي اليوم والحروب المرمّزة طائفياً تُعزى لاختلافات عقدية وتفسير للنصوص والأحداث التاريخية الإسلامية بشكل لا يمكن التوفيق بينها، فإن أثر هذا البعد على الشرخ الطائفي العربي أقل بكثير. بكلمات أخرى، أنه ومن الخاطئ تصوّر أن هذا الصراع المحتدم هو حول ماهية الإسلام «الحقيقي» أو «الأصيل» - يجادل حداد بشكل مثير أن أثر التنافس حول الحقائق الوطنية أكبر من الصراع حول الحقائق الدينية وهو ما سيشرحه في البعد الرابع.
يستدل حداد على ذلك بفشل جميع حوارات وندوات التقارب والتعايش الطائفي في تخفيف وطأة الصراع العربي-العربي. فحتى لو افترضنا وصول جميع الطوائف الإسلامية إلى صيغة توافقية لقراءة النص التاريخي والمفاهيم العقدية، فهذا لن يغيّر من آلية الصراع العربي. فليس للبعد العقدي دور حاكم في اشتعال هذا الصراع، بل وفي واقع الأمر، لا وجود لبعد أو عامل واحد حاكم، بل هي مصفوفة معقدة من الأبعاد والعوامل يختلف وزن وثقل أثر كل منها وفقاً لسياقه الخاص.
ليس للبعد العقدي دور حاكم في اشتعال هذا الصراع، بل وفي واقع الأمر، لا وجود لبعد أو عامل واحد حاكم، بل هي مصفوفة معقدة من الأبعاد والعوامل
انطلاقاً من ذلك، لا ينفي حداد أثر المفاهيم والاختلافات العقدية على الهوية والعلاقات الطائفية. فمثلاً، يضفي الجانب العقدي تبريراً للعنف الطائفي الذي تمارسه الجماعات والميليشيات المسلحة على طول الطيف. يضاف إلى ذلك الإحساس باليقين والامتداد التاريخي الذي ترسخه هذه المفاهيم العقدية لشرعنة وجود هذه الجماعات وتماسكها، فالتاريخ الإسلامي يزود المنافسة الطائفية اليوم بالدعائم الخطابية والرمزية وكذلك أدواتها التعبوية، لكنه ليس بحال من الأحوال منطلقاً لفهم أسباب ديناميكيات العلاقة بين الشيعة والسنة وتفسيراتها.
يضاف إلى ذلك، يشكل هذا البعد أثراً على الصراعات، فمثلاً إذا ما أردنا تحليل فتوى الشيخ ابن تيمية في تكفير العلويين عام 1317، فبإمكاننا القول إن سبب ذلك يعود إلى تمرّد الساحل السوري على الدولة المملوكية، ولكننا أيضاً وفي حالة الشيخ ابن تيمية لا يمكننا نفي بعد الضغينة والكره العقدي. وفي السياق المعاصر، وفي أمثلة سوريا والعراق، العامل العقدي يلعب دوراً هامشياً في ديناميكية العلاقات الطائفية مع السلطة، فكما يبين حداد هذه الدول تتبنى خطاب الاحتفال بالتنوع والتعايش، بينما في حالة دولة مثل السعودية، ينقل الكتاب عن الباحث توبي ماثيسين، مسألة الإيمان العقدي الشيعي على سبيل المثال تؤثر في المجال السياسي لتتعدى مجرد حسابات الأمن والاقتصاد. فالهوية الوطنية السعودية قائمة على خطاب الإقصاء والحصرية العقدية الوهابية (ملاحظة: يتغير الوضع في السعودية اليوم، نحو محاولة الاحتفاء بالتنوع بشكل شبيه بالجمهوريات العربية، مع إخفاء لرواسب البعد العقدي التي تظهر إلى السطح من حين إلى آخر).
يصوّب حداد على أحد المفاعيل الأخرى للبعد العقدي، حيث يشير إلى علاقة بين مدى جهل المجتمع بالتفاصيل الدقيقة للاختلافات العقدية وبين استدامة التعايش السلمي. بيد أن الكتاب لم يفصّل كثيراً في المسألة، على عكس دراسة جورج قرم المطولة للعلاقات الطائفية («تعدد الأديان وأنظمة الحكم، دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة» - دار الفارابي) التي أولت هذا الجانب أهمية أكبر، حيث يربط قرم بين مستوى ممارسة الطقوس الخاصة لكل طائفة مع الشرخ الهوياتي وتعايشها مع الآخر.
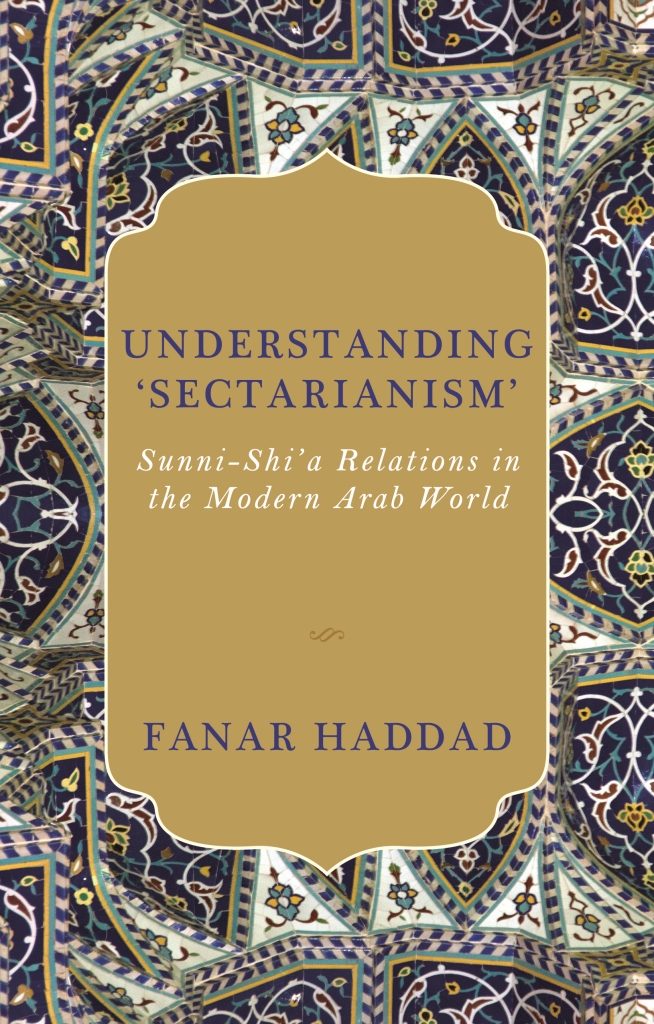
البعد ما دون الوطني
(Subnational Dimension)
يكتسي هذا البعد أهمية خاصة، حيث يسلّط الضوء على أهم الديناميكيات الطائفية التي تمس حياوات الناس ومعيشتها بشكل مباشر، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد السياسي. ويُعنى هذا البعد بالجوانب المحلية للهويات الطائفية وتقاطعها مع الموقع الطبقي والمناطقي والوشائجي والعشائري، وانعكاس ذلك على رسم التشكيل الطبقي للمجتمع وعلاقات القوة بين أطرافه. وعليه، يؤثّر هذا البعد في بقية الأبعاد، حيث أن الربط الطبقي-الطائفي يحفّز التقوقع على الطائفة، وعليه الدفع نحو تشرّب أدبياتها العقدية. وكذلك فإن مغالطة الخلط بين الطبقي والطائفي، تحفّز شعوراً بحصرية التهميش والمظلومية، وهو ما بدوره يكون بذرة لصراع يستميل التضامن والدعم العابر للحدود.
تعدّ أعمال حنا بطاطو حول سوريا والعراق جزءاً مهماً من البحث بين تأثيرات الهوية الطائفية والسلطة والانقسام الاقتصادي-السياسي. وفي حالات سوريا والعراق يبيّن حداد أهمية فهم تركيبة شبكة مصالح السلطتين بعيداً من أنها تنحاز لمكون طائفي واحد (العلويين في سوريا والسنة في العراق) بل إن واقع الأمر هو انحياز مناطقي وعشائري من داخل كل مكون. وبناء على ذلك، يبرز حداد أهمية عدم ربط هوية طائفية مع طبقة محددة، حيث أن سمة ضغائن الطبقة-الطائفة تتمظهر على طول الوطن العربي، وهو ربط يعمل على تمتين الحواجز الطائفية، وهو ما يحول دون تكوين وعي طبقي.
يرفد الكتاب العديد من الأمثلة، منها الشيعة في البحرين وربطهم بالتخلف وعدم النظافة في مقابل البحريني السني المدني والمتحضر، كذلك الدلالات الطبقية والمكانة الاجتماعية للهوية العلوية. بطبيعة الحال، لا ينفي ذلك أهمية البعد الطبقي، بل المسألة تأكيد على بديهية، أن الصراع ليس هوياتياً وليس كل منتم لهوية طائفية يتنعم بمستوى طبقي محدد، وإن كان هذا لا ينفي أثر الهوية الطائفية على التشكيل الطبقي، فالصراع العربي-العربي ليس مجرد صراعٍ طبقي متقمّص قناع الهويات الطائفية، بل إن الهوية الطائفية تؤثّر على البعد الطبقي والعكس صحيح.
يضيف حداد، أن هذا البعد يمكّننا من فهم الصراعات داخل المكون الطائفي الواحد، وذلك عبر تسليط الضوء على العوامل المناطقية والقبلية والطبقية. ففي مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي لبغداد، ومهما بلغ المدى الذي وصلت إليه الهيمنة السياسية الشيعية، فهذا لم يقف ضد صراع وتناقض شيعي-شيعي يصل اليوم إلى أقصى مدياته. ولعل التسريبات الأخيرة المسجلة لكلام نوري المالكي تعكس جوانب متعددة، فهو يتحدث عن الحفاظ على «التشيع» وفي «العراق»، وحين وصل الحديث إلى مسألة الأمان الشخصي استنفر العشيرة حيث أنه سيحتمي بمسلحين من بني مالك. جانب الولاء العشائري هذا، كان قد حرص المالكي إبّان حكمه على تمتينه عبر بناء شبكة مصالح ذات طابع عشائري من داخل المكون الهوياتي الطائفي. هذه الخصومات البينية الطائفية طالما تتكرر ولأسباب مناطقية كالتنافس تاريخياً بين كربلاء والنجف، وتكريت وسامراء، أو الصدريين وخصومهم، حيث يبرز هنا أيضاً العامل العابر للحدود وهو العلاقة مع إيران.
أخيراً يبرز هذا البعد، أحد الظواهر المهمة، وهي العلمانية الطائفية. بمعنى، أن أحد أبرز دلالات مغالطة تناقض العلمانية مع الطائفية، هي أنه وضمن تعقيد مشهد الشرخ الطبقي-الهوياتي والتنافس على المصالح الاقتصادية والمادية، لا تتكون الضغائن الطائفية على أسس عقدية، بقدر ما تكون ذات منابت طبقية وسواها. لذلك يأتي الاستقطاب والتنابز الطائفي كوسم شيعة لبنان «المتاولة» أو وسم اللاجئين السوريين أو أهالي طرابلس أو سنة العراق بـ«الدواعش» من قبل المتدينين وغير المتدينين «العلمانيين» في ممارساتهم اليومية.
الجانب العابر للحدود
(Transnational Dimension)
يبحث هذا الجانب تقاطع التقسيمات الهوياتية مع التجاذبات والعلاقات الدولية، بالإضافة للتضامن الطائفي العابر للحدود. ويحيل الكاتب التنافس الشيعي-السني في الوطن العربي للتنافس العربي-الإيراني، وهو تنافس لم يبدأ من الثورة الإسلامية في إيران، حيث ينقل حداد أن جذر الشرخ المغلوط بين «التسنن العربي» و«التشيع الإيراني» للصراع التاريخي على طول الحدود الفارسية-العثمانية، مشيراً إلى أن هذا الجذر أضاف تعقيداً آخر يخلط بين الانقسام السياسي والإثني.
أمّا اليوم، ووفقاً للكاتب، فالمحرك الأساس للبعد العابر للحدود للهوية الطائفية هو الصراع الإيراني-السعودي، والذي استعر ما بعد 2003 ثم اشتعل أكثر مع الاضطرابات التي أسس لها عام 2011. فمنذ حينها، تداخلت الأبعاد الأربعة للهوية الطائفية، ليسفر ذلك عن دوامة مدمرة شهدتها المنطقة في السنين العشر الأخيرة. حيث اكتسى الصراع الجيوسياسي ترميزاً طائفياً، ويعود ذلك لكل من الخطاب السعودي الخشن المعادي للشيعة، ولعب إيران لدور الراعي للتشيع دولياً بصيغته الإسلامية الشيعية الثورية. وهو ما ألقى بظلاله على البعد العقدي حيث التنافس على الشرعية الدينية (علينا النظر إلى فتوى الإمام الخميني ضد سلمان رشدي كشكل من أشكال هذا التنافس، حيث كان هدفها استعراض أن الصيغة الإيرانية للإسلام هي الأكثر ثورية في الدفاع عن النبي، أمام بقية التصريحات من علماء سعوديين وغيرهم ضد رشدي).
يكرر حداد هنا تنبيهه بأن المسألة ليست مجرد صراع دولي بلبوس ديني وهوياتي طائفي، بل علينا دائماً اعتبار الأبعاد الأخرى المحلية والعقدية والوطنية. فالبعد العابر للحدود يعمل على تعميق وتسعير الحروب المرمّزة طائفياً والشروخ الاجتماعية الموجودة في المقام الأول، مع التأكيد على أن خطوط التماس في هذا التنافس ليست طائفية حصراً.
إلا أن الجانب الأهم، في دراسة الكاتب لهذا البعد، تكمن في تسليط الضوء على سمة مميزة للسياسة العربية، وهي التداخل بين المجالات الداخلية (القُطرية إذا ما استعرنا من الأدبيات القومية) والخارجية. الفكرة هي أنه لا يمكن لأي دولة وطنية عربية وأي سلطة تحكمها أن تجعل العمل والخطاب السياسي حبيس هذه الحدود القُطرية، حيث أن هنالك ميلاناً ذاتياً للسياسة العربية نحو عبور الحدود، وهو بالأمر المفهوم كون أن هذه الحدود هي نتاج صيرورة تاريخية لعب فيها العامل الخارجي المتمثّل في الاستعمار دوراً رئيسياً. فالدول العربية ترتبط بمجتمع ما فوق-الدولة المكوّن لما يطلق عليه استشراقياً «العالم العربي».
الهوية الطائفية اليوم هي ليست بقايا تاريخية من عصر ما قبل الحداثة، بل وعبر تفاعلها مع طريقة نشأة الدولة العربية وبنيتها وهويتها، تداخلت هذه الهوية مع الهوية الوطنية
الفكرة، باختصار، وضمن جدليّة الوطني/ القومي عربياً، إن السياسة العربية محكومة بمجال عربي عام واحد، يتفاعل في ما بينه، وبشكل قاهر يجبر كل طبقة حاكمة عربية على عدم الرضوخ لحلم الانعزالية. فعليها ممارسة السياسة في ملعبها المؤثر وهو المجال العربي الكبير. وإن كانت القضية الفلسطينية، بالأمس واليوم، والخطاب القومي العربي بالأمس، بالإضافة مثلاً إلى خطاب قناة «الجزيرة»، دلائل على آلية اتخاذ الأنظمة للمسرح العربي العام كأداة لحشد الدعم، وتحييد المعارضة، والحفاظ على النظام، فعلينا النظر أيضاً إلى الخطاب الطائفي ضمن هذه الآلية. أي أنه، وبقدر ما يقوم به هذا الخطاب من شق للمجتمع العربي، فهو رغم ذلك مثال على الوحدة السياسية للعرب في مجال عام واحد.
وبالعربي البسيط، إن كل «كوكتيل» الهويات الطائفية هذا واستخدامه من قبل مختلف الطبقات الحاكمة، هو في جوهره الصراع ذاته إبّان مرحلة الخطاب القومي والناصري، أي محاولة فرض كل طرف الإجابة على سؤال: ماهية الدور السياسي العربي في المنطقة وفي العالم؟ وذلك بين المقاومة أو التحالف مع الاستعمار، وإن كانت فترة القرن الماضي أخذت عناوين هذا السؤال بشكل صريح، فإن استنفار الهويات الطائفية اليوم وفي أحد ركائز أبعاده هو استمرارية لهذا الصراع.
الجانب الوطني
(National Dimension)
أحد الاعتقادات السائدة الأخرى التي يجادلها الكاتب العراقي، تلك القائمة حول تصور يقضي بأن العلاقة الرابطة بين الهوية الطائفية والهوية الوطنية/ القومية علاقة تنافر وتنافي. مشيراً إلى أن خطأ هذا التصور، ينطلق من اتجاه فكري يصوّر كل ما هو حداثي، كالعلمانية، والقومية ترياقاً لكل ما هو غير حداثي، كالديانات أو الهويات الطائفية. إلا أن الكاتب العراقي ينبّه، وبحذاقة، إلى أن أحد أهم سمات الهوية الطائفية المعاصرة هو تفاعلها مع الدولة الحديثة والهوية الوطنية لهذه الدولة، وانعكاسها من خلالها. أي وبكلام آخر، فإن الهوية الطائفية اليوم هي ليست بقايا تاريخية من عصر ما قبل الحداثة، بل وعبر تفاعلها مع طريقة نشأة الدولة العربية وبنيتها وهويتها، تداخلت هذه الهوية مع الهوية الوطنية والقومية، وأفضت إلى شكل تاريخي حديث مغاير عن الماضي، حيث أمست الهوية الطائفية الحديثة مظهراً من مظاهر آلية عمل الهوية الوطنية والقومية.
بمعنى، أن الصراع المرمّز طائفياً في العراق وسوريا ولبنان والبحرين، هو صراع على حقائق وطنية، وسؤال ما هو الوطن ولمن؟ وماهية التصور المتخيل عن «السوري» و«العراقي» و«البحريني»، بل وحتى «العربي»، أكثر مما هو صراع حول حقائق صلب العقائد الدينية والمذهبية. وعليه، تعمل الهوية الطائفية من خلال التنافس الطائفي حول الموارد والحصص والسياسة، دور الهوية الوطنية، لا نقيضاً لها. بناء على ذلك، تتغير سردية أن انهيار الدولة العربية الوطنية أطلق العنان لانفجار مكونات مجتمعية أصغر بهويات طائفية، تتصارع عبر هوياتها ومن خلالها، إلى سردية قائمة على أن هذا الصراع هو تنافس حول ماهية الوطن وشكل الوطنية المتخيلة، سواء إبان الحرب أو السلم الأهليين.
وعليه، وكما يخبرنا حداد، إن الصراع في سوريا والعراق والبحرين (واليمن، فالباحث طالما أغفل اليمن رغم أنه يشكّل أحد أوضح الأمثلة)، لا يهدّد بقاء الدولة، فجميع الأطراف تريد الهيمنة الجغرافية والمركزية، فالدولة الوطنية العربية في نهاية المطاف هي الغنيمة التي يتم التنافس عليها. ولذلك، فإن الأطراف المتصارعة، تزحف إلى العاصمة أو تقوم بحمايتها، وتشكيلها ميزان قوة يميل إلى صالحها، وهذا ما يميّز الهوية الطائفية العربية والتيارات المتمركزة حول طائفتها عن الإثنية، فلن ترى الأكراد مثلاً يزحفون نحو السيطرة على بغداد أو دمشق، بينما العرب، ومهما كان الترميز الطائفي للجماعة التي ينتمون لها، يتصارعون حول كل الأرض، لأنها وبكل ما تحمل من تنوع هوياتي ينظر لها كأرض واحدة.
كأحد تمظهرات هذا الصراع حول ماهية «الوطن»، ففي مقال له بعنوان «في علمانيتنا الناقصة»، يبين الباحث العراقي حارث حسن باختصار أن عملية «تأميم الدين» في العراق، والتي اعتمدت «الإسلام السني»، لم تستطع احتواء المؤسسات الشيعية خارج الدولة، هذه المؤسسات وصيغة «الإسلامي الشيعي» أفرزت عبر حركة محمد باقر الصدر حزب الدعوة ومن ثم التيار الصدري. أمّا اليوم، وبعد الاحتلال، هيمنت هذه التيارات بدورها على مؤسسات الدولة، ومن ثم تناقضت في ما بينها على الدولة و على «التشيع في العراق» بتعبير المالكي.
الميزة هنا، يشير الكتاب، إلى أن الهيمنة على الدولة توفّر للفئة المسيطرة منبراً وشرعيةً وصدى شعبياً. وكما تتبّع الكاتب تطور العلاقات الطائفية العربية منذ زمن الدولة العثمانية وما قبلها، ومن ثم تطورها بعد دخول الاستعمار الغربي ونشأت الدولة الحديثة، فإن هذه الأخيرة، أمست مسرحاً للتنافس الطائفي وبأدوات حداثية وبغطاء مسمى الوطنية. فحتى خلال الصراع المعاصر، في كل دولة، كانت كل الطبقات السياسية تعمل على إدانة الطائفية، والتأكيد على الإيمان بالدولة والهوية الوطنية، والتنوع والتعايش، ولكن، مضمون الهوية الوطنية هذه في جوهره ينحاز لمركزية طائفية وقبلية محددة، وعلى من يشرط شروط التعايش والتنوع بالشكل الذي يفيده.
ممّا يمكن استخلاصه من هذا البعد، فكما يخضع نموذج العلمانية كعلاج للهويات الطائفية للمساءلة، فإن طرح الهوية الوطنية والقومية كترياق هو إشكالي ويحتاج إلى إعادة مقاربة، حيث أن للهويات الطائفية أثراً على ماهية الهوية الوطنية والعربية المتخيّلة. وعلى رغم من توفير العروبة وبشكل ذاتي أفضل الأدوات الثقافية لصياغة هوية عربية جامعة، فإن فحوى ومضامين ما تمثّله هذه الهوية في المخيال الجمعي للعرب يحتاج إلى طرح وعمل يتصدى لجميع الأبعاد المركبّة، المادية والهوياتية التي تؤثر في صياغتها.
خاتمة
تستعرض الفصول المتبقية للكتاب النزاع الطائفي في العراق بين موجة عام 2003 والتنافس الطائفي حينها وحتى عام 2018. وكذلك يتطرّق فصل منفصل وبشكل مثير ومهم لعدم تساوي كفة الانقسام الشيعي-السني ضمن تجاذبات الأقلية والأكثرية ضمن الحدود العربية. توفّر الأطروحة الرئيسية للكتاب أدوات مهمّة لكيفية فهم عمل الهوية الطائفية في الوطن العربي، وهو طرح مركّب يستدعي العمل على معالجات مركّبة لحلقة الدمار العربية منذ سقوط بغداد، منها البحث عن تطوير وإبداع لوقف ديمومة إعادة إنتاج الأزمات التي تواجه المجتمع العربي منذ نهاية الدولة العثمانية. مع الأخذ في الاعتبار عاملاً تطرّق له حداد لماماً وهو الدور الخارجي الغربي المعاصر. فلا يمكن الحديث عن محاولات انتشال للواقع العربي من دون استيعاب أن هنالك تنظيماً بشرياً على شكل دول في غرب أوروبا وأميركا تعمل على إعادة تشكيل المنطقة لضمان مصالحها الإمبريالية عبر منع التنمية التي من دونها تستحيل عملية إيقاف إعادة إنتاج الديناميكيات الطائفية لنفسها. فحين الحديث عن عام 2003 كحدث مفصلي في تاريخ العلاقات الطائفية عربياً فنحن لا نتحدث عن زلزال أو كارثة طبيعية، بل هجمة منظمة عملت على انفجار المشرق العربي. انفجار ليس نتاجاً لقصور استعماري في فهم «الطائفية» بل لأن هذه الفوضى هي بحد ذاتها آلية عمل الاستعمار. إنّ فهم عمل هذه الآلية وأثرها في كل الأبعاد المتعددة للهوية الطائفية هي بوصلة العمل على صياغة تاريخ عربي جديد.
* كاتب عربي



