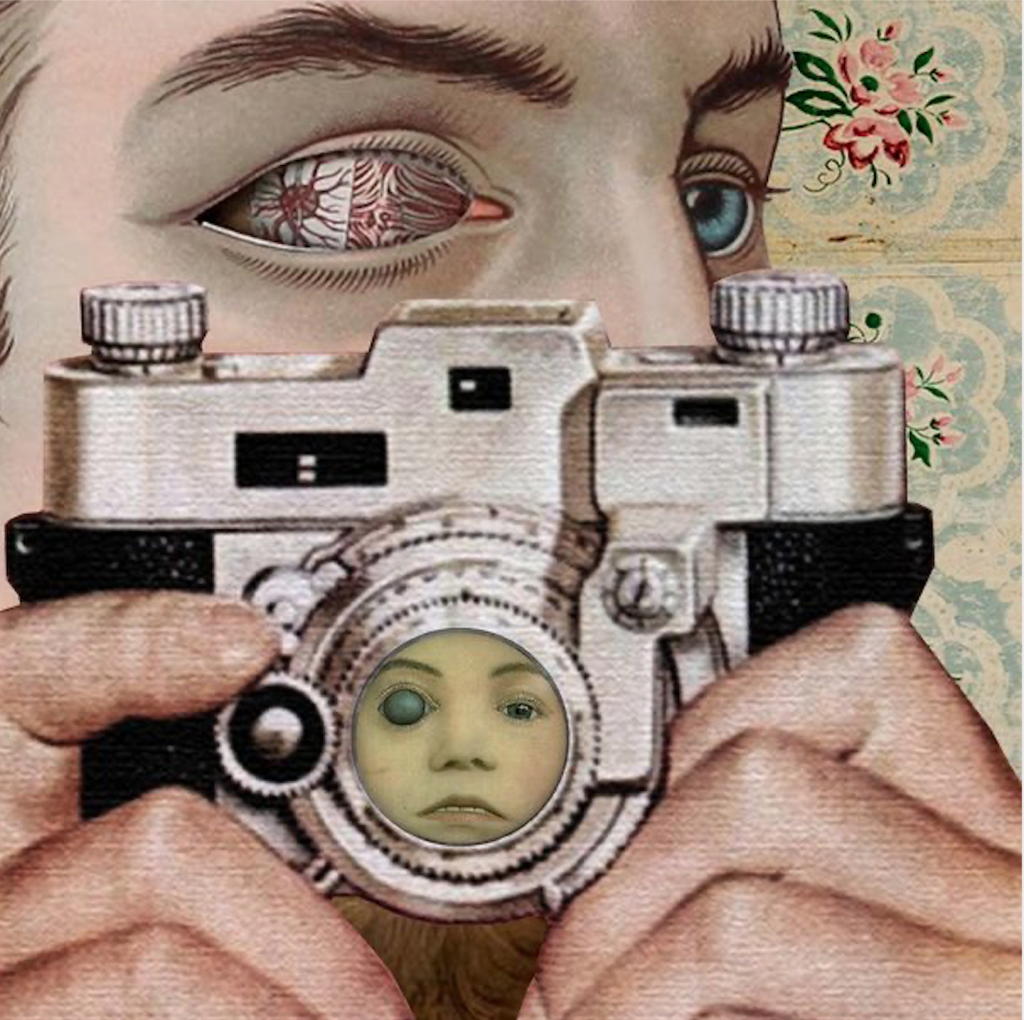
إن عدنا والتقينا بلينين اليوم، لأخبرناه أن ما حذّر منه منذ قرن ونيّف تمدّد وأصبح خطراً يلاحق الحركات التحررية في كل زاوية من العالم، بل إنّه – كما توقّع – طاوله شخصياً في الفترة التي لحقت وفاته لتصويره كنقيض لخلفه ستالين (وإن كانت هذه المحاولات محدودة التأثير نظراً إلى وضوح نهج لينين، على عكس آخرين). وربما أكثر من ينطبق عليه هذا الوصف – أو اللعنة – هو الثوريّ الأرجنتيني تشي غيفارا الذي ما إن اغتيل حتى أصبحت صوره ترافق أي تظاهرة، أملًا بمنحها طابعاً جذرياً، وتُسلَّع في ثياب الموضة والكحول والفنّ المعاصر. وإذا أردنا أن نعالج الموضوع على ضوء أحداث اليوم، لجأنا إلى إيضاح فكرة الغرق بالعسل، وما رافقها من تنامي ظاهرة «نشر الوعي» وانعكاس ذلك على مجتمعاتنا.
عن الغرق بالعسل
يروي الفيلسوف نيكوس كازنتزاكي في كتاب «رسالة إلى غريكو» كيف اتّضح له العديد من الأمور حين رأى نحلة غارقة في إناء من العسل. ويجوز القول إنّ الإعلام، وخصوصاً الإعلام الغربي (أي وسائل الإعلام الكبيرة التي تسيطر على المجال الافتراضي، وهي بأكثريتها الساحقة تابعة للقوى الغربية ومموّلة منها)، قد امتهن فنّ إغراق الحركات التحررية بالعسل إلى حدّ قتلها. لنشرح.
في أيام لينين، كانت وسائل الإعلام (ومن يرافقه من كتّاب ومؤثّرين) تعمل على تبجيل الشخصيات الثورية وتمجيدها، ولكن عبر التشويه وطمس أفكارها الثورية والإبقاء على جوانب معيّنة تجعلها تظهر بمظهر إصلاحيّ في الحدّ الأقصى. فهي كانت تُغرق محبّي هذه الشخصيات بالعسل عبر القول: «انظروا، نحن معكم، ندعمكم ونكتب عمن تحبّونهم في جرائدنا، ونجعل الرأي العام الغربي والعالمي يحبّكم!» ولكنها في الحقيقة كانت تروّض العقول عبر تشويه تاريخ هذه الشخصيات وسلخ سماتها الثورية الخطرة عنها: فجعلت من ماركس وطنياً ألمانياً، ومن «هو شي منه» قوميّاً يمينيّاً، ومن تشي غيفارا فوضوياً متمرّداً، لتكون بذلك قد قتلتهم وقتلت محاولات البناء على إرث هذه الشخصيات الحقيقي، الأمر الذي من شأنه أن يشكّل خطراً على المنظومة المهيمنة.
ولكن هذه الحالة تطورت. ففي القرن الماضي، كان كل ذلك يحدث بعد وفاة هذه الشخصيات، أو بعد إقصائها، ويتطلب سنوات من العمل والكتابة وتمويل المنظمات. لكنّ ذلك يحدث اليوم لحظة بلحظة، ويستطيع الإعلام إغراق النحلة فور ولادتها. وقد أظهرت وسائل الإعلام براعتها في ذلك عبر تغطيتها لتحركات السود في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي. فعندما نشبت أعمال الشغب عام 2014 في مدينة فيرغسون الأميركية ذات الأكثرية السوداء، وذلك على إثر اغتيال شاب أسود من قبل شرطيّ، تخبّطت وسائل الإعلام في الآونة الأولى بين داعم للتظاهرات العنيفة المعارضة للشرطة الأميركية ومعارض لها. ولكنها تداركت ذلك وأصبحت فجأة جميعاً داعمة لها. كيف؟ كانت تدعو «منظّمين» للحراك للظهور على شاشاتها والكلام عن مخاطر العنف وكيف يؤجّج الرأي العامّ ضد الحراك المحقّ، كما عملت بكثافة على إظهار دعم شكليّ لهذه التظاهرات، لتتنامى ما تُسمّى بظاهرة الناشط الاستعراضيّ (performative activism)، وتظهر شخصيات سوداء شهيرة لتدعم الحراك السلميّ. فتكون بذلك قد أغرقت الجماهير بالعسل عبر إيهامها بأن «صوتها وصل» وأنها استطاعت إحداث تغيير في الرأي العام، برغم أنها لم تحقق أية مكتسبات جدّيّة لأنه تمّ استبعاد الطريق الوحيد نحو ذلك: العنف المنظّم (وهو ليس عسلاً). أمّا في عهد ترامب، فقد استفاد الإعلام من ذلك عبر إدارة الدفّة من الشعارات الجذرية كحلّ الشرطة الأميركية أو إزالة سلاحها، إلى شعارات موجّهة ضد ترامب، حاصرةً بذلك المشكلة بشخص ترامب ومبعدة الأنظار عن أن المشكلة في بنية النظام الأميركي العنصرية. وهنا أيضاً أتقنت وسائل الإعلام لعبة ترويض هذه التحركات حتى أصبح العنف مقبولاً ومستحبّاً طالما أنه لا يهدّد مصالح المنظومة.
عن نشر التوعية
إذا عدنا بالتاريخ، نرى أن مفهوم نشر التوعية لم يظهر في الحالة السياسية إلا حديثاً. فكان هذا المفهوم مقتصراً على مسائل اجتماعية أو صحيّة، مثل مواجهة وصم متلازمة السيدا أو حثّ الناس على تلقّي لقاح. ولكن في الميدان السياسي، كان كل نشر للتوعية مقترناً بعمل: فحين كانت مجموعات يسارية تحذّر الناس من مخاطر النازية، كان ذلك مقروناً بدعوة إلى دراسة الموضوع عن كثب، أو حضور ندوات، أو حتى الانتظام في مجموعات طالبية أو محلية هدفها مواجهة نشر الأفكار النازية. وحين كان أهالي بيروت وطرابلس يقرأون ويسمعون عمّا يحدث في الجنوب في التسعينيات، غالباً ما كان ذلك مقروناً بدعوة للانتظام في صفوف المقاومة، أو المساهمة في إغاثة المصابين والأيتام والنازحين بشتى الطرق.
إذًا فالتوعية كانت دائماً الخطوة الأولى في مساندة أي قضية نحو مخرجَيها: إمّا أن تتعمّق فيها وتساهم في تحليلها ودراستها وترسيخ بعدها النظريّ، والاستعداد عبر ذلك للتضحية بوقتك وفرص عملك دعماً لهذه القضية؛ إمّا العمل لمساندة هذه القضية عبر الانتظام في الأحزاب المهتمّة أو التطوّع – وحتى السفر – للمشاركة في العمل العسكري، وهذا ما يرتّب عليك مخاطر أكبر على الصعيد الشخصيّ.
لكنّ الخطر برز حين تمّ الفصل بين نشر التوعية ومخرجيها (ويمكن العودة بذلك بشكل ملحوظ إلى بداية ما يسمّى بالربيع العربيّ، الذي ترافق مع انفجار وسائل التواصل الاجتماعي). فأنت، عندما قمت بهذا الفصل، قد أوهمت الآلاف بأنهم، إذا غنّوا لفلسطين، أو وزّعوا بعض المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي مع شعار «أنقذوا اليمن»، فقد برّأوا ذمّتهم تجاه القضية، لا بل أصبح لهم فضل على الذين يساندونهم، وأن مشاركتهم هذه توازي بأهميتها العمل العسكري. وتراءى للبعض حتّى – وهذه الحالة التي نشهدها في فلسطين، ورأينا مثيلتها في التسعينيات في جنوب لبنان المحتلّ – أن هذه الوسيلة هي الـصائبة، وهي بديل ناجح عن العمل العسكري العنيف وعن النظريات الثورية المضجرة.
على من يخدم المقاومة أن يستعدّ للتضحية من أجلها، سواء بوقته أو ماله أو عمله، وألا يشارك في أذيّتها، وأن يتوقّع شتّى العقوبات عند احتدام الصراع
للحقيقة، إذا وضعنا أنفسنا في عقل هذا الشابّ الذي يمتلك الوقت والكفاءة والأدوات ويتقن اللغة الرائجة لـ»نشر التوعية» عبر هاتفه، فالمعادلة رائعة: أوّلاً، تعطيه رصيداً اجتماعياً هائلاً، ويصفّق له جمهوره من المتابعين، ويصبح هو المثقّف والمناضل في دوائره الاجتماعية. ثانياً، هي لا تهدّد مصالحه الشخصية ولا امتيازاته الطبقية، ونادراً جدًّا ما هو مستعد للتضحية بهذه المصالح دفاعاً عن مواقفه، (بالمناسبة، يوجد لدينا مثال: الممثل الأميركي «مارك رفالو» وعارضة الأزياء الفلسطينية الأصل «بيلا حديد»، أصبحا عزيزين على قلوب بعض الشباب العربيّ بسبب تغريدات متفرّقة دعماً لفلسطين، ولكنهما تراجعا بسرعة قياسية عن هذه المواقف خلال الجولة الأخيرة وأصبحا من دعاة السلام وعدم الانحياز، تحت ضغط خسارة عقود أعمالهما). ومن ناحية ثالثة، تُمكّنه من تمييز نفسه عن الفقراء الذين يقاتلون: فهو أيضاً يقاتل، لكن بطريقة راقية، ولا يحتاج إلى توسيخ يديه، أو حتى أن يجرح إصبعه بزناد البندقية، أو أن يضحّي بوقته وملذّاته دعماً لهذه القضية. فهذه الأمور «للفقراء» وليست «للمتعلّمين»، كما أنه ليس مضطرّاً حتّى إلى الاحتكاك بهم عبر المشاركة مثلاً في تنظيم ندوات تثقيفية، فهو «متعلّم»، وهم سيبقون «غير متعلّمين». الأجدى أن يموتوا، لا أن يقرأوا أو يناقشوا.
أمّا بالنسبة إلى جعل نشر التوعية موضة آنية (فترى خلال أسبوع هبّة شبابية دعماً لفلسطين على وسائل التواصل، ثم ينصرفون إلى حياتهم العادية)، فهذا أمر سهل التصرف به من قبل مجموعة صغيرة من خبراء الخوارزميات ومموّليهم. وقد أثبتت الوثائق كيف أنه تمّ خلق فقاعات نشر التوعية لتبرير حرب ليبيا، خصوصاً عبر حسابات وهمية، وكيف أنّ الكثير من المعلومات في هذه العمليّات خاطئة ومستقاة من المصدر ذاته (مثل قضية الإيغور التي يشكّل مصدرها الوحيد اليميني المتطرّف «أدريان زنز»).
فلسطين في الإعلام
حين رأيت وسائل إعلام غربية تتكلّم عن قضية الشيخ جرّاح، ورأيت دعماً دولياً من المؤثّرين في العالم الافتراضي، بدا لي الموضوع مرعباً. هذه الوسائل الإعلامية مموّلة من اللوبيات الإسرائيلية، وسبق وحرّضت الرأي العامّ على دعم الحرب على سوريا والعراق وليبيا. وهؤلاء المؤثّرون نشروا «توعية» حول «مجازر الإيغور» و»هجمات الأسد الكيميائية» (وأجزم أنهم كانوا لينشروا شهادة نيّرة الصباح الكاذبة ألف مرة لو تسنى لهم ذلك). فكيف لي أن أثق أو أفرح بذكرهم لقضية الشيخ جراح؟ التفسير هنا هو الآتي: اللعبة لعبة شطرنج. ترويضاً لجزء كبير من الفلسطينيين، وخصوصاً من فئة الشباب، قام الغرب بدعم تعليمهم وإرسالهم إلى دول الغرب، أملًا بإشراكهم في عمليّات استسلام مثل أوسلو وصفقة القرن (وهذا نجح إلى حدّ كبير). لكنّ هؤلاء الشبّان اكتسبوا أيضاً الخبرة واللغة والأدوات اللازمة لإيصال آرائهم إلى شريحة كبيرة من الشباب الغربي عبر نشر التوعية. لقد تقدّموا خطوة، فكيف تصدّها؟
لمن يعرف الشطرنج، فإنه عند كل احتدام خلال المباراة، يمكنك أن تضحّي بعدة أحجار وتمنح عدوّك فرصة للتقدّم: إنك تقدّم له العسل. وعدوّك، موهوماً بالفرصة التي يعتقد أنه اغتنمها، سيتقدم غير آبه بما تحيكه، إلى أن تردّ عليه بضربة محكمة وتصرخ منتصراً «كش ملك». والإعلام الغربي، عبر استدراج قضية الشيخ جرّاح إلى منابره، يسعى إلى قتلها: فهو استطاع عزلها عن القضية الفلسطينية ككلّ، وركّز على أن المشكلة هي مشكلة «عنصرية»، أي مجرّد مشكلة «آبارتهايد» (وبالمناسبة، هذه العبارة التي تعني الفصل العنصري، أصبح مجرّد استخدامها مشبوهاً، فالمشكلة ليست أبداً مشكلة «فصل»). لا يُمسّ بأحقية وجود الصهاينة في القدس وفلسطين، ولا نأتي على ذكر عمليات الطعن والدهس التي يقوم بها بعض «الفقراء البربريين». نلغي المشكلة الوجودية، ونحوّلها إلى مشكلة سلوكيّة بحتة لدى الإسرائيليين. تتمّ مهاجمتهم فقط في حدود حيّ الشيخ جرّاح، وتظهر المشكلة وكأنها مرتبطة بالحكومة الحالية أو بالسياسة الإسرائيلية الحاليّة، أي أنّها تُحلّ ببساطة عبر التخلّص من العنصرية أو من الأفراد العنصريين. في نهاية الأمر، من الأفضل أن تجعل الناس يؤمنون بأن المشكلة محصورة بتصرف الشرطة الإسرائيلية وبعض العصابات الصهيونية، كما فعلت في حراك السود، على أن تترك وسائل التواصل الاجتماعي تتفاعل بحرية وتخاطر بأن يتمّ تناقل أفكار جذرية تشكّل خطراً على الكيان.
كذلك، سيعتقد من دأب على «نشر التوعية» حيال قضية الشيخ جرّاح أنه انتصر بفضل نشره التوعية، وذلك لأن قضيته وصلت إلى مسامع الشباب في الغرب. هو لن يعلم، بل سينكر، أن ذلك فخّ، وأن الحديث عن الشيخ جرّاح بشكل منفصل عن القضية الفلسطينية يهدف إلى فصل التظاهرات الداعمة لأهل الشيخ جراح عن صواريخ المقاومة في معركة «سيف القدس»، وأن المعيار هنا، هو أن تسأل هؤلاء الذين اهتمّوا فجأة بفلسطين «ما رأيكم بحماس؟ ما رأيكم بإزالة الكيان؟»، حتّى تراهم يتهاوون. ولكن هذا لا يهمّ، فهو يعتقد أن دعم الأكاديميين الغربيين يعطيه أهلية للكلام في الاستراتيجيات، ويستطيع الإعلان بكلّ ثقة أن وقف إطلاق النار كان قراراً سيّئاً، أو أنه يجب إعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية لفصائل المقاومة.
ملاحظة في عقد الدونيّة
تعقيباً على المقطع السابق، إن التعلق بآراء المفكّرين والمؤثّرين الأوروبيين ظاهرة غريبة للغاية في عالمنا العربيّ. نحن ننتظر الغربي (أو المتعلّم في الغرب) لأن يوصّف حالة مجتمعنا، وأن يعطينا رأيه بالأحداث. وإن وقف في صفّنا نهنّئ أنفسنا، وإذا عارضَنا نهرع لمراجعة أنفسنا والوصول إلى حلول وسطى معه. لماذا ذلك؟ والمثير للنفور أن ذلك ليس محصوراً باليوم: ففي ستينيات القرن الماضي ظلّ المفكرون العرب، خصوصاً اليساريين منهم، ينتظرون رأي جان بول سارتر بشأن القضية الفلسطينية، فهو كان يقدّم لهم دائماً أنصاف آراء، ويتكلّم بالعموميات ويرفض الدخول في أي كلام جذري ضدّ الصهيونية. لكنه، برغم رماديته الساطعة، ظلّ رمزاً ثقافياً للعرب إلى أن وقعت حرب الـ 67 التي قام خلالها سارتر وزوجته بتوقيع عريضة دفاعاً عن الكيان الإسرائيليّ، فترافقت النكسة السياسية بنكبة أكاديمية: لقد أضاع المثقفون العرب حبيب القلوب... السؤال هو: لماذا نصرّ على الأخذ بآراء كاتب أميركي من هنا وفيلسوف فرنسي من هناك؟ ألا نملك عزّة نفس كافية كي نفرض آراءنا وندير الأذن الطرشاء للّذين سيبقى سقف مساندتهم لقضيتنا بعض الرسائل المفتوحة والوقفات التضامنية في المقاهي؟ هؤلاء لن يفعلوا شيئاً يهدّد امتيازاتهم الطبقية وموقعهم الاجتماعي. إن فكّروا في أن يساندونا أو أن يتضامنوا معنا، فهذا جيّد وقد يرفع المعنويات لبضع دقائق، خصوصاً أنه من المفرح أن نرى الناس يتناقلون صور الدمار والقتل ويتعرّفون إلى عمق الإجرام الاسرائيليّ ويتبرّعون لإغاثة المصابين. ولكن أن نعمل جاهدين على إقناعهم بذلك، وأن نلوم أنفسنا إن لم يفعلوا، فهذا تخاذل تامّ. والتعامل معهم يجب ألّا يتمّ سوى على قاعدة «ستّين سنة ما يتضامنوا».
خلاصة
الأمر الأساسي الذي يجب أن نعلمه، هو أنه لا يوجد شيء اسمه مقاومة افتراضية، ولا ضغط دوليّ عبر وسائل التواصل، ولا عبر رفع الأعلام الفلسطينية في ساحات العواصم الأوروبية (بالمناسبة، ألم تلاحظوا الاهتمام المتزايد بالمسيرات الداعمة لفلسطين في أوروبا برغم أن عدداً كبيراً من الدول العربية والجنوبية شهد مسيرات كبرى؟)، فهذه الظواهر الآنية مسارها ليس التثقيف العميق ولا دفع الناس إلى الانخراط في العمل المقاوم، بل تعبئة الرصيد الاجتماعي للمشاركين فيها كحدّ أقصى.
وأمر آخر هو أنه ليس هناك من ركود في الخطاب والمواقف: فالخطاب الذي كان سائداً ومقاوماً في الماضي قد يصبح مشبوهاً اليوم. سردية «الفلسطينيون ضحية» وكاريكاتيرات كارلوس لطوف التي تقارن بين عدد الصواريخ الإسرائيلية وتلك الفلسطينية، كانت سردية ناجحة منذ 10 سنوات، وتُظهر بحقّ مدى الإجرام الإسرائيليّ. لكن استخدامها اليوم ليس في مكانه. اليوم لديك مستجدّ: المقاومة أصبحت قويّة ولديها قدرات صاروخية متطورة، وتستطيع ضرب المستوطنات وقتل من في منازلها. وعليه، فإن الخطاب المقاوم اليوم هو خطاب يحمل المزيد من القوة والتحدّي. لذا فالإصرار على البقاء في خطاب الانكسار قد لا يكون سوى مدخل للمطالبة بالتسوية والسلام، وليس لحثّ الناس على التمسك بالمقاومة. والدليل أن الإعلام الغربي قد ركب موجة هذا الخطاب الداعي للشفقة على الفلسطينيين، لأنه خطاب ناجح وأصبح من السهل استخدامه كفخّ عسل.
ويبقى السؤال: ماذا أفعل حيال ذلك؟ طبعاً، لا يُفرض على أحد المشاركة في العمل العسكري، خصوصاً أنه يحتاج إلى رصانة وصلابة قد لا تتلاءمان مع طباع الكثيرين. لكن على هؤلاء الذين لا يريدون الانخراط في العمل العسكري أن يعلموا أمرين: أولاً، إن أرادوا أن يخدموا بحق وجدارة عمل المقاومة، فعليهم أن يستعدّوا للتضحية من أجلها، سواء بوقتهم أو مالهم أو عملهم (وأي عمل أو اختصاص يخدم المقاومة)، وألا يشاركوا بعملهم اليوميّ في أذيّتها، وأن يتوقّعوا شتّى العقوبات عند احتدام الصراع. الأمر الثاني هو أنه، إن لم يستطيعوا القيام بذلك أيضاً، عليهم أن يعوا أن ذلك ليس عيباً، فالحاجة إلى المال قد لا تسمح بذلك، ولكن عليهم أن يتقبّلوا كذلك أنه مهما نشروا شعارات وشاركوا في وقفات تضامنية، فسيبقى للمقاومة والمقاومين فضل عظيم عليهم، وأن من سقى الأرض بدمه له الحقّ الكامل بأن يطلب تقرير المصير. وإن أنكرنا عليه هذا الحقّ فنحن نتعامل مع المقاوم كأنه مرتزق، يموت نيابة عنّا ثم نقوم نحن بتقرير مصيره.
*جامعي لبناني


