جرى الإعلان في تغطية إعلامية مباشرة ومترافقة مع أجواء احتفالية، عن نجاح الإمارات العربية المتحدة في دخول نادي الدول الغازية للفضاء، وبالتحديد إلى المريخ، وذلك مع وصول مسبار الفضاء المسمّى إماراتياً «مسبار الأمل» إلى مداره حول الكوكب، في مهمّة أُعلن أنّها الخطوة الأولى في برنامج المئة عام لاستيطان الكوكب المذكور، والذي يبعد 55 مليون كيلومتر في أقصر مسافة له عن الأرض. ويترافق وصول هذا المسبار مع مسبارين آخرين ضمن برامج الفضاء الأميركية والصينية، في حين أنّ الهدف هو المزيد من التعرّف إلى المريخ. لقد أثار الخبر عن «وصول الإمارات إلى المريخ» ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مهلّلين لهذا الإنجاز وآخرين مشكّكين فيه، حيث جرى تقييمه من قبل البعض عبر ربطه بمشاركة الإمارات في العدوان على اليمن، وتوقيع سلسلة اتفاقيات مع الكيان الصهيوني، في ما يتعدّى التطبيع الشكلي، وهكذا امتزج السياسي بالعلمي.
صحيح أنّ من الخطأ فصل العلم عن وظيفته الاجتماعية، إلّا أنّ من الضروري أولاً الولوج إلى المسألة من بوابة المعايير العلمية. وهنا سنستعين بالصفحة الرسمية لوكالة الإمارات للفضاء، حيث ورد أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة دخلت «بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر مرسوم الشيخ خليفة بن زايد بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اسم مسبار الأمل، لتكون الإمارات واحدة من بين تسع دول فقط تطمح إلى استكشاف هذا الكوكب. وانطلق المسبار في مهمّته بتاريخ 20 تموز / يوليو 2020، ومن المخطّط أن يصل إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجري التخطيط والإدارة والتنفيذ لمشروع المسبار على أيدي فريق إماراتي يعتمد أفراده على مهاراتهم واجتهادهم لاكتساب جميع المعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف الفضاء وتطبيقها، إذ تُشرف وكالة الإمارات للفضاء على المشروع وتموّله بالكامل، في حين يطوّر مركز محمد بن راشد للفضاء المسبار بالتعاون مع شركاء دوليين. وتتجلّى أهداف المهمّة في بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، والارتقاء بمكانة الإمارات في سباق الفضاء لتوسيع نطاق الفوائد، وتعزيز جهود الإمارات في مجال الاكتشافات العلمية، وإقامة شراكات دولية في قطاع الفضاء لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة». واتّضح بحسب وسائل الإعلام أنّ 200 مهندس إماراتي يشاركون في المشروع إلى جانب 200 مهندس أميركي من المختصّين والباحثين في علوم الفضاء.
إنّ التعاون بين البدان والجامعات ومراكز الأبحاث في العالم هو من سمة البحث العلمي وتبادل الخبرات، وهذا أمر ليس طبيعياً فقط، بل ومطلوب بما يعزّز التفاعل المتبادل بين المدارس العلمية المختلفة، وخصوصاً في مجالات مثل الفضاء، حيث تتضافر الجهود لسبر أغوار ذلك العالم الغامض والمدهش واللامتناهي الذي لطالما حلم البشر ببلوغه وكشف أسراره.
بعد عقدين من افتتاح عصر الفضاء تبلورت ثلاثة اتجاهات في علم الفضاء:
القسم الأول مرتبط بدراسة الفضاء ذاته، ويتضمّن دراسة الفضاء المحيط بالأرض مباشرة، مثل دراسة الغلاف الجوي العلوي، والأحزمة الإشعاعية، والغلاف المغناطيسي، والوسط ما بين الكواكب، ويُطلق على هذا الاتجاه تصنيف الفضاء القريب. ومع توافر إمكان دراسة بعض أجسام المنظومة الشمسية، بشكل مباشر، من خلال دراسة محيطها، فإنّها شكلت موضوعاً قائماً بذاته، وتخطّت البعثات حدود دراسة القمر إلى كواكب المنظومة الشمسية من خلال المسابير. أما الفضاء «البعيد»، فإنّ دراسته لا تتمّ بشكل مباشر عبر المسابير، بل بواسطة المعدّات الفلكية المثبّتة على منصّات خارج الغلاف الجوي للأرض، وهذا صار يشكّل موضوعاً لعلم الفلك خارج الغلاف الجوي للأرض. أما القسم الثاني من الأبحاث الفضائية، فلا يشمل دراسة الفضاء بذاته، ولا العمليات الفيزيائية المرتبطة بالأجسام السماوية وبالأوساط بين النجمية، بل العمليات التي قد يقوم بها الإنسان في الفضاء، مثل عمليات اللحام في الفضاء، ونمو البلورات في ظروف انعدام الوزن، ودراسة سلوك المواد وعمل الأواني، إضافة إلى الأبحاث في مجال علم الأحياء الفضائي والطب. وهي بكلّيتها تتميّز بأهمية تطبيقية كبيرة. أما القسم الثالث والكبير في الأبحاث الفضائية، والذي يتميّز بأهمية تطبيقية وأساسية، فهو يتعلّق بدراسة الأرض من الفضاء، بما في ذلك دراسة المناخ والموارد الطبيعية.
وكمثال على مسارات البحث العلمي للعلوم الأساسية، يمكن إيراد المواضيع المحدّدة من قبل معهد الأبحاث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية للأعوام 2012 - 2020:
1 - المسائل المعاصرة لعلم الفلك وللفيزياء الفلكية ودراسة الفضاء الخارجي بما في ذلك تشكل الكون، وتركيبته وتطوّره، وطبيعة الكتلة السوداء والطاقة المظلمة، ودراسة القمر والكواكب، والشمس ومنظومة الشمس - الأرض، وتطوير طرائق وأجهزة علم الفلك خارج الغلاف الجوي للأرض.
2 - المسائل المعاصرة لفيزياء البلازما، بما في ذلك فيزياء البلازما الفلكية، وفيزياء البلازما المنخفضة الحرارة وأسُس استخدامها في العمليات التكنولوجية.
3 - أنماط تشكّل التركيبة المعدنية والكيميائية والنظائرية للأرض. الكيمياء الفضائية للكواكب ولأجسام المنظومة الشمسية. نشوء وتكوّن المحيط الحيوي للأرض. الدورات الكيميائية الإحيائية والدور الكيميائي الأرضي للكائنات.
4 - الأسس العلمية لصياغة طرق، تكنولوجيا، ووسائط دراسة سطح الأرض وجوفها، والغلاف الجوي للأرض بما في ذلك الغلاف المتأيّن والغلاف المغناطيسي، كذلك الغلاف المائي والجليدي. المحاكاة الرقمية والمعلوماتية الجغرافية بواسطة البنية الثلاثية الأبعاد.
5 - تغيّر البيئة والمناخ بتأثير العوامل الطبيعية والبشرية. الأسس العلمية للاستغلال العقلاني للطبيعة والتنمية المستدامة، وتنظيم إدارة استغلال الأراضي والمناطق.
6 - الميكانيكا العامة، أنظمة الملاحة، ديناميكا الأجسام الفضائية ووسائل النقل والمركبات المتحكّم فيها، وميكانيكا المنظومات الحية.
ومنذ إطلاق الاتحاد السوفياتي أوّل قمر صناعي حول الأرض، في عام 1957، فإنّ عدد البلدان التي انخرطت في سباق الفضاء بلغ حتى اليوم عشر دول، وهي الاتحاد السوفياتي/ روسيا، الولايات المتحدة الأميركية، الصين، دول الاتحاد الأوروبي، اليابان، الهند، إيران، الكوريتان، وإسرائيل. (وكانت أستراليا قد شاركت في برامج إطلاق صواريخ إلى الفضاء، من عام 1967 حتى عام 1971 عندما أوقفت برنامجها). وإذا وضعنا جانباً البرامج العسكرية لغزو الفضاء، فإنّ تعاوناً يجري بين مؤسّسات الفضاء المختلفة في ما يتعلّق بالبرامج السلمية. ويتّضح أنّ الدول المذكورة أعلاه تتميّز ببنية صناعية تقانية وعلمية صلبة توفّر الشروط المادية والبشرية الضرورية التي تحتاج إليها برامج غزو الفضاء؛ فتطوّر تقانة الصواريخ الفضائية والأبحاث لاستكشاف الفضاء هي من مؤشرات الثورة العلمية المعاصرة، وعلم الفضاء يتمظهر اليوم كتخليق (سنتيز) لما بلغته العلوم والتقانة المعاصرة. والأبحاث الفضائية ليست فقط مرحلة جديدة من تطوّر العلوم حول الفضاء، بل هي مرحلة جديدة في تطوّر العلوم عامّة، حيث تحقّقت إنجازات علمية مهمّة في الكثير من المجالات العلمية والتقانية. وخلال ستين عاماً من غزو الفضاء، وخصوصاً خلال عشرين عاماً من العمل الدولي المشترك في إجراء التجارب على المحطة الفضائية الدولية، كانت بشكل جدلي تتشابك المهام في المنظومة العلمية التقنية بحيث كان يتمّ توظيف النتائج الفضائية في التطبيقات على الأرض، وفي المقابل، فإنّ احتياجات البحث العلمي في الفضاء كانت تشكل الدافع لتطوير الأبحاث الأرضية بما يلبّي هذه الاحتياجات. إنّ تصميم وتصنيع منظومات الصواريخ الفضائية العاملة في الفضاء، والأقمار الصناعية للأرض، والمركبات الفضائية المأهولة والمحطّات الكواكبية غير المأهولة أعطت دفعاً كبيراً لتطوّر فروع علمية وتقانية عديدة لم تكن سابقاً مرتبطة بالفضاء. وبرامج غزو الفضاء تتكئ علمياً على تقاطعات مجالات عديدة في الفيزياء والهندسة، في ترابط متماسك بين النظرية والتطبيق. ولو أخذنا على سبيل المثال المسبار الفضائي، فهو جهاز فضائي غير مأهول، وكما هو مخصّص لدراسة أجسام المنظومة الشمسية كذلك الفضاء الكوكبي. والمسابير الفضائية تقوم بدراسة الكواكب، وتطير في مسارات بالقرب منها وحولها، وتدخل إلى أجوائها أو تحطّ على سطحها. وهذه الدراسات تتمّ بواسطة أجهزة حديثة عالية التقانة تكون موجودة داخل المسابير أو مثبّتة على سطحها، وذلك بالتوازي مع المتابعة والمراقبة من على الأقمار الصناعية ومن على سطح الأرض. وعموماً، تُثبّت داخل المسبار آلات تصوير وماسحات تسمح بالحصول على معلومات دقيقة عن تضاريس سطح الكوكب موضوع الدراسة، وأجهزة لقياس الإشعاعات ودرجة حرارة الوسط المحيط، وتلسكوبات (غالباً راديوية)، وتجهيزات لتحديد التركيبة الكيميائية للفضاء المحيط وللتربة. وتُثبّت على المسابير أجهزة إرسال راديوية فائقة القدرة لإرسال المعطيات إلى مراكز التتبّع الأرضية، كما أنّ المسابير الحديثة مجهّزة بأجهزة إرسال واستقبال مزدوجة الاتجاه تسمح لمركز القيادة الأرضية بتغيير مسار المسبار وإعطاء أوامر أخرى. وعموماً، تتولّى الألواح والبطاريات الشمسية تأمين التغذية بالطاقة لكلّ منظومات المسبار وأجهزته. ويعود تاريخ إطلاق أول مسبار إلى الثاني من كانون الثاني/ يناير عام 1959، عندما انطلق لأول مرة في التاريخ من قاعدة بايكانور في كازاخستان، الصاروخ السوفياتي «فوستوك» حامل المسبار «لونا - 1» بسرعة انطلاقٍ توازي السرعة الفضائية الثانية (11.2 كلم / ثانية) وهي السرعة الضرورية للتخلّص من جاذبية الأرض، وكان هدف المسبار الوصول إلى سطح القمر. وبالرغم من عدم تحقيق الهدف بالوصول إلى سطح القمر (بسبب عدم احتساب الوقت الضروري لوصول الأوامر من الأرض إلى أجهزة التحكّم في المسبار) إذ إنّ «لونا - 1» عبر بالقرب من سطح القمر على مسافة 6000 كلم، وصار قمراً صناعياً للشمس، وخلال الرحلة تمّ قياس الحزام الراديوي الخارجي للأرض، وأُجريت القياسات المباشرة الأولى للرياح الشمسية، كما أُجري اختبار بتوليد مذنب اصطناعي، وتمّ التأكّد من عدم وجود حقل مغناطيسي مهم حول القمر، وبالرغم من أنّ الرحلة لم تحقّق أهدافها بالوصول إلى سطح القمر، إلّا أنّها نجحت جزئياً من وجهة النظر العلمية. وبعد شهرين أطلقت الولايات المتحدة الأميركية المسبار «بيونير - 4» باتجاه القمر، إلّا أنّ مساره كان بعيداً عن الهدف، ما لم يسمح له بالحصول على صور للقمر بجودة عالية. ولاحقاً، أُطلقت تسمية مسبار على كلّ الأجهزة المحمولة ضمن الجاذبية الشمسية والمخصّصة لدراسة القمر والمريخ والزهرة والكواكب الأخرى في المنظومة الشمسية. ومع تزايد أعداد المسابير المُطلقة، تمّ إعداد نظام دولي لترميزها وتسجيلها. والمسبار الأميركي مثلاً «بيونير - 10» (أُطلق في آذار / مارس من عام 1972) بعد عبوره بالقرب من كوكب جوبيتر (كانون الأول/ ديسمبر من عام 1973) تخطّى حدود المنظومة الشمسية (1983) وهو في مساره نحو نجمة ألديباران (Aldebaran)، وهي النجمة الألمع في كوكبة الثور، حاملاً تحية من كوكب الأرض، والتي ستصل إلى عوالم أخرى (في حال وجودها) بعد مليوني عام.
إنّ تشييد مسبار (من دون الدخول في شروط تصنيع صاروخ فضائي) يحتاج إلى معارف وتقنيات في عدد كبير من المجالات الهندسية والفيزياء التطبيقية، وهذا يفترض وجود مراكز أبحاث ومختبرات قادرة على تصميم كلّ الأنظمة المعقّدة والمتطوّرة، التي ينبغي تجهيز المسبار بها ليقوم بوظيفته. ولو راجعنا الإنتاج الصناعي للإمارات العربية المتحدة، لما وجدنا منتجاً واحداً تتوافر فيه هذه الشروط. ويمكن هنا الاستنتاج أنّ ما جرى في الإمارات لم يكن سوى استحضار علماء ومهندسين أميركيين من أصحاب الخبرة والمهارة، تولّوا تركيب منظومات المسبار التي اشترتها دولة الإمارات من الشركات المصنّعة، وقاموا بضبطها والتحقّق من تشغيلها، وبعد ذلك قامت اليابان بإطلاق المسبار على صاروخ حامل بالسرعة الفضائية الثانية، وتم توقيت وصول المسبار إلى مدار المريخ في الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات. وستتولّى محطّات الاستقبال الأرضي والأقمار الصناعية (طبعاً هي ليست إماراتية) نقل الإشارات والصور المرسلة من المسبار إلى مراكز المتابعة الفضائية لتجري معالجتها والاستفادة منها.
إنّ برامج غزو الفضاء هي كلٌّ متكامل تنطلق من الفضاء القريب (كما هي حال كل البلدان المنخرطة في البرامج الفضائية) لتتطوّر تدريجياً ويُبنى البرنامج بالترابط مع أهداف تنموية وعلمية محلية، بحيث يتمّ توظيف النتائج الفضائية بما يخدم التطوّر العلمي والتقني. وإذا افترضنا أنّ المسبار أنجز المهام المطروحة وأبرزها:
- معرفة أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ
- تقصّي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا والعليا
- تقديم الصورة عن كيفية تغيّر جو المريخ على مدار اليوم وبين فصول السنة
- مراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ، مثل العواصف الغبارية، وتغيرات درجات الحرارة
فإنّ هذه المعطيات تكتسب أهمّيتها كمعارف في مجال فيزياء المريخ، وهي معطيات لن تكون نهائية في دراسة المريخ، ويمكن الاستفادة منها في معاهد الأبحاث الفضائية حيث تشكل الفيزياء الفضائية أحد فروع البحث العلمي فيها، وهي جزء من منظومة متكاملة مع باقي فروع العلوم الفضائية. والإمارات، لا تملك أصلاً قاعدة علمية تقانية كهذه، ما يعني أنّ الإفادة من نتائج هذه الرحلة لا تعني الإمارات بشيء.
أمام هذه الحقائق العلمية، يتكشف حجم الدعاية والتسويق لإنجازات تمّ شراؤها من قبل دولة اختيرت من قبل الإمبريالية العالمية لتلعب دوراً خاصّاً في حركة التجارة ورأس المال العالمي، وهي تمتلك احتياطياً وافراً من النفط، وتشكّل مع السعودية أداة أساسية في النظام الرسمي العربي المتآمر على ثروات ومصالح الشعوب العربية، وتشكّل اليوم رأس حربة في الاندفاعة الرسمية لتوقيع الاتفاقيات مع الكيان الغاصب، في وقت يستمر فيه هذا الكيان في قتل الفلسطينيين والتنكّر لأبسط حقوقهم الوطنية المشروعة، وما خبرية دخولها إلى نادي بلدان الفضاء إلا بالون دعائيّ مدفوع الثمن يحاول حكّامها استخدامه للتغطية على خيانتهم الوطنية.
* أستاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا
المسبار وأوهام العظمة!
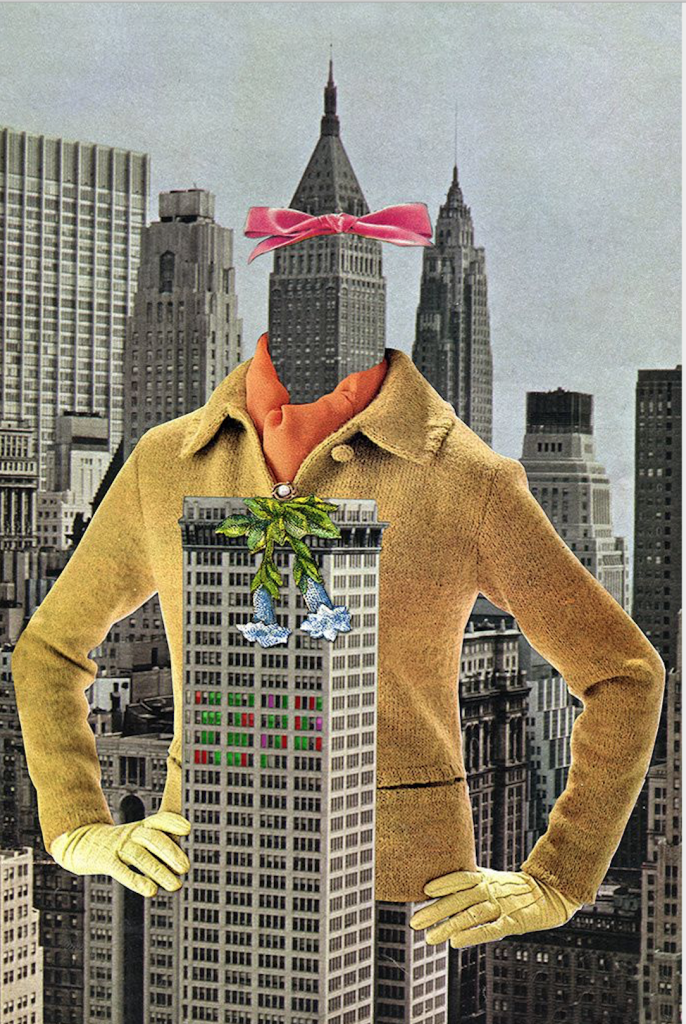
كولاج للفنانة اليونانية أوجينيا لولي (الولايات المتحدة)


