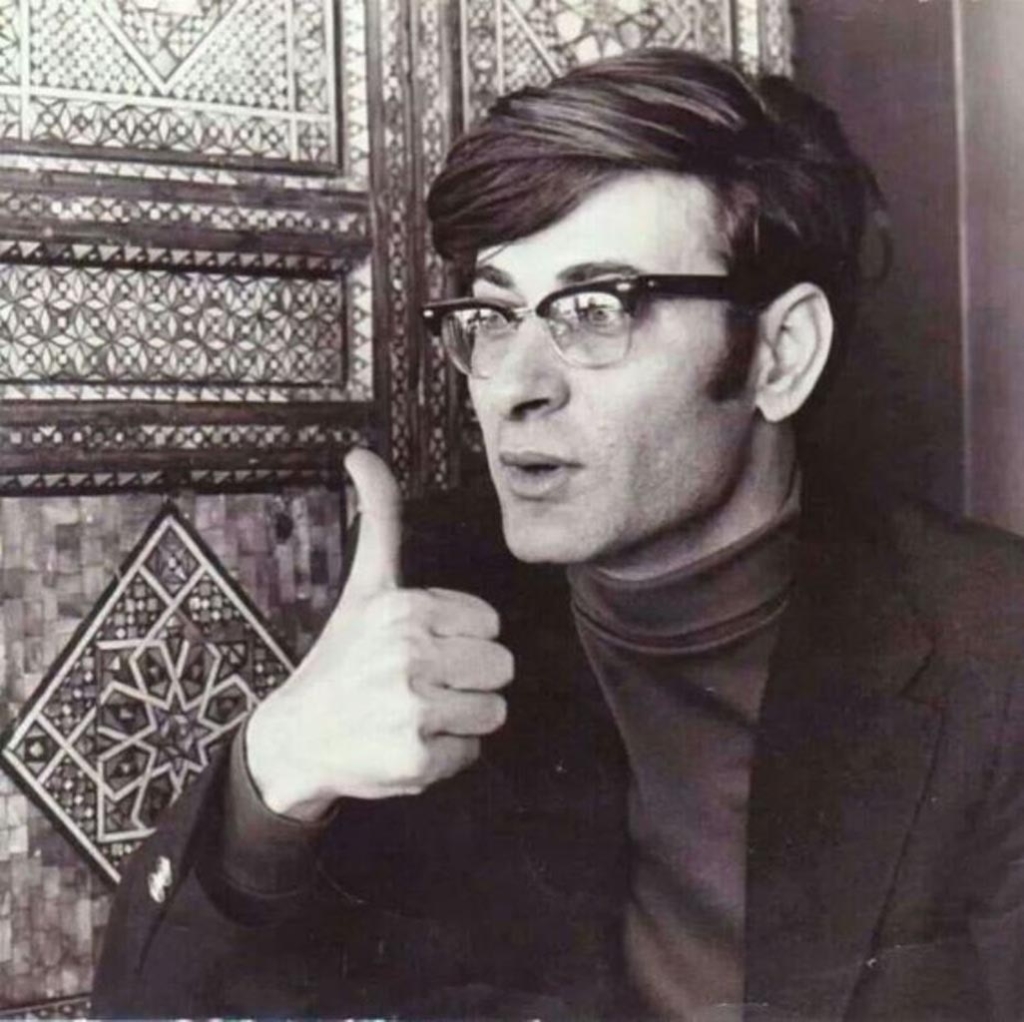
وكان محمود درويش ذاته قد توقف مبكراً عن قراءة هذه القصيدة في أمسياته الشعرية، رغم مطالبة جمهوره بها. إذ بدا له من غير المنطقي أن يصرخ «سجل أنا عربي» بين العرب. فقد كانت حين كتبها قصيدة مواجهة، وكان المخاطب فيها هو الصهيوني الإسرائيلي، وليس العربي أساساً.
غير أن على المرء أن يعترف أن لهذه القصيدة تاريخاً، وأن تاريخها جزء من تاريخ المنطقة، بل إنه جزء من تاريخ الأمة، إن كان هناك أمة في الحقيقة.
كان ميلاد القصيدة الفعلي حين ألقيت في الناصرة عام 1963. وكان درويش قد كتبها بعد حادثة وقعت معه في وزارة الداخلية الإسرائيلية. فقد قدم طلباً الحصول على بطاقة هوية. وحين سأله الموظف الإسرائيلي عن قوميته، رد محمود: «عربي». فكرر الموظف السؤال على نحو مستنكر، فرد عليه محمود: «سجّل أنا عربي». ومن هذه الحادثة انبثقت القصيدة. هكذا حكى محمود في إحدى مقابلاته.
لكن لديّ وثيقة (1) تشير إلى أنه ربما كانت هناك مسودة أولى للقصيدة لم تكن تحوي جملة «سجل أنا عربي»، بل جملة «طبعاً عربي». لكن يبدو أن محمود نسي ذلك، وظن أن القصيدة كتبت دفعة واحدة من دون مسودات. المسودة التي أتحدث عنها بعنوان «كاريكاتور»، وهي تقول:
«- درويش، مطلوب للفحص الطبي
- جنسك...
- طبعاً عربي»
ومن المحتمل أن هذه المسودة هي التي كتبها في الباص بعد الحادثة: «قلت له مجدداً، وكان الحوار يجري بالعبرية: سجل انا عربي. خرجت من عند الوظف، وأعجبني الإيقاع. فبدأت في رأسي بتدوين القصيدة قبل أن أكتبها على قصاصة ورق في الباص في طريقي إلى البيت» (مقابلة مجلة «نزوى» 2002). وفي هذه الحال، تكون الجملة الموقعة «سجل أنا عربي»، قد انبثقت بعد وصوله إلى البيت. لم تكن جملة «طبعاً عربي» لتوافق الغرض. لم تكن تملك إيقاعاً متماسكاً قادراً على الإمساك باللحظة. المعنى ذاته في الجملتين. فوق ذلك، فإن كلمة «سجّل» جعلت المعنى يبدو مختلفاً. فهي أمر إثبات. إشارة بالسبابة كي يثبت القول ويصير وثيقة.
على كل حال، كان محمود متشككاً في ما إذا كانت القصيدة شعراً حقاً. كان معجباً بها في ما يبدو، لكنه كان يدرك بشكل ما أن فيها مشكلة، أو أن فيها ما يجعلها بين الشعر واللاشعر. ثم جاءت أمسية 1963 في الناصرة. وهناك قرأ محمود عدة قصائد، فصفق له الجمهور بشدة، وطلب منه أن يقرأ قصائد أخرى. لكن حسب قوله، لم يكن لديه إلا ورقة «سجل أنا عربي» في جيبه. فأخرجها من جيبه، وقرأها. ولم يكن يدري حين بدأ بقراءتها أنه يفجر قنبلة نووية: «وحدث ما لم أكن أتوقعه. شيء يشبه الكهرباء شاع في الجو، حد أن الجمهور طلب مني إعادة القصيدة ثلاث مرات» (مقابلة مجلة «نزوى» 2002).
وكانت تلك الأمسية حدثاً حاسماً في مسار محمود درويش الشعري، بل في مسار الشعر الفلسطيني أيضاً. لا يمكن فهم هذين المسارين من دون هذه الواقعة. والحق أن محمود درويش تمعن جيداً في معنى هذه الحادثة لاحقاً: «أقول لك بصراحة: من قرر أن هذه قصيدة هم الناس وليس أنا. هم الذين قالوا لي: هذا شعر» (مقابلة مجلة «نزوى» 2002). وهنا، في هذه الجمل، يلتقط محمود الحقيقة التي طبعت الشعر الفلسطيني من منتصف الستينات إلى منتصف الثمانينات على الأقل، حقيقة أن الشعر لم يكن في ذلك الوقت صناعة فردية فقط، بل صناعة جماعية. فالناس الذين مسّتهم الكهرباء، هم الذين قرروا أنّ «سجل أنا عربي» شعر. الناس هم الذين حكموا. بذا، فتدخّل الناس كان حاسماً في تعريف الشعر.
يقول محمود إنه التقط في هذه القصيدة «مكبوتاً بسيطاً جداً» عند الناس وعبّر عنه، فاندمج الشاعر بالجمهور، واندمج الشعر بالناس. لكنني أعتقد أن الأمر يتعدى البساطة الظاهرية. كان عالم الفلسطينيين كله في ذلك الوقت، أي حوالى منتصف الستينات، يتجه نحو نقطة انفجارية. أما محمود، فقد وقف فوق هذه النقطة، وفجر القنبلة. وكانت القنبلة جملة موقعة: سجّل أنا عربي».
القصيدة التي انفجرت كقنبلة مرتين في عام 1963، وفي عام 1967، قتلت. قتلها الزمن. قتلتها الهزائم
وبهذه الجملة، انتهى زمن وبدأ زمن. انتهت مرحلة في الشعر وبدأت مرحلة.
مرة ثانية، يلتقط محمود اللحظة. لكنه أمسك بلحظة أخرى في ديوانه «عاشق من فلسطين» الذي صدر عام 1966. ولا بد من أن قصائده كتبت بين عامي 1964-1966. فبعدما أمسك باللحظة العربية، أمسك بقبضته باللحظة الفلسطينية. تجلى هذا في قصيدة «عاشق من فسطين». كانت القصيدة تكراراً لكلمة فلسطينية: فلسطينية العينين والاسم، فلسطينية الجسم، فلسطينية الكلمات والصوت، فلسطينية الميلاد والموت. كان تكرار كلمة «فلسطينية» مثل تكرار جملة «سجل أنا عربي». كان لا بد من التكرار. لا بد أن يتكرر الاسم الذي محي، يستعاد، وكي يفهم العدو ذلك.
والحال أن «عاشق من فلسطين» لم يكن أيضاً عملاً فردياً لمحمود درويش. كانت القصيدة المتفجرة عملاً فردياً للشاعر، لكن الديوان ككل كان عملاً جماعياً، بدءاً من اسمه. فقد حمل محمود مسودة الديوان إلى غازي السعدي كي ينشره في «دار الجليل» التي انتقلت لاحقاً إلى عمان. وكان عنوان المجموعة «غيوم على المرايا». رفض السعدي هذا العنوان، وقال لمحمود: شو يعني «غيوم على المرايا»؟ ومن سيفهم هذا الكلام؟ واقترح عليه ان يسميه «عاشق من فلسطين»، تشابهاً مع ديوان محمد الفيتوري «عاشق من إفريقيا»، الذي صدر عام 1964، وأعاد السعدي طباعته في فلسطين 1948.
عاد محمود إلى شلة أصدقائه الذين على رأسه محمد ميعاري، وناقشوا اسم الديوان. وقرروا قبول اقتراح السعدي. وصدر الديوان بالفعل باسم «عاشق من فلسطين». لقد قررت المجموعة أن «غيوم على المرايا» لا ينفع كعنوان، وأقرت «عاشق من فلسطين». كان الشعر في نهاية المطاف، يلعب على الحد بين الفرد والجماعة. كانت الجماعة جزءاً من الشعر.
على كل حال، لنعد إلى قصيدة «سجل أنا عربي». فقد قدِّر لهذه القصيدة أن تعيش حياة جديدة. قدر ها أن تنفجر مثل القنبلة من جديد. فبعد هزيمة عام 1967، كان العرب كلهم مذلين مهانين، وكانوا يبحثون عن من يقنعهم أنهم ليسوا كلاباً ضالة. وهنا انبثقت لهم قصيدة «سجل أنا عربي». وانتشرت القصيدة مثل قدحة نار في الهشيم.
وهكذا قدر لهذه القصيدة أن تمسك باللحظة من جديد. لكنها أمسكت بها هذه المرة وحدها من دون تدخل درويش ذاته. لقد أفلتت من بين يديه وتدحرجت كعربة نارية. لم تعد تهتم بشاعرها. لم يعد وجوده يهمها.
أما الشاعر فقد بدا وكأن القصيدة التي رفعته، تحولت إلى حاجز في طريقه. لم يكن يريد أن يكون لعبة بيد مشاعر اليائسين الذي يبحثون عن الأمل والتحدي ولو في الكلمة. يسأل محاور مجلة «نزوى» محمود عن القصيدة:
«-طاردتك؟
- تماماً. هنا في بيروت أو في العالم العربي. كنت أخشى أن تشكل عائقاً يمنع القارئ من متابعتي.
- لكن رغم ذلك للقصيدة فضل كبير عليك؟
- لا انكر ذلك، فهي التي عرفت الناس علي، لكن هذا لا يعني أن أبقى، أو أن يبقى شعري، أسيرها» (مقابلة نزوى).
إذن، فوقوف الشعر على الحد بين الفرد والجماعة خلق مشكلة أيضاً. وكان محمود أول من أدرك عمق هذه المشكلة. وقد حاول أن يبني حلفه مع الجمهور بطريقة أخرى وعلى أسس أخرى. كانت حياة درويش تحالفاً ومواجهة بينه وبين الجمهور. كانت محاولة لـ «تطويع قصيدة «سجل أنا عربي»».
أما القصيدة فهي الآن في لحظتها الثالثة التي لا تمسك فيها بشيء. ليس لها يد كي تمسك بها. لقد قطعت يدها في هذه اللحظة التي لا معنى لها. فلم يعد أحد قادراً على أنا يصرخ: سجل أنا عربي. ذلك أن مثل هذه الصرخة ستبدو بلاهة مطلقة. فليس هناك الآن ما يمكن لعربي أن يفاخر به الآن.
القصيدة التي انفجرت كقنبلة مرتين في عام 1963، وفي عام 1967، قتلت. قتلها الزمن. قتلتها الهزائم.
ويا لها من قصة. يا لها من قصيدة.
1- أرتني الكاتبة امتياز دياب مسودة قصيدة «سجل أنا عربي». كما أنّ المعلومات حول تغيير اسم مجموعة محمود درويش منها. دياب تخرج فيلماً عن محمود درويش، وتكتب كتاباً عن بداياته
* شاعر فلسطيني
مقابلة مجلة نزوى


