مقالات مرتبطة
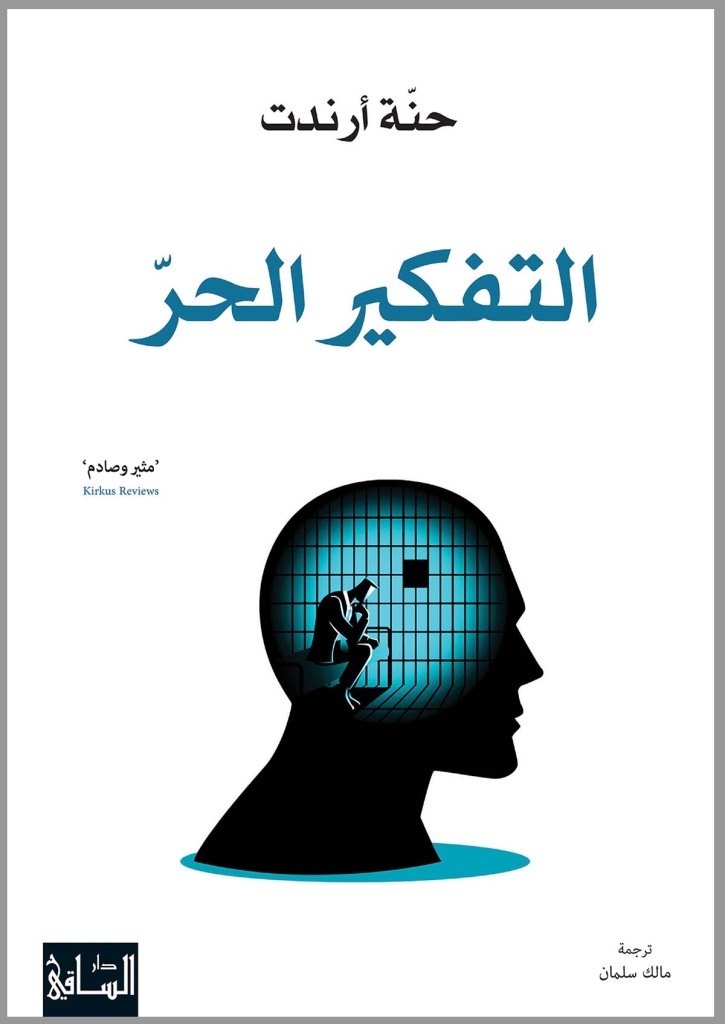
وبين أيدينا ترجمة جديدة لعملها الذي حمل بالعربية عنوان «التفكير الحر» أنجزها مالك سلمان (دار الساقي) والترجمة الحرفية من الإنكليزية تقول: «التفكير من دون درابزين ـــ محاولة في الفهم 1953 ـــ 1975» Thinking without a banister : essays in understanding المنشور عام 2018 بإشراف وتقديم جيروم كون (J. Kohn)، ورعاية القيّمين على تراثها الفكري، وهو يشرح بعض سياقات أفكارها والمناخ العام الذي هيمن على القرن العشرين الذي أثّرت فيه عميقاً.
الكتاب المذكور عبارة عن مجموعة من الدراسات والمقالات والمقابلات والخطب والرسائل والمداخلات والردود، وُضعت في مناسبات وأزمان متباعدة. لكنّ المسألة السياسية والسلطة والثورة تقع في قلبها، وبالتأكيد قضية الحرية، وقد قدّمت فيها معنى جديداً للحياة السياسية في زمن أزمة المجتمع الحديث. فداخلت في «الانعتاق» والثورة وشروطها ومعناها، والشمولية والحرب الباردة وفي الدولة القومية والتقليد والقيم والأخلاق، من دون أن تنسى توجيه التحية لأستاذها ومرشدها، الفيلسوف الألماني الأشهر مارتن هايدغر «في عامه الثمانين».
ولدخول عالم أرندت، من المفيد نقل قولها حول «التفكير من دون درابزين»: «عندما تصعد وتنزل الدرج يمكنك أن تتمسك به كيلا تقع. لكننا فقدنا هذا الدرابزين. أنا أفكر بهذه الطريقة. وهذا ما أحاول أن أفعله في حقيقة الأمر».
تتحدث أرندت هنا عن الفهم والحكم من خلال الذات من دون الاعتماد على «المقولات المتصوّرة مسبقاً». هذا ما قصدته بعبارة «التفكير بدون درابزين» (من دون شيء نستند إليه) كما فعل نيتشه في «هكذا تكلم زرادشت»، إذ رأت أرندت أن فقدان المعايير المميّز لعصرنا يمثل أزمة وفرصة في الوقت نفسه. عندما يفكر المرء بدون تحديدات، فهو يفكر من دون الرجوع إلى مقولات الفكر التي لا جدال فيها. وعندما يحثنا نيتشه على الشك بنحو أفضل من ديكارت، فإنه يحثنا على التفكير من دون عوائق، ومثل هذا التفكير خطير لأنه يجب أن يكون فوق الخير والشر وبالتالي بدون الرجوع إلى «الأخلاق».
إن اهتمام أرندت بالتفكير الذاتي لازمها مدى عمرها، ويعود على الأقل إلى وقت عملها مع أستاذها هايدغر. أعلنت في مؤلفها «الوضع البشري» (1958) عن اهتمامها «بالتفكير في ما نفعله». مع ذلك، فإن تأملات أرندت الأولية والأكثر شمولاً حول التفكير جاءت إلى درجة كبيرة من تجربتها في محاكمة أدولف أيخمان (1961). لقد صُدمت في القدس بالدرجة التي كان فيها أيخمان إنساناً عادياً - ليس سادياً - ولا حتى معادياً للسامية بشكل خاص. وجدت أنّ ما كان محورياً بالنسبة إليه هو عدم تفكيره. والتحدي الذي تضعه لنفسها ولنا جميعاً هو إعادة تعلم فن التفكير.
رغبت المُنظرة السياسية في رؤية «الشر المحض» (الجذري بتعبير كانط الذي استعاده الفيلسوف الفرنسي بول ريكور لاحقاً) الهادف إلى التدمير الصرف، ذاك الذي «لا يتمتع بأي ارتباط جوهري بمعاداة السامية أو أي إيديولوجية أخرى»، وكانت قد رأت الشر في ظهور الأنظمة الشمولية (التوتاليتارية) ومصادرتها للحرية الإنسانية.
قدّمت معنى جديداً للحياة السياسية في أزمة المجتمع الحديث
في نصها عن «الثقافة والسياسة» (1958) استعراض واسع للمفهومين ولا سيّما عند اليونان، إذ أدرك الإنسان نفسه «كائناً سياسياً» إلى صفته الإنتاجية من خلال العمل، وبناءً عليه، ترى المفكرة حاجة السياسة إلى الثقافة، لأن هذه الأخيرة تضمن استمرار أقوال وأفعال البشر الفانين، وإلى تداخلهما ثمة خاصية مشتركة بينهما هي انتماؤهما كظاهرتين إلى «العالم العام». تقرّ بأنّ الفضاء السياسي لا يزدهر ويعيش في «معزل عن جمال الأشياء الثقافية، وتلك الأبهة الساطعة التي تتجلى فيها الديمومة السياسية وخلود العالم».
ترى أرندت في «محاضرة في الحرية والسياسة» (1960) إلى الارتباط بينهما بخلاف التعريفات الكثيرة للحرية، فلا يمكن اختبارها، في شكل إيجابي إلا في «عالم السياسة والفعل، ففي المجتمعات الاستبدادية تغيب السياسة عن الفضاء العام: الحرية والسياسة متزامنتان في تجسّدهما الواقعي وترتبطان ببعضهما كوجهي العملة الواحدة». بيد أن العصر الحديث فصل بينهما وركّز على مسألة الأمان من دون الحرية، وجهدت الأنظمة الشمولية في قمع الحريات. غير أن أرندت تقدّر أنه من العسير منع البشر من التصرّف بحرية، ذلك أن لا أحد يستطيع منع الناس «من التفكير والإنتاج وتجريدهم من الإرادة». لا تربط أرندت الحرية بحرية الإرادة أو الاختيار، كما يفعل أكثر الفلاسفة الغربيين التقليديين، بل تربطها بالفعل، فـ «الناس أحرار في سياق الفعل، وليس قبله أو بعده، وأن تكون حراً يعني أن تكون منخرطاً في الفعل». بالتالي، يتطلب ذلك ميداناً مناسباً للفعل. تشدّد على أنّ أشياء كثيرة تعتمد على الحرية الإنسانية، ولا سيّما «قدرة الإنسان على منع الكوارث» التي تحدث دائماً. وقد أكدت على الفعل في قولها أثناء مشاركتها في مؤتمر عن أعمالها نظّمته «جمعية تورنتو لدراسة الفكر الاجتماعي والسياسي» عام 1972: «إنني أؤمن أن الفعل مشروط بالعمل الجمعي، وأن التفكير شيء فردي، وهذان وضعان وجوديان مختلفان تماماً». وحين سئلت عن موقعها في الانتماءات المعاصرة، أجابت بشفافية، بأنها لم تكن اشتراكية أو شيوعية، رغم أن أبويها كانا اشتراكيين، والمجموعة الوحيدة التي انضوت فيها هي «الصهيونية» بين عامَي 1933 و1943، ومن ثم انفصلت عنها، وهي تعبر عن ندمها، وتبرر هذا الانتماء بأنه كان للدفاع عن نفسها بصفتها يهودية، وكان أجدر بها أن تدافع عن نفسها بصفتها كائناً إنسانياً.
انتهت أرندت في تجربتها الفكرية الغنية إلى الانسحاب من العالم والانغماس في التفكير الذاتي، حين تبدّت لها صعوبة المهمة من دون شيء تتكئ عليه، وحين وجدت هوّة عميقة بين الماضي والمستقبل، وهي تنقل عن المفكر الفرنسي ألكسيس دو توكفيل قوله: «عندما لا يعود الماضي يلقي بضوئه على المستقبل، فإن عقل الإنسان يهيم في المجهول». لذا، رأت أن على المرء التفكير «كأنّ أحداً لم يفكر من قبل، ومن ثم يبدأ في التعلّم من الآخرين». وكما سبق أن عبّرت أرندت في «الوضع البشري»: «ليس اغتراب الأنا، كما كان ماركس يعتقد، هو خاصية العصر الحديث، بل هو الاغتراب عن العالم».


