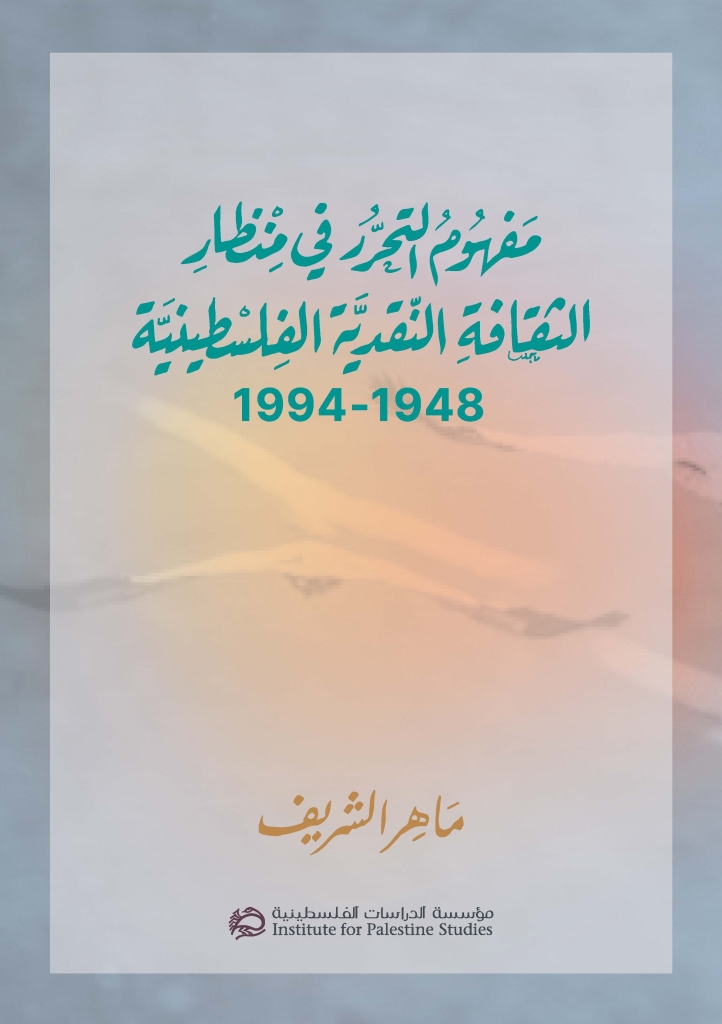
يبرر الشريف «منهجه الوصفي» بالتنبيه إلى أن اختياره هذا لا يعني مطلقاً أن حقل الثقافة النقدية الفلسطينية اقتصر عليهم، لكنه يقول إنّهم «انتموا بصورة عامة إلى مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنهم اتخذوا، وخصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو، مواقف نقدية من قيادتها وإزاء عملية السلام وتداعياتها. وكنت على معرفة جيدة بنتاجها في هذا المضمار». إذاً، هم ليسوا من مشارب متعددة طالما أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تضمّ من كل المشارب الفلسطينية المتعددة، مع أملنا، ورغبتنا، في إصدار جزء ثانٍ لهذه المساهمة البحثية في حقل الدراسات الثقافية التي يعتمدها المؤلف في إصداراته. فالساحة الفلسطينية تغلي، ولا تخلو!
في مقدمة الكتاب (220 صفحة مع خاتمة والمراجع وفهرست الأعلام)، أوضح الشريف «أن المثقف النقدي الذي أعنيه، هو ذاك الذي رفض أن يكون آلة في يد السلطان». ونقل عن قسطنطين زريق أن أوّل واجبات المفكر في أوقات الأزمات هو «أن يحسّ بالأزمة ويحياها، وأن يحدد تحت وطأة الأزمة التي يحياها فهمه لوظيفته التي تتمثّل في تبيّن الحق وتبنّيه». وهو ما تناوله الفصل الأول من الكتاب بعنوان «كيف تصوّر المثقف النقدي دوره المجتمعي وعلاقته بالسياسة»، لنلحظ تبايناً في آراء المثقفين النقديين الفلسطينيين في شأن العلاقة التي ينبغي لها أن تقوم بين الثقافة والسياسة. انتقد فيصل دراج منظمة التحرير الفلسطينية، قائلاً: «في ممارساتها السياسية والثقافية، لم تطور ما هو حديث في الحياة السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، بل عاقت وهمّشت وحاصرت كل ما هو حديث». وميّز إدوارد سعيد المثقف بالقول إنّ «الصوت لا يمتلك رنيناً وصدى إلا عندما يربط نفسه بملء حريته بواقع حركة ما، وطموحات شعب ما، والسعي العام وراء مثال أعلى مشترك ما»، ليوجّه أنيس الصايغ نقده اللاذع إلى ما سمّاه «المثقف الفلسطيني الذي ركب موجة النضال أيام الثورة ولبس ثوب المسالم أيام الاستسلام»، مؤكداً أنّ «كيان إسرائيل المزروع في بلدي سيظلّ سرطاناً خبيثاً».
وفي ظل هذا التباين، لم يمنع أن يحتوي مضمون الخطاب النقدي على ملامح بارزة في تشريح الواقع، فأكد هؤلاء على خصوصية الهوية الفلسطينية ودور الذاكرة في حفظها، وتعددية العناصر التي تكوّنها، وأيضاً في التركيز على جوهر الضعف الفلسطيني، وإعلاء شأن العمق العربي للثقافة الفلسطينية، والإيمان بأهمية التفاعل الحيّ بين الثقافات المتعددة، ولكن «مع حقنا في حماية ذاكرتنا الجماعية، وحقنا في سرد روايتنا التاريخية» كما قال محمود درويش.
ولبلوغ مضامين مفهوم التحرر، نلاحظ ربط المثقف الفلسطيني بين التحرر الوطني والتحرر المجتمعي، من بينها تحرر المرأة كقضية مجتمعية، فتوقفت الدكتورة فيحاء عبد الهادي عند «التغيرات التي حدثت على مستوى وضع المرأة خلال الانتفاضة الشعبية عام 1987 مثل اتساع المساحة التي تتحرك ضمنها، لكن بعد أوسلو – تقول عبد الهادي – راحت تتشكّل حركة نسوية جديدة اعتمدت على التمويل الخارجي، واستبدلت المتطوعين بالموظفين، وركّزت على القضايا الاجتماعية على حساب القضايا الوطنية». وهو ما أيّدته الباحثة يارا هواري بنقدها لمؤسسات المجتمع المدني بقولها إنّ «تمكين المرأة اقتصر على التمكين الاقتصادي، وليس على تمكينها من مقاومة الاحتلال ووضع رؤية لما بعد الاستعمار».
ومن سبل بلوغ التحرر، دعوات للأخذ بأسباب الحضارة الحديثة، وتعظيم شأن الفعل الاجتماعي والأخلاقي، واعتماد العقل والعلم والتعليم الحديث (يعدّ إبراهيم أبو لغد واحداً من أبرز الذين انشغلوا بالتعليم الحديث بين صفوف النقديين الفلسطينيين، وقد عمل مع الدكتور علي الجرباوي وبالتعاون مع اليونسكو على وضع منهاج تعليمي وطني حديث).
بعد أوسلو، ظهرت حركة نسوية جديدة اعتمدت على التمويل الخارجي
في الفصل الرابع من الكتاب بعنوان «الصهيونية ومعاداة السامية، والتطبيع الثقافي في منظار المثقف النقدي»، لم يقصّر هؤلاء في فضح الصهيونية، وعنصريّتها، وتحالفها الوثيق مع الإمبريالية، فكشف إميل توما ربْط القيادة الصهيونية بالتوراة «بعد رفضها عرض بريطانيا بالاستيطان في أوغندا لأنها لا تلهم الشعب اليهودي قومياً ودينياً». وتَوَافَقَ في ذلك المتديّنون منهم والعلمانيون، فأعلن بن غوريون «الاشتراكي غير المتديّن، آكل لحم الخنزير أن التوراة هي وثيقة انتدابنا» (ص 144).
أما في مسألة التطبيع الثقافي، فنلحظ تبايناً في الآراء، لكن أنيس الصايغ كان الأكثر حدة في مقاربته لها، فرأى أنّ «التطبيع مرض، ووباء مُعدٍ تمتدّ سلبياته إلى عموم أنحاء الوطن العربي، وهو أخطر من الغزو العسكري».
ينهي الشريف مع الفصل الخامس حول الحل الذي تصوّره المثقف النقدي الفلسطيني للصراع الدائر على الأرض الفلسطينية، لنلحظ أيضاً تفاوتاً في الاقتراحات، ودوراناً في طابعها السلمي (!) وبخاصة أنّ أياً من هؤلاء لم يشر أو يقدّم تبنّياً للمقاومة المسلحة، لكن الصايغ يحسمها أيضاً بقوله: «لا تعايش إطلاقاً بين الحق العربي والشر الصهيوني في فلسطين» ومعها، صارت الحلول التي قدموها لا تبرح النظريات الثقافية/ الفكرية، لأن مع عدو صهيوني/ توراتي/ عنصري/ احتلالي/ إحلالي، إرهابي كهذا لن تنفع معه سوى محطات كالعام 2000 في لبنان، والعام 2006 في لبنان أيضاً، وما سبق وتلى هذه المحطات من مسيرة شعب فلسطيني أعلى الشهداء مرتبة الأحياء. كيف استطاع إدوارد سعيد المجيء إلى الحدود اللبنانية – الفلسطينية ليرمي حجره؟


