
لماذا تكتب «شعر/ سرد» على كتاب المتنبّي؟
ـــ على الكتاب عبارة «شعر/ سرد» لأنه قسمان: الأول عبارة عن عشرين قصيدة نثر. كل قصيدة بمثابة ردّ على بيت للمتنبي أو ترجمة له عبر الزمن. الثاني نص سردي شخصي عن الفترة التي كُتبت فيها هذه القصائد والظروف المحيطة بكتابتها. كانت الفكرة الأولى كتابة مقالات نقدية قصيرة بالتوازي مع القصائد، لكني استعضت عن ذلك بنص واحد طويل نسبياً وبسيط جداً في لغته وصياغته على عكس القصائد نفسها. إنه حول ملابسات علاقتي بالمتنبي وما أسفر عنه لقاؤنا وما تشير إليه النصوص. لذلك غيّرت عبارة «شعر/ نثر» إلى «شعر/ سرد». وكنت متحمّساً جداً لكتابة هذا النص بعدما انتهيت من القصائد، لأنه أيضاً طبعاً عن حياتي والتحول الذي حصل معي بعد الأربعين وعن الغرام والموت والكتابة. أليس كل شيء نكتبه عن هذه الأشياء وعن الذات؟
من أي نقطة بدأت الكتابة عن كتاب «المتنبي»؟ ما الخطة التي رسمتها لنفسك؟ وإلى ماذا انتهيت؟
ـــ لم تكن هناك خطة بهذا المعنى. كل ما في الأمر أني قررت أن أقرأ ديوان المتنبي بشكل جدي. وعندما انغمست في القراءة تأثّرت ببعض الأبيات إلى درجة التماهي معها شعرياً. حدث هذا مرتين أو ثلاثاً قبل أن أستشعر باحتمال إنجاز متتالية أو كتاب.
هل تشعر بندّية مع المتنبي؟ ولماذا؟
ـــ ليست هناك ندية ولا سؤال عن الندية. ربما المطروح هو وعي الشاعر. ماذا يبقى من وعي الشاعر لو انمحى الظرف التاريخي المحيط بكتابة الشعر. أشعر أن هذه النصوص لقاء مع تراث المتنبي. إنها تستدعيه وتغازله وتؤوّله وتدحضه أيضاً، لكنها في النهاية قصائد نثر عن حياة كاتب موجود هنا الآن. لا مجال للمقارنة لكن هناك مساحة، عبر الشعر، للحوار.
أظن أن الكتاب من هذه الناحية محاولة للإجابة عن سؤال ما هو الشعر، وأنا مشغول بهذا السؤال المستحيل منذ بدأت أكتب. إنه موجود في رواية «التماسيح» حيث تُطرَح فكرة أن الشعر – وهو في ذلك أشبه بالصمت أو السر – خطاب حر، أو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن تكون له سيادة في مقابل خطابات مُستَعمَرة من جانب المكان والزمن إن لم يكن الأيديولوجيا أو القناعة، خطابات منبطحة لـ «المعنى». على عَكْس الكليشيه والنكتة والشعار، الشعر أو الأدب هو الخطاب الذي يجعل من اللغة وجوداً أو حضوراً أقوى وأوسع من الشرط المادي أو اللحظة التاريخية أو حتى حدود الكاتب.
لافتة علاقتك باللغة، هل تستخدمها نوعاً من استدعاء التراث؟ وهل أنت مهتم بفكرة «إحياء التراث»؟
ـــ بالنسبة إلي تظل اللغة خامة متغيّرة لها صفات تؤثر في شكل الكتابة. في نصوص المدن العربية مثلاً، كنت أستدعي لهجة المكان الذي أكتب عنه. في كتاب «الطغرى»، كنت أحاكي العربية الوسيطة التي كتب بها الجبرتي وابن إياس، كما أقدّم صورة بانورامية واسعة عن كل «عربيات» القاهرة المحتملة. في «التماسيح»، كنت أستدعي لغة قصيدة النثر التسعينية. وفي «باولو»، أتحاور مع لغة المدونات. «ولكن قلبي» هو أول محاولة لمقاربة «اللغة العالية» كما يسمونها أحياناً. أقصد الكتابة بعربية وإن كانت معاصرة وتضمّنت ألفاظاً أجنبية وصياغات معاصرة تظل خالية تماماً من اللحن والخطأ، ونموذجها هو ذروة النهضة الأدبية في العصر العباسي. إنها خامة جميلة وإن كانت صعبة. لكنني أتعلّم العربية من جديد.
ليس عندي تفسير واضح لهذا التركيز على اللغة إلا ربما كون علاقتي بلغتيَّ – العربية والإنكليزية – شيئاً مركّباً ومتداخلاً منذ الصغر، وكوني من ثم واعياً جداً لاختلاف الكلام عن النص المكتوب. لكن أظن أن اللغة هي نفسها الكتابة بمعان كثيرة، هل يمكن أن يكتب أحد ولا يهتم باللغة على مستوى ما؟ وكيف يتذوق إنسان نصاً لا ينتبه إلى لغته؟
لديك ثنائية الحداثة/ التراث، في أكثر من مشروع، هل هذا سؤالك الدائم في الأدب؟
ـــ يبدو أن هذه سمعة التصقت باسمي. أنا لا أمانع ذلك، لكن أريد أن يهتم الناس بمحتوى ما أكتبه وأدبيته الأوسع أيضاً! يبدو لي بديهياً أن تكون اللغة عاملاً أساسياً بالذات في زمن الوسائط السمعية البصرية حيث هناك وسائل أنجع لحكي حكاية مثلاً أو عرض موضوع. أظن أن الإبداع في التعامل مع اللغة هو جزء من عملية الكتابة في كل الحالات، لكن في بعض الحالات عندي ربما يأخذ حيزاً أكبر. على أي حال، أنا أكتب الآن شيئاً أحاول من خلاله أن أتجاوز موضوع اللغة تماماً على أمل الوصول إلى مكان يكون السرد فيه هو المحرّك الأول.
لست معنياً بإحياء التراث ولا أفهم تقديسه. أعتقد أني معني بالهوية وهناك جوانب من التراث تغذّي تساؤلاتي عنها. لكنّ هناك أيضاً نصوصاً قديمة أحبها ليس لأنها تراث ولا بوصفها كذلك. العربية الفصحى فيها امتداد رهيب عبر المكان والزمن، وهذا يشجع على البحث واللعب. في «الطغرى»، كان الماضي مرجعية فقط. الماضي الأفضل من الحاضر، في سياق القاهرة. وبهذا المنطق، لعب التراث المكتوب دوراً في العرض لعظمة الماضي وإضاءة الحاضر بها. كان هذا أيضاً لقاء.
هل تعتبر استدعاء المتنبي جزءاً من استدعاء التراث ووضعه على طاولة شخصية كما حدث في «الطغرى»؟
ـــ المتنبي بالنسبة إليّ، يكاد يكون عكس إحياء التراث. كل الفكرة في التماهي معه من مكاني هنا الآن، واختبار تصوري أنه فعلاً صالح لذلك.
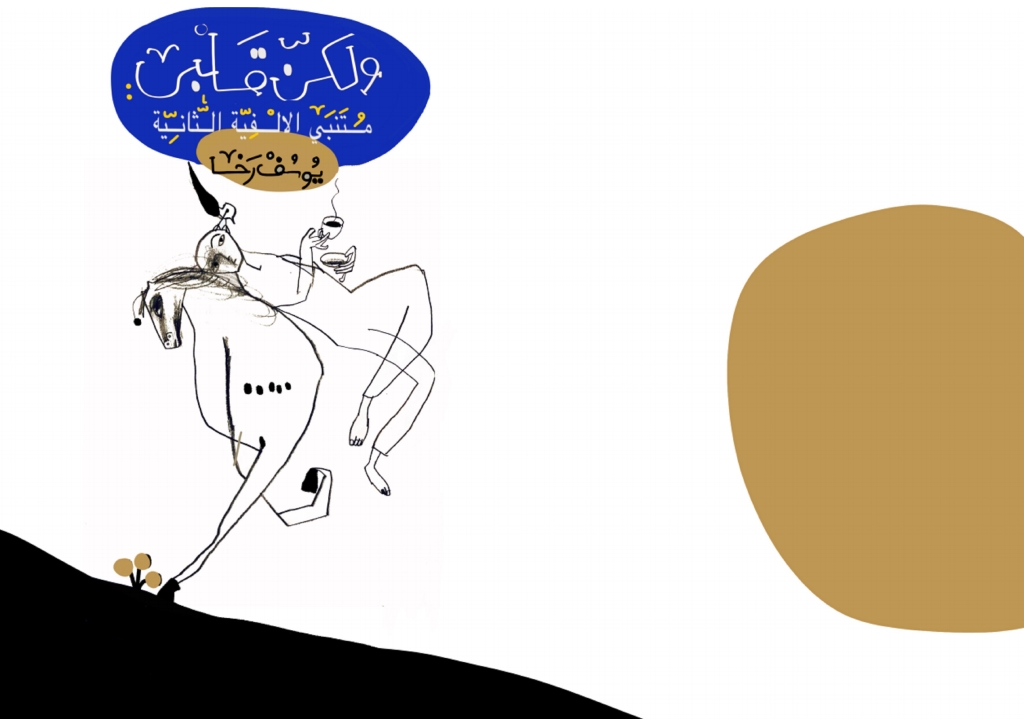
كتبت عن بيروت، تونس والقاهرة، ما الذي دفعك للكتابة عن هذه الأماكن بالذات؟ وهل كتابتك عن بيروت وتونس هي كتابة عن القاهرة بشكل ما؟ هل ذلك صحيح؟ كيف؟
ـــ كنت أتفادى صيغة الرواية وأتفادى القاهرة وكنت مشغولاً بالهوية، فكتبت عن المدن العربية مستعيناً بزيارات قصيرة وبحث طويل. كنت أوظف آليات الصحافة لأغراض أدبية، وأمزج الشعر بالسرد والتنظير. ولعل كتب الأماكن هذه كانت أحد التجليات المبكرة لموضة الـ creative nonfiction المنتشرة اليوم بالعربية. في الكتابة عن مدن مثل بيروت وتونس، كانت القاهرة دائماً هي المرجعية التي أتحرك من عندها وأعود إليها. لذلك أظن أني وأنا أتكلم عن هذه المدن التي لا أعرفها ولا تعنيني بالقدر نفسه – وكل كلامي مقارنات ومواءمات على أي حال – كنت أتكلم بشكل ملتوٍ عن القاهرة أيضاً... إلى أن واجهتها ورضخت لبعض معطيات الشكل الروائي في «الطغرى».
كتبت عن أكثر من مكان، كيف ترى «المكان» وموقعه في الأدب جغرافياً أو سياسياً أو ثقافياً؟
أعتقد أن الأدب كله في النهاية يتحدث عن أحد شيئين: إما المكان أو الزمن. الأدب يتحدث عن الوضع الإنساني وعن الحب والموت طبعاً، لكنه يفعل ذلك عبر أحد شيئين. أعتقد أنّ «الطغرى» مثلاً كتابة مكان، لكن التماسيح كتابة زمن. وربما يكون هذا ميلي الروائي عموماً. كتابتي لا يعنيها المحيط الاجتماعي والثقافي بقدر ما تعنيها خبرة مرور الوقت على المستوىين اللحظي والتاريخي وما تفعله هذه الخبرة في الوعي. ماذا يعني أن يكون الواحد موجوداً في لحظة معينة، ثم موجوداً في لحظة أخرى؟ أين كيانه أو حقيقته من اللحظتين؟ وحين نتكلم عن إنسان أو شخصية، هل نتكلم عن شيء غير هذه اللحظات ونقيم خارجها أم أننا نتكلم عما يتكوّن نتيجة اختلاطِ بعضها ببعض؟
رجوعاً إلى اللغة، لماذا تكتب باللغة الإنكليزية؟ هل هي نوع من الخروج العنيف عن المصرية التي تسكنك؟
ـــ جزء كبير من عملي في الصحافة الثقافية وحولها كان دائماً بالإنكليزية. كان تعليمي كله والجزء الأكبر من قراءتي بالإنكليزية. ولم يكن عندي موقف ضد الكتابة الأدبية بها، إلى جانب العربية. عندما توافرت مساحة لفعل ذلك فعلته، وعندما شعرت أني جاهز نفسياً، غامرت بإنجاز رواية كبيرة أحاول أن أنشرها الآن. لا يمكن الخروج على «مصريتي»، لكن الإنكليزية – إنكليزيتي على الأقل – جزء جوهري من هذه المصرية. لا أحسها ضد هويتي أو في مواجهة معها بأي شكل. عموماً أنا في صدد كتابة ورقة عن هذا الموضوع سأتعامل معه فيها من منظور ما بعد استعماري، أقصد أني سأطرح سؤال الثقافة السائدة في العالم ولغتها وعلاقة ابن ثقافة مندثرة بها أو مكانه منها. لذلك فالسؤال مطروح فعلاً على أكثر من صعيد.
حدّثنا عن الرواية التي كتبتها باللغة الإنكليزية، وإلى أين مصيرها حالياً؟
ــــ لا أعرف ماذا سيكون مصير روايتي الأولى (وربما الوحيدة) بالإنكليزية. لديّ وكيل أدبي في كندا يسعى إلى بيعها، وقد أرسلتها إلى عدد من الأصدقاء في أنحاء العالم. ربما يستغرق إيجاد ناشر مناسب وقتاً طويلاً، وربما أفكر في حلول بديلة أو أقرر أن أبقيها مخطوطة في حوزة عدد محدود من الناس. فعلاً لا أدري، وليس الأمر في يدي. ولا أظن له علاقة بجودتها من الناحية الأدبية. الذي أريد أن أقوله في هذا السياق أني أُحبطتُ في الأوساط الأدبية الأميركية والبريطانية، حيث أيديولوجيا الهوية المقهورة تسيطر على كل شيء. كنت أظن أني سأجد هناك مزيداً من الحرية والتنوع وقد يكون هذا حقيقياً على السطح بشكل ما، لكن الواقع أن سطوة البيع والشراء من جهة والتعامل مع الأدب باعتباره مادة دعائية لقضايا هوياتية ضيقة إن لم تكن استهلاكية من جهة أخرى، قد أديا إلى اقتصار المجال على أنماط كتابة بعينها. هناك استثناءات ولكنها قليلة ومعظمها يعود إلى أزمنة سابقة. والأجواء تبدو لي استغلالية ووصولية إلى أبعد حد. لا أريد أن أتكلم عن محتوى الرواية أو أخوض في شكلها، لكنها من وجهة نظر امرأة من عمر أمي، وهي مهداة إلى أمي. وتتعامل مع الربيع العربي وتاريخ مصر الحديث من خلال حياة هذه المرأة في فترتين زمنيتين هما ١٩٥٦-١٩٨٩ و٢٠١١-٢٠١٥ في القاهرة. لم أستطع أن أكتب من وجهة نظر امرأة حتى قررت أن أخوض تجربة كتابة رواية كاملة بالإنكليزية وأنا أفكر في حياة أمي.
احكِ لنا عن كتاب «برا وزمان»؟ كيف يشمل كتاباً عن فيلم معاني الوطنية، والحزن، والجمال البصري، والإنتروبيا السياسية، والاستعمار والجنس؟
ـــ طلب إلي صديقي نزار أندري الذي يحرر سلسلة من الكتب القصيرة عن السينما العربية أن أكتب عن «مومياء» شادي عبد السلام. نزار أستاذ جامعة والسلسلة مشروع أكاديمي. لكنه يعرفني ولم ينتظر مني إلا نصاً أدبياً. وفيلم «المومياء» طبعاً شيء أساسي في وعيي وتكويني أياً كان إحساسي به الآن. لكن الأهم أنه يطرح أسئلة عميقة وكثيرة عن معنى أن يكون الواحد مصرياً في العصر الحديث. لذلك استعملت صيغة الفقرات المرقّمة كما في رواية «التماسيح». كل فقرة نص قائم بذاته بدرجة ما، لكنه يتفاعل مع بقية النصوص ويرد عليها ويضيئها. ويمكن أن يكون عن أي شيء يثيره الفيلم أو عن مشهد من المشاهد أو مصدره أو مدلوله. هكذا لم أكتب عن الفيلم بقدر ما كتبت حوله. وأوّلت أحداثه فعلياً ومجازياً بالرجوع إلى أسئلة الهوية والتاريخ بما في ذلك الاستعمار والانتماء الثقافي ومعنى الوطنية واليتم الحضاري. أدخلتُ في الموضوع حكايات شخصية ذات صلة أيضاً. أن تجتمع أشياء متشعّبة ومختلفة لتناقش موضوع: كان هذا هو جمال المشروع.
في مقدمة الكتاب استخدم نزار أندري تعبير Mummification of Yousef Rakha ، هل تعد هذا التعبير جزءاً من فكرتك حول الاتصال مع التراث وانشغالك بفكرة التأثير والخلود؟
ــــ أعتقد أنّ التحنيط مجاز مناسب فعلاً. في الكتاب قرب النهاية كلام عن طقس فتح الفم، وهو طقس من طقوس التحنيط. إنه الطقس الذي يمنح الميت القدرة على الكلام في الحياة الأخرى. الفكرة كانت أن مشاهدة «المومياء» بهذه الطريقة طقس سمح لي بالكلام، البوح بأشياء عميقة وفارقة عن هويتي ومكاني من العالم وإنسانيتي أو الإنسانية.
هل حرّك هذا الكتاب سؤالك حول الزمن؟ وكيف ترى الزمن؟
ـــ هناك نظرية أن الزمن خدعة، مجرد آلية بيولوجية تساعد الثدييات على التعامل. لكن الزمن موضوع مهم جداً بالنسبة إليّ. ليس كمساحة أتطلع إليها ولكن كخبرة متغيرة وسحرية يمكن التعبير عنها بالكلام. ماذا يعني أن نكون في الزمن: أظن أن هذه هي تيمتي الكبرى ككاتب.
هل تعتقد أنّ «المومياء» فيلم ديني؟
ـــ لا أعتقد أنّ «المومياء» فيلم ديني لكن أظن أن أسئلة الوجود تتقاطع مع الأسئلة الغيبية على تنوعها، وبهذا المعنى يمكن القول إن «المومياء» هو فعلاً عمل رؤيوي. هذا أحد جوانب تفاعلي معه في هذا النص على أي حال، ليس فقط من خلال ما يطرحه من عقائد مصرية قديمة ولكن أيضاً نتيجة هوس شادي عبد السلام بفكرة الهوية المصرية كشيء قادر على تجاوز اللغة والزمن، شيء خارج التاريخ وأقوى منه. أنا لا أؤمن بهذه الفكرة لكني تفاعلتُ معها.
لماذا استخدمت «المومياء» مدخلاً لكتابة سيرة شخصية موازية؟
ـــ لم أكتب سيرة شخصية فقط. كتبت سيرة وتاريخاً وبحثاً ونقداً من داخل خبرة مشاهدة الفيلم. أظنّ «المومياء» مدخلاً رائعاً للكتابة عن «المصرية» التي ذُكرت في سياق المتنبي. لكن ليس للأمر صلة مباشرة بعلاقتي بالسينما.
هل كتاب شادي عبد السلام رحلة خضتها لكشف علاقتك المركبة مع السينما؟
ـــــ ليس مع السينما عموماً ولكن مع هذا الفيلم.
كيف هي علاقتك بالسينما كوسيط فني؟
ــــ أنا لست مهووساً بالسينما، لست cinephile مثل مصطفى ذكري مثلاً أو بعض الأصدقاء الذين لا يمضون يومين من دون أن يشاهدوا فيلماً واحداً على الأقل، ويتحمسون للأحداث والأخبار السينمائية مثل مشجّعي كرة القدم. لكن السينما شيء أساسي في حياتي وفهمي للحياة ومعمار الحكي والجمال. لا يمكن إنكار ذلك. أتمنى أن أتعاون مع مخرجين لإنجاز أفلام وأحياناً أحلم بالإخراج أيضاً وإن كان ذلك صعباً من الناحية العملية. الآن هناك محاولة تعاون مع مخرج شاب فعلاً. فالسينما حاضرة دائماً بصرياً وسردياً، وهي حاضرة – حتى في أسوأ حالاتها – بشكل إيجابي يدفع إلى التفكير النقدي ويحرّض على الإبداع والتفرّد. أظن أن هذا عكس السوشال ميديا تماماً. إذا كانت السوشال ميديا وهماً، فالسينما خيال. الفرق كبير. في السوشال ميديا، عقلية القطيع والتفكير الأحادي والهوس برد الفعل اللحظي المباشر. أما في فيلم يشاهده الفرد ويربطه بأشياء تهمه، فيمكن أن يكون هناك نص أدبي كامل.
المتنبّي بالنسبة إليّ، يكاد يكون عكس إحياء التراث. كل الفكرة في التماهي معه من مكاني هنا الآن، واختبار تصوري أنه فعلاً صالح لذلك
حدّثنا عن تجربة هجر الفايسبوك، ما فلسفتك؟
ـــ كانت عندي تجربة طويلة نوعاً ما مع فايسبوك، وقد توازت مع انخراطي في احتجاجات ٢٠١١ من ناحية وفي دوائر المثقفين المصرية من ناحية ثانية. كان فايسبوك هو الملتقى والمقر، وكان يؤدي دوراً فعّالاً في اتصال الناس بعضهم ببعض. لكن الحقيقة أنه، وبالنظر إلى ما أسفرت عنه الاحتجاجات وتعامل المثقفين معه، تبين لي بسرعة زيف ولا جدوى هذه التفاعلات. خلال سنتين أو ثلاث، رأيت الفضاء الافتراضي يتحول من مساحة اتصال وتفاعل مفتوحة على آفاق واحتمالات واسعة وبعيدة إلى سجن ذهني يعكس كل حدود ومشاكل ومظالم الواقع، وشعرتُ بغربة مؤلمة حقيقة عن محيطي. لا شك في أن الثورة أبرزت كل ذلك وبمعنى ما استعرضته، لكن الذي اكتشفته أيضاً أن الثورة أو هزيمتها لم تكن سببه بقدر ما كانت نتيجته.
ربما للمرة الأولى منذ سنة ٢٠٠٥، حين رجعت إلى الكتابة بعد انقطاع ست سنين، أدركت أني لست طرفاً في أي وسط أو تجمع، لأنه بات واضحاً أن هذه الأوساط والتجمعات لا تحمل أملاً في أي تغيير حقيقي. بات عندي فهم مختلف قليلاً لفكرة التحقق، وشعرتُ أنني وإن كنت منزعجاً من السياق العام أو محبطاً في ردود الفعل، عليّ أن أتذكر دائماً أن الكتابة مجرد تفاعل فردي وحوار بين النصوص واستمتاع باللغة وما يمكن أن تصنعه. كان البعد عن فايسبوك ضرورياً لإدراك ذلك، فضلاً عن كون ذلك أراح أعصابي فعلاً ووفّر لي وقتاً وجهداً مهدرين وساعد في أن أرى الواقع ومكاني منه بصورة أوضح.
حدّثنا عن تجربة مدونة «ختم السلطان»؟
ـــ في الفترة نفسها التي هجرت فيها الفايسبوك، حوّلت مدونتي الشخصية إلى مساحة جماعية غير ملزِمة أصبحت مكاناً حيوياً لنشر الأدب. أدركت أن الواحد عندما يقدّم نصوصاً مكتوبة بتأنّ ومراجعة ومطروحة كمادة للقراءة في الفضاء العام وليس للدعاية والتلاسن في فضاء ملتبس دائماً بين العام والخاص، ففي ذلك حد أدنى من احترام الغير ودفعه في اتجاه حوار حقيقي أجدى وأبقى بكثير مما يحدث على فايسبوك.
أحبطتُ في النشر من الأوساط الأدبية الأميركية والبريطانية حيث أيديولوجيا الهوية المقهورة تسيطر على كل شيء
وما هي تجربتك مع الورش الأدبية؟ ما أهم منجز تخرج منه مع تفاعلك مع جيل آخر؟
ـــ أدير ورش الكتابة بالروح والسياق نفسيهما. أملي أن تتوافر مساحة تفاعل وحوار غير محكومة بالأهواء الشخصية والولاءات القسرية التي تُفرض على الناس. وهذا أهم ما أستفيده من اللقاء المنتظم بكتّاب آخرين ليسوا دائماً أصغر سناً ولا أقل خبرة، ولكنهم في حالة تسمح بعرض أعمالهم على آخرين بهدف الذهاب بها إلى مكان أبعد: أني أشعر بوجود فضاء حيوي وصادق لإنتاج وتداول الأدب بنزاهة تامة وبلا أوهام داخل الواقع الفعلي.
تحب الكتابة خارج التصنيفات، كيف ترى الإنجاز المصري الأدبي حالياً؟
ــ هذا سؤال كبير وردّي الصادق أني لا أعرف. هناك أشياء جميلة غير محتفى بها إجمالاً. أذكر على سبيل المثال شعر مهاب نصر وأحمد يماني. وهناك حركة حقيقية منفتحة على العالم تتخلّق عبر مواقع مثل «ختم السلطان» ومبادرات شبيهة. لكن ماذا يعني كل هذا وبمَ يبشّر؟ سياسياً واجتماعياً وثقافياً، يظل الواقع أردأ من أن يكون للأدب صدى في أرجائه. وهذا صحيح أينما ذهب الواحد في العالم اليوم. لذلك أعتقد أن المنجز الحقيقي سيكون في تكوين ودعم مساحات قراءة وحوار غير مشروطة بأي شكل، والبعد بهذه المساحات قدر الإمكان عن المنطق الاستهلاكي ومصارع الرأسمالية.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا


