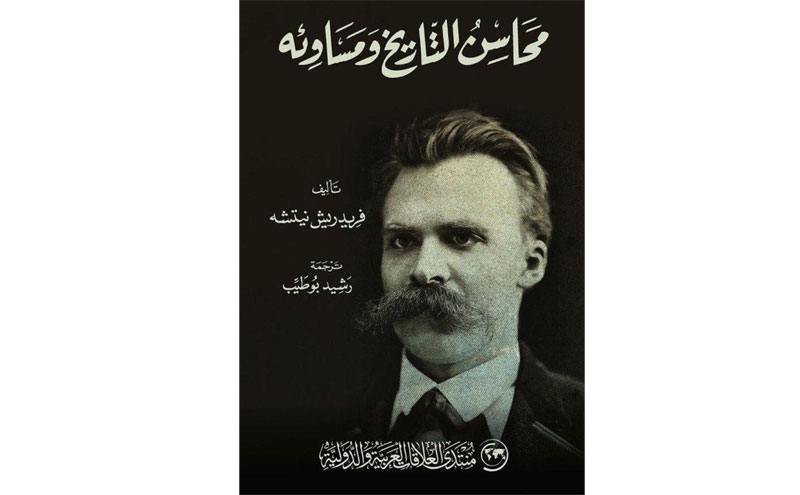لاحظ نيتشه أن مُفكري ونُخبَ وسياسيي عصره سقطوا «صرعى مرض التاريخ» وأنّ إقبالهم على دفن رؤوسهم في التاريخ، ما هو إلّا أمارة تراخي وتأخر وضعف. فهؤلاء صاروا لا يقتدرون على مقاربة ظاهرة ما إلا وفي يدهم عصا العلم التاريخي، ما يحوّل كلّ معرفة حاضرة حيّة ونضرة إلى معرفة تاريخية ذاوية ذابلة. فالإفراط في الإقبال على التاريخ، أو تعظيم دوره بشكل مبالغ يجعل الحياة تذوي وتأفل. كما أن مِن شأن تُخمة التاريخ أن تقتل الإنسان. وعلى النخب الفكرية والسياسية أن تعيد التفكير في شعار المسيح: دع الموتى يدفنون موتاهم واتبعني، ولا يغيروا الشعار إلى: دع الموتى يدفنون الأحياء.
في نظر نيتشه، نعم نحن نحتاج لتاريخ، لكننا نحتاج إليه بشكل مختلف عن المتسكّع الخامل في حديقة العلم، بغض النظر عن الاحتقار الذي ينظر به مِن عليائه إلى ضروراتنا وحاجاتنا. إن هذا يعني أننا نحتاج إلى التاريخ للحياة والعمل، وليس لكي نولي ظهرنا في ارتياح لهما، أو لكي نزين الحياة الأنانية والفعل الجبان والسيئ. فنحن نريد أن نتعلم التاريخ بقدر ما يخدم التاريخ الحياة. لكن للأسف طريقتنا لممارسة التاريخ وتقويمه، تدفع بحياتنا إلى الجفاف والانحطاط، وتجعل صوت أحد المتجمّعين حول الرئيس الفرنسي ماكرون أخيراً في بيروت يقول: «ببوس إجرك انتدبنا». إنها ظاهرة يتوجّب معرفتها عبر دراسة طبيعة القراءات التاريخية الخاصة بزمننا.
خضع صاحب الصوت والداعي لعودة الانتداب ـــ بوعي أو بدون وعي ـــ لما أسماه نيتشه «التاريخ الأيقوني»، وهو تاريخ يجعل من الماضي صورة أيقونية، تدفع النخب إلى إخراج انحطاط الماضي من طي النسيان، وإعادة تقديمه ليصير حدثاً خالداً، وإقامة تأبين جنائزي عظيم للتاريخ الماضي، من دون أن تعي أنها تدفن الحاضر من دون إيجاد حلول له. وذلك إن نمّ عن أمر، فإنّما ينمّ عن نزوع إلى الهرب من الذات، ونكوص عن إيجاد مثال، أي السعي نحو شأن أفضل. ففي هذا الوعد التاريخي المهزوم، يبرّر الجيل الضائع انكساره بالبحث عن كيفية حدوث الأشياء وتجلية أسبابها. وتلك العلة لتبرير الجبرية والإيمان بالحتمية وجعلها أمراً ممكناً، مهدئ مبرّر لكراهية الذات. فإن تجاوز الإنسان لتاريخ ما، يجعله يظن أن ما مضى كان على أحسن حال.
الأحكام التاريخية المطلقة بتقدم عصر (الانتداب مثلاً) وتدهور عصر (اتفاق الطائف مثلاً) تتجاهل فجائع الماضي
ما سبق هو ما يجعل التخمة التاريخية أمراً رذلاً، منها أنّ استبداد التاريخ على عقول الجماهير التي تُعاني من مشكلات، يجعلها في معاداة مع الحياة. بل يجعل الناس يلحقون الضرر بمستقبلهم بل اجتثاثه، فالإقبال على الماضي يقوم على التفريط بالمستقبل. فالأحكام التاريخية المطلقة بتقدم عصر (الانتداب مثلاً) وتدهور عصر (اتفاق الطائف مثلاً) تتوقف في الأساس على هفوات وتتجاهل فجائع الماضي.
يظهر نيتشه خطورة الإفراط في استهلاك الدراسات التاريخية، ويحدد مخاطر القراءات التاريخية التقليدية في خمسة جوانب: أولاً فهي معادية للحياة، أي تخلق تعارضاً بين الحياة الداخلية للفرد والعالم الخارجي، ثانياً، تعدّ عاملاً مسؤولاً عن إضعاف الشخصية، ثالثاً والأهم تخلق الوهم حول الماضي بصفته حاملاً للفضيلة أكثر من الحاضر. رابعاً يقلق الزخم التاريخي غرائز الشعوب، ويحُول دون بلوغ الفرد والمجتمع رشدهما. وخامساً تنمو روح الكلبية في المجتمع، وهي مزاج خطير يتمثّل في السخرية من الذات ويشلّ قوى الحياة ويدمّرها في النهاية.
لا يكتفي نيتشه بهدم فلسفة التاريخ التقليدية، إنما يعيد طرح تصوّر جديد خاص به، يطلق عليه «تاريخ الإنسان». وهذا لا يعني أن عاد إلى التاريخ مرة أخرى، لكنه أسس فلسفة تاريخية سلبية أو مضادة تسهم في بناء تاريخ إيجابي.
ورغم أنّ نيتشه شكا مرض تخمة التاريخ الذي أصاب معاصريه ورفض الإقبال المفرط على الدراسات التاريخية، إلا أنه لم يتخلّ عن فوائد الحس التاريخي ومزاياه والإقرار بمدى أهمية التاريخ للحياة. فما يميز الإنسان عن غيره هو الطريقة التي يوظف بها التاريخ: إذا كان ذلك من أجل خدمة الحياة، فهذا هو المسار السليم. أما إذا كان ذلك لعبادة الماضي، فهو مسار مميت. كما ركز نيتشه على عنصرين: عنصر تاريخي وعنصر لاتاريخي، وكلاهما ضروريان مِن أجل الحفاظ على صحّة الفرد والشعب والحضارة. كما قام نيتشه بتبجيل عنصر اللا تاريخي، لكننا سنركز على العنصر الأول أكثر، حيث نصح نيتشه بضرورة معالجة الماضي بين حين وآخر أو بمعنى آخر أن يذيب الإنسان جزءاً من صنمية ماضيه، عبر محاكمة هذا الماضي باسم الحياة ومساءلته بشكل قاسٍ بل إدانته. ومن ثم نصير في حاجة لدفن الماضي ونسيانه وتجاهله، والنسيان أمر جلل، فهو يوفر السعادة التي تعدم الأفق التاريخي، ولا يجعل الإنسان يتحول إلى حفار قبور للحاضر. وإنما يصبح الإنسان فرداً ينمو ويتفتح ويتطوّر ويداوي جراحه ويصلح ما أفسده ويعوّض خسائره مسيطراً على الماضي لا العكس.
وللسيطرة على الماضي وعلى ملكة التاريخ، يشير نيتشه إلى ضرورة التزام الإنسان بالمبدأ التالي: أن يصير العلم التاريخي بالشيء يعني أن يعيش الإنسان من جديد، لا بما هو معرفة ميتة (عصر الانتداب الفرنسي مثلاً) وإنما بما هو حياة قائمة (إدراك الأزمة السياسية والإنسانية الراهنة في لبنان مثلاً)، فلا طريق يقود من مفهوم الشيء إلى ماهيته إلا التوحّد معه، ولا يمكن الحكم أو التعلّم من تجربة مريرة إلا بعد أن نعيشها بشكل كامل، ونساوي بين جميع أطرافها ونوحد ونتوحّد معها. ومعنى التوحد النيتشوي ليس التمثل به أو الاقتداء إنما الإخضاع للمسألة والإملاء حسب حاجة الإنسان في الوقت الحاضر.
يتوجب إذن على الجميع أن يتّضح له وجود شيء ما أولاً ـــ فساد، انتداب، ..إلخ ـــ وإذا نظرنا نقدياً إلى الماضي لهذا الفعل، سنقطعه من جذوره، لا أن نقوم بتقديسه. وكلا الأمرين في نظر نيتشه شديدا الخطورة، فنحن كبشر في الحاضر نمثل حصيلة الأجيال السابقة، وذلك يعني أننا في الآن نفسه نتيجة لانحرافات هذه الأجيال ورغباتها وأخطائها بل لجرائمها، ويصعب علينا التحرّر كلياً من هذا الإرث. وحتى إذا حكمنا على تلك الانحرافات واعتبرناها لاغية، فإننا لا نُلغي عبر ذلك حقيقة أننا ننحدر منها، بل في أحسن الأحوال نصل إلى صراع بين طبيعتنا المتوارثة ومعرفتنا المكتسبة. ولربما أدّى الصراع بين الطبيعي والمكتسب إلى عادات وغرائز جديدة وطبيعة ثانية تدفع الطبيعة الأولى إلى الاندثار.
لذا، إن محاولة البعض اختيار ماضٍ ومحاولة الانتساب إليه بشكل بعدي ـــ ضداً على الماضي الذي ينحدرون منه ــــ هي محاولة يتربص بها الخطر دوماً لأنه يصعب تعيين حدود في عملية نفي الماضي أو إعادة سرده على هوانا. وفي أغلب الأحيان لا تتجاوز معرفتنا بما هو جيد لنا لكي نحققه أو ما نقدر على القيام به وما لا نقدر. لذا تظهر حاجتنا كبشر وكشعوب لحساب الأهداف التي نرسمها مِن أجل قوتنا ومن أجل معرفة دقيقة بالماضي، سواء كانت تلك الأهداف متعلقة بالتاريخ الأيقوني أو التقليدي أو النقدي، فهي لا تحتاج مجموعة من النخب والمفكرين أصحاب الأفكار المحضة الذين يكتفون بالتفرج على الحياة، بل تحتاج إلى أناس يستهدفون خلق حياة جديدة مِن ركام التاريخ. تلك هي العلاقة الطبيعية لحقبة ولحضارة ولشعب بالتاريخ. علاقة تنظمها الحاجات وتسيطر عليها القوة الكامنة بداخلها. إننا لا نرغب في معرفة الماضي أو العودة لعصور خلت إلا لخدمة الحاضر. وتنعدم رغبتنا في التاريخ حين يضعف حياتنا ويؤدي إلى اقتلاع مستقبلنا. وهذا بسيط وبديهي مثل الحقيقة، ومقنع بشكل مباشر، ولا نحتاج أن نقدم له استدلالاً تاريخياً يبين فداحة الانتداب ووحشية الماضي.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا