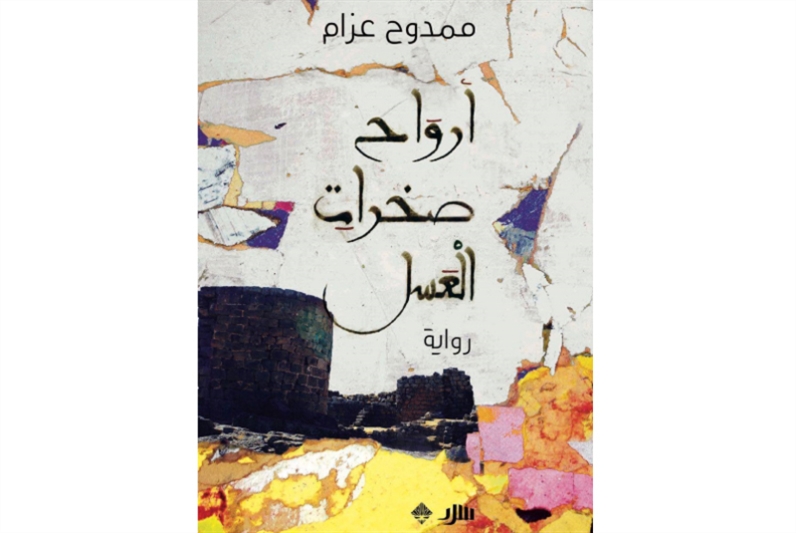رواية سياسية تكاد تخلو من الحديث السياسي الصريح
يوكل كلّ من نائل وأحمد إلى الراوي سرد حكاية بدأت بنبوءة موت عابد بالقرب من شجرة اللوز عند صخرات العسل. ثم بعد ثماني سنوات يموت رفيقاه قبل موتهِ، بعدما اجتازوا طفولة شقية، ومراهقة أظهرت أولى الاختلافات بينهم، ثُمّ صاروا روحاً متماسكة تتقاسمها أجسادهم. لقد عملوا سوياً، عرفوا نجاحات وانكسارات عاطفية ومهنية. يعيد عزام للأفكار دورها في صناعة مستقبل الشخصيات بالقدر الذي يتيح للخيال إثراء عالمهم. في لحظات الحب تؤدى أدوارٌ بارعة بفطرية وتلقائية تحكم هذا النص الذي يجيء بفكر خاص بهِ، إنّه فكر العاطفة. ويندرج في باب هذا الفكر؛ خروج عابد للبحث عن الصخري، وهو أب بديل عن أبيه، وانتماؤهُ بالكامل إلى حليمة بدلاً عن أمّه، حليمة التي «تنتمي إلى سلالة نساء لا يمكن أن تنحي هاماتهن». وتعمّد عابد ألا ينظر إلى عيني هند كي لا يحبها أكثر، لقد خاض حبهما إرث العائلات وخلافاتها. لقد جعل فكر العاطفة الذي يسري في أرواح الشبان الثلاثة منهم شخصية واحدة تتنوع أدوارها وتتناغم في وظيفة أرادها عزام وظيفة جماليّة ومتكاملة، كما لو أنّ غاية محددة تقف وراء السرد برمتهِ، وهي تقديم نموذج يُخضِع فيهِ القوة إلى حسابات الرفق، والحقد إلى أواصر الذكريات، فيما تنهض الصداقة قيمة عليا، يدفع بها عزام لتقابل الوحدة والضعف. يرى الواشي كسراً في الكيان الإنساني، وتظهر المشكلة في وجود الجبن لا في غياب الشجاعة. ربما ما يمثله عابد، بخروجه للبحث عن أبيه الواقعي محسن، وسعيه البحث عن القتيل لا عن القاتل، وحضور قوتهِ نقيض العنف لا قرينة لهُ، ورفضه المشاركة في الحرب، (استُدعي رفيقاه للخدمة فيها)، كان تجسيداً مثالياً لتلك الغاية. لقد صنع من عابد نموذجاً لمُخلّصْ، يُفهَم في نص ممدوح عزام خياراً سياسياً وإنسانياً حرص الروائي السوري على إظهارهِ بقالب أدبي رصين ومحكم، لا يركن سوى لشرط الأدب، بل ينتعش ضمن هذا الشرط فقط. لا يفاجئ القارئ بمصير الصداقة الواحد، عندما تعرض عابد للخطر، اندفعا إليه، وقد شعر خالد أنّ شيئاً سرياً وعنيفاً هزّه بينما شعر حامد أن أذنه قد صاحت. يحتشد النص الثري بلحظات درامية فارقة بدت جزءاً من هوية السرد. تحضر المدرسة معادلاً للخوف والرهبة والقمع، يتركون المدرسة التي تضجّ بروح الكراهية الحزبية، ثم يعودون للدراسة من أجل الحب. إذ يقف حامد وعابد إلى جوار صديقهما خالد المغرم بهيفاء الكافي. ومن خلال حكاية هيفاء وخالد، يخبرنا عزام عن الطريقة التي يغيرنا فيها الحب، ليكون لوناً في حياة نُزعَت ألوانها، عندما يجلس خالد بالقرب من الحظيرة، ويردد «هذا مطرحي مع الحمير» بعدما نبّهته هيفاء إلى أنّ قصة شقيقته، وسلوكهم معها، هي أسوأ قصة تسمعها في حياتها. يظهر الحب ليصلح سلوكاً خَرِباً وكلمات الحب التي يتبادلها كلّ من خالد وهيفاء أمام حامد وعابد هي كلمات تهزّ وجدانهما، وهما ينتظرانها عند المدرسة الثانوية، تساعدهما هذه اللحظات على الشفاء من القمع وآثاره.
يرصد عزام أنفساً ضائعة في بلاد موحشة تضيع الآباء والأبناء، الموت فيها واجبٌ، إلا أنّه يتحدث عن الموت والحرب، بينما تنّكب هند على كتابة 130 رسالة حب إلى عابد، تذكر فيها الحب مرة واحدة، فيما تحاول أن تجعله يرى عبر الكتابة إليه المرأة التي ينتظرها. لقد أضاء ممدوح عزام باستخدام الحب المكلوم عتمة القتال والموت.