في نيسان من عام 1990، كان وفدٌ سياسي/عسكري سوفياتي يرجع من إحدى جولات التفاوض مع الأميركيين، والتي أفضت إلى توحيد ألمانيا وضمّها للـ«ناتو» وانسحاب الجيش السوفياتي من وسط أوروبا وتقليص ترسانته النووية. في الطائرة، في طريق العودة إلى موسكو، ظلّ المارشال أخرومييف مطرقاً وواجماً، حتّى نطق أخيراً بنزق: «على طول سبعين سنة، كان الأميركيون يحاولون تدمير اتّحادنا (السوفياتي)، وها هم قد وصلوا أخيراً إلى مبتغاهم»، فردّ نائب وزير الخارجية شيفرنادزه الذي كان بجانبه: «هم لم يدمّروه، لقد فعلنا ذلك بأنفسنا».
هذه من الروايات الكثيرة التي تجدها في كتاب فلاديسلاف زوبوك الجديد، «الانهيار»، الذي يفصّل تلك الفترة الحاسمة والمتسارعة التي انتهت بسقوط الاتحاد السوفياتي. فترة 1989-1991 التي لم يتمكّن أغلب الناس والباحثين من استيعاب أحداثها، فاكتفى الكثيرون بتعبيرٍ عن الدهشة «عملاقٌ وانهار فجأة»، أو اعتبار الحدث لا يحتاج إلى تحليل، بل هو النتيجة الحتمية لنظامٍ شيوعي «مخالف للطبيعة». على الهامش: اعتبار أن النظام الاشتراكي معادٍ للطبيعة والفطرة، في حين أنّ الراسمالية الصناعية تتماشى مع «جوهر الانسان» يبدو افتراضاً مضحكاً بالمعنى الفلسفي ولكن، كما سنرى لاحقاً، فإنّ الانتصار الايديولوجي الفعلي للرأسمالية في تلك المرحلة تمثّل في شيوع مثل هذه القناعات وتحوّلها إلى حقيقة، حتى في قلب موسكو والحزب الشيوعي. كما يقول زوبوك عن فترة 89-91، فإنّ فكرة الأسواق المفتوحة والليبرالية الاقتصادية بين النخب السوفياتية والصحافيين والمثقفين لم يكن ينظر إليها كموقف إيديولوجي بل على أنّها، ببساطة، «المنطق السليم».
كتاب زوبوك طويلٌ نسبياً (قرابة الـ700 صفحة مع الهوامش)، ولكنّه أوّل عملٍ بحثي يعطيك صورةً متكاملة، يوماً بيوم، لعملية الانهيار السوفياتي. هناك أعمالٌ أخرى تتناول جوانب محددة من العملية (الاقتصاد مثلاً، أو انفصال القوميات) ولكنك تجد عملاً يضع كلّ هذه العوامل في إطار موحّد، ويدرس تفاعلها مع بعضها البعض، ليصنع سردية موحّدة عن مسيرة الانهيار العظيم. الطريف هو أن زوبوك يعترف أنه كان في شبابه روسياً ليبرالياً من أشدّ المؤيّدين للبريسترويكا وغورباتشوف، بل كان في فترة الانهيار يعمل في موسكو مرشداً ومترجماً للصحافيين الغربيين الذين ينقلون، بحماسة، «الثورة الديموقراطية» في روسيا. ولكنّ رأي المؤلّف ببطله السابق قد تغيّر جذريّاً وانقلب منذ بدأ العمل على هذا الكتاب والتقليب في المصادر والأرشيفات.
الخلاصة الأساسية التي يتوصّل إليها زوبوك، من خلف كلّ السّرد، هي أنّ كل التفسيرات التي راجت عن سقوط الاتحاد السوفياتي وفشل البريسترويكا (أنّ غورباتشوف واجه بيروقراطية شيوعية عنيدة قاومت إصلاحاته، أنّ الإصلاحات لم تكن كافية، أو أنّ الاتحاد السوفياتي كان قد وصل إلى مرحلة الاهتراء ولا إصلاحات ستنفعه أو تمنع سقوطه) هي كلّها غير صحيحة. حين استلم غورباتشوف المكتب الكبير في الكرملين عام 1985 لم يكن شيءٌ من ذلك حتمياً، كانت هناك أزمة وجمود ولكن لا بوادر انهيار، وكان غورباتشوف يمتلك سلطة ديكتاتورية أورثها إياه نظام ستالين، كان في وسعه أن يستخدمها كما يشاء. جوهر الموضوع، في رأي زوبوك، هو شخص غورباتشوف وسياساته. لا يمكن فهم ما حصل من غير أن تكون السردية متمحورة حول دور غورباتشوف. ذاك السياسي الحزبي (أباراتشيك) الذي جاء من إقليمٍ زراعي ومن منبتٍ فقير، وارتفع في صفوف الحزب حتى أصبح الابن المدلل لأندروبوف ووريثه. تضافرت رعاية أندروبوف والظروف (كموت أغلب رجالات الجيل القديم، جيل الحرب العالمية الثانية، مع رحيل تشرنينكو) لجعله مرشّح اجماعٍ لقيادة الحزب الشيوعي السوفياتي، والجميع في الحزب واللجنة المركزية وعموم الشعب متحمّسٌ لمجيء هذا الإصلاحي الشاب وينتظر بتشوّقٍ ما سيفعل.
كانت الهزيمة إيديولوجية وعقائدية في الأساس. لجأ غورباتشوف إلى لينين للهرب من إرث الستالينية ولكنّه، كأسلافه، لم يتمكّن من ابتداع معنى جديد لـ«جمهورية العمّال الثورية»
تكلّمنا في السابق عن السياسات الاقتصادية لغورباتشوف ونتائجها الكارثية (عبر كريس ميللر وغيره)، وزوبوك يؤكّد بالفعل أن اقتصاد الاتحاد السوفياتي (ومعه مستوى حياة الناس، الامتحان الأساس أمام غورباتشوف) كان قد تم تخريبه وقضي الأمر مع «إصلاحات» عام 1987-1988، وكانت الأزمة في طريقها إلى التجذّر والاستفحال، والتحوّل من مشكلة ركودٍ وجمود إلى إعصارٍ مدمّر وشلل كامل. ما تبقّى بعد ذلك كان «حصر الأضرار»، وهنا ربّما كان فشل غورباتشوف العظيم؛ بمعنى أنّه، ولو ترنّح الاتحاد السوفياتي، ولو «خسر» شرق أوروبا، إلا أنّه لم يكن من الحتمي له أن يسقط ويتفكّك؛ وإن سقط، فقد كان من الممكن إنقاذه على صورة دولة فيدرالية مركزية، وإن لم يكن ذلك متاحاً، فقد كان محتملاً أن تنقذ بنى الدولة والمؤسسات والاقتصاد؛ إلّا أن إدارة غورباتشوف للموقف قد ضمنت، عند كلّ مفصل، أن يصل بلده دوماً إلى الاحتمال الأسوأ (قد يكون «الانجاز» الوحيد الذي يمكن للرجل أن ينسبه لنفسه هو أن الاتحاد السوفياتي لم يسقط ضمن سلسلة حروبٍ أهلية تشتعل بين دول نووية، وذاك كان أساساً لأنّ همّ الولايات المتحدة كان في حصر الترسانة السوفياتية والتحكّم بها وبمن يملكها).
«ابن النّظام»
من زاويةٍ ما، يمكن اعتبار غورباتشوف ابناً غير بارٍّ لأندروبوف؛ الرئيس السابق للـ«كي جي بي»، الذي لم تُتَح له قيادة الاتحاد إلا لفترةٍ وجيزة. كان أندروبوف يؤمن بضرورة الاصلاح الجذري للنظام السوفياتي، وقد بنى حوله فريقاً يعتنق الأفكار نفسها، وكان أقربهم إليه غورباتشوف. بل إن الوعي بجمود النظام وضرورة تحديثه كان همّاً حاضراً لدى القيادات السوفياتية منذ أوائل السبعينيات. ما ابتدأه غورباتشوف في أواسط الثمانينيات، يشرح زوبوك، لم يكن ثورةً مفاجئة من الداخل، بل إصلاحاً تمّ تأجيله لعقدٍ ونصف. غير أن نظرة غورباتشوف لمفهوم «الاصلاح» قد تطوّرت بشكلٍ مغايرٍ جذرياً لفلسفة أستاذه. كان أندروبوف ينظر إلى مشاكل الاتحاد السوفياتي على الطريقة الصينية تقريباً: اقتصادك يحتاج إلى تحديثٍ وتكنولوجيا، وهذا يتطلّب دولارات وترتيباً ما مع الاقتصاد الدّولي؛ وأنت يجب أن توجّه مواردك والعملة الصعبة التي تحصّلها لاستيراد التقانة وأدوات الانتاج من الغرب، وليس مواد الاستهلاك والحبوب والطعام. كان أندروبوف يفهم أنّ رفع فعالية الاقتصاد لن يكتمل من غير اصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة الانتاجية، وإدخال آليات تنافسية في الاقتصاد المركزيّ الموجّه (الذي لا تزال الـ«غوزبلان» تدير كلّ تفاصيله، تماماً كما كانت تفعل أيّام ستالين)؛ غير أنّ أندروبوف كان واعياً بالكامل لأنّ إعادة ترتيب المؤسسات والعملية السياسية لا يمكن أن يحصل قبل أن «يشعر الناس بأن مستوى حياتهم يرتفع بفضل الاصلاحات»، كما ينقل المؤلّف عن أندروبوف، وإلّا فأنت تستدعي الكارثة.
أمّا غورباتشوف، بعد نيله الثقة الحزبيّة، فقد انطلق في رحلةٍ نظريّة جذريّة، نقلته من «نيو-لينينيّة» (على حدّ تعبير المؤلّف) تؤمن ببناء «الاشتراكية الديموقراطية» عبر توزيع سلطات المركز على وحداتٍ صغرى تقرّر أمورها بشكلٍ مستقلّ، وصولاً إلى التخلّي عن لينين نفسه في آخر سنواته والرّهان ـــــ اقتصادياً وسياسياً ـــــ على الليبرالية والتعددية الحزبية وبناء السوق الحرّ عبر «علاج الصّدمة». قد تكون المسألة أن غورباتشوف كان مؤمناً إيماناً شبه دينيّ بقدرة «الديموقراطية» و«اللامركزية» على بناء مؤسسات وأسواق بشكلٍ تلقائي (يكفي أن تدمّر المركز حتى تنتعش الأطراف)؛ وقد تكون المسألة ــــ كما يقترح زوبوك ــــ أن الخبرة الوحيدة لغورباتشوف «على الأرض» كانت بين النقابات الزراعية في جنوب روسيا، وهو لا يعرف ببساطة كيفية عمل الاقتصاد الصناعي السوفياتي؛ ولكن الأساس هو أنه، في حالة غورباتشوف، كانت النظرية من الأساس خاطئة والتنفيذ كان أسوأ. حين فصل غورباتشوف وحدات الانتاج السوفياتي عن بعضها البعض وأعطاها صلاحيات تشبه ما تمتلكه الشركات الخاصة (ولكن من دون أكثر مسؤولياتها)، شلّ على الفور اقتصادٌ كان يقوم على الترابط والتكامل؛ والمؤسسات الناجحة لم تستخدم أرباحها للتحديث والتجديد كما توقّع غورباتشوف، بل لزيادة رواتب موظفيها وشراء مواد استهلاكية. أخطر من ذلك، يشرح الكاتب، كان الاتحاد السوفياتي يمتلك منذ أيام ستالين والحرب الكبرى نظاماً مالياً بدائياً، ولكنّه فعّال في التحكّم بالكتلة النقدية: لديك مال «نظري» (بِزنال) هو مجرّد وحدة حسابيّة يستخدم للمحاسبة بين الشركات ولشراء المواد الأولية والبيع بالجملة، ولديك مال «نقدي» (كاش) هو الروبلات التي في جيوب المواطنين وحساباتهم المصرفية. الفكرة هي أنّ الإثنين لا يختلطان، فتظلّ كمية النقد في البلد محصورة عبر رواتب الناس من ناحية والأسعار من ناحية أخرى، فيما الـ«بِنزال» تتحكّم به الميزانية بشكل مركزي. حين سمح غورباتشوف لمؤسسات الدولة بانشاء «تعاونيات» ومصارف تجارية من غير قيود، بل والتعامل مع الغرب مباشرة والاستيراد منه في مرحلة لاحقة، تداخل النظامان وبدأ الـ«بِنزال» بالتحوّل إلى رواتب وروبلات وقروض في جيوب المواطنين. ولّد ذلك، بالترافق مع شلل الانتاج، موجة تضخّم ونقصٍ في السلع عصفت بالاتحاد السوفياتي منذ عام 1988 وحتى أيامه الأخيرة. حين تزداد كمية النقد في جيوب المواطنين، فيما انتاج السّلع ثابت وأسعار أكثرها لم تتغيّر منذ أيام بريجينيف، يصبح لديك «مال كثير يلاحق سلعاً نادرة» بتعبير زوبوك، وهي الحالة التي أوصلت إلى الرفوف الفارغة في المتاجر والطوابير الطويلة أمام أي سلعةٍ متوافرة، والدولة تضطر سنوياً لطباعة عشرات المليارات من الروبلات التي لن يجد المواطنون شيئاً يشترونه بها.
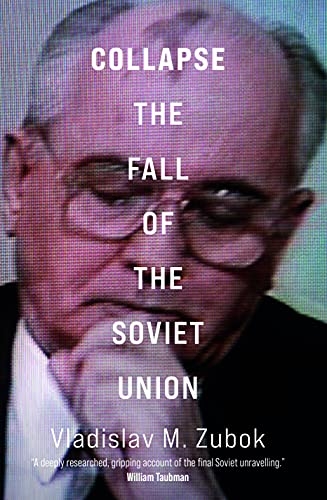
ولكن، قبل التفصيل والسرد الاقتصادي، فقد كانت الهزيمة إيديولوجية وعقائدية في الأساس. لجأ غورباتشوف إلى لينين للهرب من إرث الستالينية ولكنّه، كأسلافه، لم يتمكّن من ابتداع معنى جديد لـ«جمهورية العمّال الثورية». استبدل خروتشيف وعد الشيوعيّة وتخليص البشرية بأن يعد مواطنيه برفع مستوى حياتهم واستهلاكهم وإرخاء قبضة الدولة والمخابرات على المجتمع. أمّا شرعية بريجينيف، فقد استندت هي الأخرى على وعدٍ بأن يتمتّع المواطنون السوفيات، بحلول عام 1988، بـ«أعلى مستوى حياة في العالم». أمّا غورباتشوف، فقد وعدهم بـ«الاشتراكية الديموقراطية»؛ ولكن، كما كتب آلان باديو، فإنك حين تتخلى عن «الفرضية الشيوعية» وتبدأ بمنافسة الغرب الصناعي بمقاييسه هو، فإنّك تدخل لعبةً خاسرة سلفاً. حين تمّ استبدال ستالين بكوادر ومدراء، واستبدال النظرية الثورية بأرقام النموّ وتحقيق كوتا الانتاج؛ أصبح هوس المقارنة مع الغرب ومستوى الاستهلاك فيه مرضاً يستوطن المعسكر الشرقي ــــ مواطنين ونخباً. وحين انفتح المجال لنقد المؤسسات القائمة مع «غلاسنوت»، أصبح «الوصول إلى الغرب» هو حلم الجميع من دون اعتذاريات، وسادت قناعة بأنّ «النظام القائم»، أي الاشتراكية والاتحاد السوفياتي، هو الشيء الوحيد الذي يحول بين الناس وبين نمط الحياة في أوروبا الغربية. في المجلّات والصحف السياسية التي كنت تبيع ملايين النسخ في موسكو ولينينغراد، أصبحت «الخيارات الاشتراكية» بمثابة تهمةٍ أو كلمةٍ قذرة، ويقول زوبوك أنّه، حين ينظر اليوم إلى تلك المطبوعات، يُصدم بحجم النقد الذي كان يوجّه للإيديولوجيا الرسمية بكل أركانها في تلك الفترة، والاعتناق الكامل لليبرالية كخيارٍ أوحد، وذلك في بلدٍ كان لا يزال يحكمه الحزب الشيوعي. يمكن المحاججة، من منظورٍ ما، بأنّ الاتحاد السوفياتي لم يتمكّن من تجاوز عمليّة «نزع الستالينية» والبقاء بعدها. يروي المؤلّف أن غورباتشوف، وهو يخطب أمام عمّالٍ صناعيين من الإثنية الروسية، أراد الهجوم على الأفكار الانفصالية الصاعدة من حوله، فقال «هناك فكرة (بمعنى أنها فكرة غبية) بأنه يكفي أن تنفصل روسيا عن الاتحاد حتى تصبح، خلال سنتين، مثل أوروبا الغربية»، ولكن العمّال ما أن سمعوا هذه العبارات حتى بدأوا بالتصفيق والهتاف قبل أن يكمل غورباتشوف جملته، فاضطرّ لنهرهم بأن يوقفوا التصفيق ويفهموا مقصده.
حتّى من ظلّ يتكلّم باسم «الخيار الاشتراكي» في نهاية الثمانينيات من كوادر الحزب الشيوعي، يقول زوبوك، كان في حياته الشخصية يسعى بلهفةٍ خلف السفر غرباً والاستحصال على الجينز والإلكترونيات وباقي منتجات الغرب الصناعي. حين سقط جدار برلين عام 1989، كان خوف أميركا الأكبر هو أن يكون ثمن توحيد ألمانيا إعلانها «محايدة» وخروجها من حلف الـ«ناتو» (ما كان سيعني نهايته في أوروبا)، غير أن تنازلات غورباتشوف أدهشت الأميركيين؛ وفي شباط من العام التالي أعلن هلموت كول عن عرضٍ بتوحيدٍ نقدي للشطرين، يتضمّن استبدال الماركات الألمانية الشرقية القديمة في حوزة المواطنين بماركات ألمانية غربية، بنسبة واحدٍ إلى واحد (تخيّل أن يُعرض عليك استبدال ليراتك اللبنانية أو السورية بدولارات). هذا كان بمثابة عرضٍ لا يمكن رفضه «اشتروا» عبره، ببساطة، ألمانيا الشرقية من غير شروط. «أكبر رشوة جماعية في التاريخ الحديث»؛ حتّى أنّ الجنود السوفيات المرابطين هناك بدأوا بمبادلة ماركاتهم بالعملة الغربية. بحسب زوبوك، كان الكلام يكثر في الاتحاد السوفياتي عن «الحرية» في تلك الأيّام، ولكن الاستهلاك وأدوات الترف الغربية كانت «رمزاً ومحتوى، في آن، لمفهوم الحريّة». في لحظة سقوط جدار برلين، يضيف الكاتب، كان الآلاف من الناس يرقصون على بقايا الجدار محتفلين، ولكن الملايين من الألمان الشرقيين كانوا في الوقت نفسه يجوبون المتاجر الفخمة في برلين الغربية التي تفيض بالسّلع.
متّهمون ومذنبون
شاعت نظرةُ بعد السّقوط مفادها أنّ المجمع العسكري-الصناعي السوفياتي كان، بضخامته وكلفته الباهظة، من أهمّ أسباب الفشل الاقتصادي والانهيار. يكذّب زوبوك إلى حدٍّ بعيد هذه الفرضيّة. بدايةً، لم تكن ميزانيّة المجمّع العسكري-الصناعي يوماً قريبة من الأرقام التي كانت تتداولها المصادر الغربيّة في الثمانينيّات. ثانياً، مثّل المجمّع قاطرةً للتقدّم التقني والصناعي في البلد؛ ولكن ما هو أهمّ من ذلك هو أنّ هذا الجزء من الدّولة السوفياتية كان الوحيد الذي قام بـ«مهمته» المطلوبة: تمكّن من تحقيق التكافؤ العسكري مع أميركا، وطوّر السلاح النووي وأطلق «سبوتنيك» والبرنامج الفضائي، وأنتج ملاييناً من الباحثين على أعلى مستوى. من هنا قال أحد مساعدي غورباتشوف، محتجّاً على ما يحصل للجيش السوفياتي، أنّ هذه الانجازات العسكرية هي «كلّ ما نملك اليوم». في الحقيقة، يضيف الكاتب، كان كلّ دولارٍ يتمّ استثماره في المجمع له مردودٌ يفوق الدولار الذي يُنفق في مجالات مشابهة في أميركا؛ أمّا نزيف الاقتصاد الحقيقي، فقد كان في القطاع الزراعي وعشرات مليارات الروبلات التي تُنفق على دعمه، والصناعات التي تنتج أكواماً من السّلع لا يريدها أحد.
لا شيء مما حصل كان حتميّاً. لم تكن «الجمهوريات» التي استقلّت عبارة عن قوميات مقموعة حرّرت نفسها، بل إنّ أكثرها كان «واجهاتٍ» منذ أيام ستالين، لها دورٌ رمزي أكثر منه سياسياً
المثير هنا هو أنّ العلماء والباحثين في المجمع العسكري-الصناعي مثّلوا نواة المعسكر الليبرالي في الاتحاد السوفياتي في تلك المرحلة. نسبة كبيرة من كوادر «روسيا الديموقراطية» وغيرها من الحركات التي أوصلت يلتسين إلى الحكم ودفعت في اتجاه تفكيك الاتحاد كانت مكونة من أكاديميين وعلماء يعملون في المجمع، إضافة إلى «إنتلجنسيا» موسكو ولينينغراد. قد يبدو غريباً أن تدفع نخب النظام إلى تفكيكه، ولكن ذاك كان معنى النظام «النفعي-البيروقراطي» الذي أرساه خروتشيف وبريجينيف؛ حين يبدأ المركز بالانهيار، يسعى الجميع إلى «تسييله» لصالحهم: قادة الأحزاب الشيوعية في «الجمهوريات» يتحولون فجأةً إلى «آباء قوميين» لدول مستقلّة، في أوكرانيا وبيلوروسيا وآسيا الوسطى وأذربيجان؛ مدراء «شيوعيون» للمصانع يصبحون رجال أعمالٍ، حين وجدوا أنهم الأقدر على تأسيس الشركات الخاصة والإثراء في الظرف الجديد؛ والكثير من الخبراء والعلماء في المجمع الصناعي افترضوا أيضاً أنّهم في موقعٍ يسمح لهم بالتقدّم أكثر في عالم «ما بعد الاتّحاد». الحزين هو أنّه، بينما كانت هذه الفئات تتوهّم أنها تخوض «ثورة ليبرالية» في موسكو عام 1991 وتعيش لحظاتٍ «سحرية» في الشارع، كانت فعلياً تخدم طموح سلطويين انتهازيين وشعبويين على مثال يلتسين. من أوّل نتائج اصلاحات السّوق، يقول زوبوك، هو أنّ مئات الآلاف من ألمع الباحثين والعلماء السوفيات تحوّلوا إلى تصدير النفط واستيراد الإكترونيات. صحيحٌ أن بعض هؤلاء أثرى في رأسمالية يلتسين، أو هاجر إلى الغرب ونجح فيه، إلّا أن غالبيتهم تحوّلوا إلى مواطنين روس بائسين، يعانون آثار الفاقة والانهيار خلال التسعينيات.
ولكنّ مكاناً خاصّاً في اللائحة يجب أن يذهب إلى غورباتشوف. يجب أن نكرّر أن لا شيء مما حصل كان حتميّاً. لم تكن «الجمهوريات» التي استقلّت عبارة عن قوميات مقموعة حرّرت نفسها، بل إنّ أكثرها كان «واجهاتٍ» منذ أيام ستالين، لها دورٌ رمزي أكثر منه سياسياً. ولكن غورباتشوف بنى العملية السياسية حولها، وأعطاها سيادةً تنافس سيادة المركز. تحوّل القادة الشيوعيون الأوكران، حرفياً في يومٍ وليلة، من ماركسيين يدافعون عن وحدة الدولة إلى انفصاليين قوميين، حين وجدوا أنّ المركز قد انهار، ولديهم فرصة للّحاق بدول البلطيق والاندماج مع الغرب (فعلياً، كانت دول البلطيق الصغيرة هي الوحيدة من أقاليم الإمبراطورية السابقة التي تمكّنت من تحقيق هذا الحلم ودخول أوروبا والاندماج فيها).
غير أنّ تعامل غورباتشوف مع الغرب كان الكارثة الأكبر. ينتاب القارىء مزيجٌ من الشفقة والدهشة وهو يرى كيف يتمّ التلاعب بالزعيم السوفياتي من قبل نظرائه الغربيين. ينتشي بالمديح والقمم الخارجية فيما همّ بوش وكول وميتران الحصول منه على التنازلات، وتفكيك الترسانة العسكرية، وسحب الجيش السوفياتي من قواعده المتقدّمة. فهم الغربيون باكراً أنهم لن يحصلوا على زعيمٍ في الكرملين مثل غورباتشوف وكانوا واضحين في ضرورة «الحفاظ عليه» في السلطة لأطول وقتٍ ممكن. كتب سمير أمين عن الوهم الذي امتلك نخباً سوفياتية بأنّه، بمجرّد التخلّي عن الاشتراكية، فإنّ الغرب سيجعلهم شركاء ويمسك بيدهم ليقودهم صوب الديموقراطية والرخاء. في الحقيقة، بينما كان غورباتشوف يتكلّم عن انتهاء النزاع الدولي و«البيت الأوروبي المشترك» ويحصل، بالطّبع، على جائزة نوبل للسلام، كان سكوكروفت وجايمس بايكر يتجادلان فيما إن كان من الأفضل تفكيك الاتحاد السوفياتي بشكلٍ جزئيّ، أم أنه لا ضير في تركه يغرق في حروبٍ ويتشظى إلى عشرات الدول. في إحدى الاجتماعات في البيت الأبيض، اشتكى وزير الخزانة الأميركي من فكرة تقديم أي مساعدات أو قروضٍ لغورباتشوف (الذي كان يراهن عليها بشكلٍ أساسي لنجاح «بريسترويكا»). احتجّ الوزير بأنّ المطلوب حقيقةً هو «تغيير المجتمع السوفياتي» إلى درجةٍ لا يعود فيها قادراً على تحمّل كلفة المنظومة الدفاعية. في نهاية الأمر، لم يحصل غورباتشوف على القروض ولا المساعدات ولا عضوية صندوق النقد حتّى، بل كان في أواسط 1991 يتفاوض مع بوش لإرسال وجبات طعام الجنود الأميركيين، منتهية الصلاحية، لتوزيعها على الشّعب.
خاتمة: ضحايا السّقوط
من العبر الأساسية التي تهمّنا هنا هي أنّ الاتّحاد السوفياتي كان في قمّة قوّته العسكريّة حين سقط، ولكنّ ذلك لم يصنع فارقاً. على رغم التفوّق التقني والنوعي في العسكريّة الغربية إلّا أنّ الاتحاد السوفياتي كان قادراً على خسارة عشرة آلاف دبابة في «فالق فولدا» الألماني، ثمّ عشرة آلاف دبابة أخرى، قبل أن يخرج عشرين ألف دبابة غيرها من المخازن يُكمل بها اجتياح أوروبا. ولكن لا معنى للقوة إن لم يتمّ استخدامها؛ وقد راقب هذا الجيش الجرّار أميركا وهي تبني اقتصاداً دولياً يقصيه، وترعى حلفاء أثرياء في أوروبا وآسيا، وتكمل حصاره تكنولوجياً، من غير أن يصمّم أي ردة فعل تقلب الموقف. في الوقت ذاته، الجيش لا ينفع حين لا تقدر البيروقراطية السوفياتية، بعد سبعين عاماً على الثورة، على حلّ المسألة الزراعية ورعاية ريفٍ منتج، بحيث ظلّ اطعام النّاس همّاً للبلد الصناعي مترامي الأطراف. هي مسيرةٌ تشبه مسيرة غورباتشوف الذي انطلق وهو يمتلك السلطة المطلقة، وانتهى في آب 1991 وهو يقف ذليلاً أمام يلتسن، في مجلسٍ يرفع العلم الروسي، ويلتسن يقدّم له للتوقيع، تباعاً، ورقةً تحلّ رئاسة الوزراء وتعطي حقّ انشائه للجمهورية الروسية، وأخرى تضع كلّ ممتلكات وأصول الاتحاد السوفياتي في الأرض الروسية تحت تصرّف «الجمهورية»، وثالثة تنصّ على حلّ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي.
كانت من مطالب جورج بوش الأساسية أن يوقف السوفيات الدّعم عن الأنظمة التي تعارض الهيمنة الأميركية: كوبا، فييتنام، كوريا الشمالية، وغيرها. يذكّر زوبوك بمصائر هذه الدّول: النظام الأفغاني سقط بعد سنواتٍ قليلة، فييتنام تأقلمت على الطريقة الصينية، كوبا وكوريا الشمالية صمدت، بكلفةٍ ومعاناةٍ هائلتين. ولكنّ الضحيّة الأولى للسّقوط، بعد المواطنين السوفيات أنفسهم (يقول المؤلف أن نسبة الفقر في روسيا كانت حوالي الـ30 في المئة في الثمانينيات، فأصبحت بين 70 و80 في المئة بعد «تسييل» الاتحاد السوفياتي وعلاج الصدمة)، هم أهل منطقتنا. افتتحت مرحلة الأحاديّة القطبية عبر حرب الخليج وضرب العراق، وهي لم تكن حرباً محدودة ضدّ صدّام حسين، بل فاتحة مشروعٍ «لإعادة تشكيل المنطقة سياسياً» على حدّ قول زوبوك، وهي عمليّة لم تزل مستمرّة حتّى اليوم، وذهب ضحيتها ملايين العرب.



