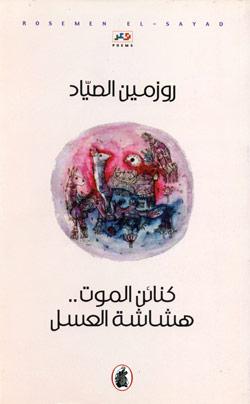بعد باكورتها «إلى رجلٍ قد يأتي» (2009)، يصلنا صوت الشاعرة السودانية روزمين الصيّاد (1982) معززاً بمجموعتها الثانية «كنائن الموت... هشاشة العسل» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر). الفصاحة بادية بوضوح في هذه التجربة الشابة التي تنقلنا إلى شعر جديد يكتب في مناطق نائية، ولا يجد مكاناً في العواصم الشعرية الرئيسية. نقرأ قصائد المجموعة باعتبارها منجزاً محلياً مُقصىً عن منافسة ما هو راهن في المركز. المحلية مشرعة على المفاجآت مثلما هي عرضة لممارسات شعرية يعافها التطور الذي لحق بالشعر. هكذا، تسمح المحلية لنا بتذوق مكونات وعناصر غير مستهلكة، وتضجرنا ـــــ في الوقت نفسه ـــــ بنبرتها المباشرة وبلاغتها القديمة. قد نطالع صوراً ومقاطع لافتة مثل: «نزعتُ رأس دميتي/ وضعته جانباً على الوسادة/ فلا بدّ أن ينام شخصٌ ما/ في ليل هذه الغرفة/ غير المتناهي»، أو «ليس سيئاً/ من يطفئ أعقاب سجائره/ على فخذيكِ نهاراً/ ويقبِّل ذات المِطفأة/ نهايات الليل»... لكن سرعان ما يعقب ذلك مقاطع عادية لا تلمس فيها إلا الفصاحة غير المثمرة: «لا يكتب تأريخ الموت/ إلا عُريُ رمال الصحراء/ ولا أكتب إلا ما يُمليه عُريكَ/ على المزامير الخائرة/ أفكر فيكَ أكثر مني/ تحتنكُني جهالة النقيض/ أُطأطئ جوفي/ ذاكرتي المجنونة/ ألعق ثدييّ/ وتيرة الدم التراب والدم». لعلّ البدايات تبرر وجود قصائد معقولة وأخرى عادية، إلا أن لجم اللغة المتعالية وإخضاع القصائد لقسوة أكبر قبل إجازتها للنشر كانا سيمنحان حيوية أكبر للمجموعة التي يُضطر القارئ فيها إلى قراءة صورٍ ذكية مثل «ريحٌ لم يرُقْها الخارج/ فبذرت رمسها/ في رئتي اليُسرى»، أو «أما زلتَ كالسفن التي/ تسلبُ الموانئ/ هناءة قيلولتها». لكنه، في المقابل، لا يجد تفسيراً مقنعاً لقصائد كاملة تخلو من أي بريق شعري، كما هي الحال في هذا المقطع: «ما زلنا نتأرجح/ على حبالنا الصوتية/ نسبر دُجَن الأصوات/ على دفتي القافلة/ صِفْري علامة القسمة/ الحادي الأخرسُ/ يمسك بالرسن وكأنّه/ فعلُ ثرثرته اليتيمة».
اللغة ذات الحساسية القديمة، ومعجمها المتجنب لمشهديات الواقع، تجعل الجيد والفج متجاورين في تجرية روزمين الصياد. الأرجح أن الاستمرارية ستكشف لاحقاً إن كان النوع الأول سيحتل مساحة أكبر، أو أن تجربتها ستظل محكومة بهذه الثنائية.
روزمين الصيّاد: أين البريق؟