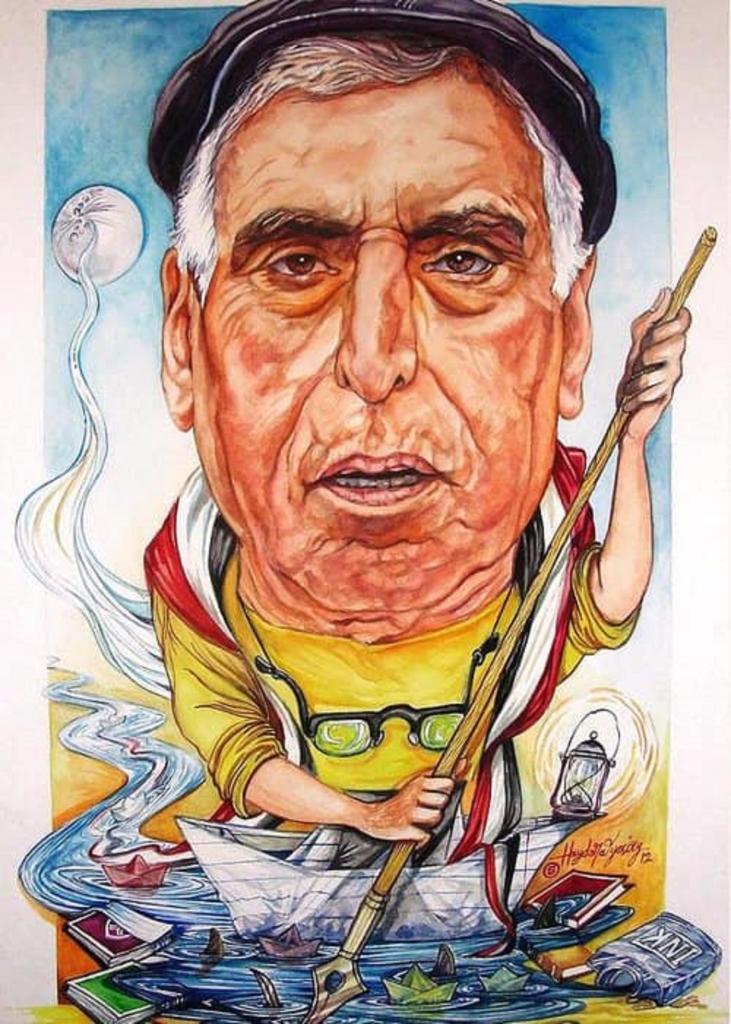
وتلك هي الرحلة الشاقة:
«بلادُ اللهِ واسعةٌ ولكنْ
يضيقُ العيشُ حينَ تقولُ: كلَّا
كأنَّ نُعومةَ الكَلِماتِ دربٌ
إلى النُّعمى وإنْ أمْسيتَ صِلَّا
تَعالَى الحقُّ يا وَلَدي فدعْنا
ندقُّ صنوجَنَا أعْلَى فأعْلَى»
هي ذي رؤيا سعدي وهذا قرع صنوجه الصاخب الذي لا تجدي معه «نبرة خافتة» هذه المرة لأنها ستبدو «نبرة خائفة أو خانعة». لذا، وصفها دجَّالو الثقافة وفقهاء المارينز بالخرافة ووصموا موقفه بالخرف، هذا هو الفارق النوعي لمحنة سعدي في رؤياه عن محنة رامبو في رؤياه الأخرى. لذلك، فإن فحص الجذور سيكون مهماً في هذا المقال، وأساسياً وفق بلاغة المقام ومقتضى الحال.
أن يتحوَّل سعدي يوسف منذ عام 2003 دريئة للطعن، فليس عن عبث، بل بدا أمراً منظَّماً وممنهجاً، وهو إذ طالَ كلَّ صوت ثقافي أعلن موقفه الرافض للاحتلال، إلا أن سعدي كان دريئة نموذجية (الدريئة الحلقة التي يتعلَّم عليها الهواة الطعن) ثم جيء بـ «الربيع العربي» فكتب مرثية للقذافي يعارض فيها مرثية أحمد شوقي لعمر المختار، وأعلن موقفه الصريح من الحرب على سوريا منذ وقت مبكر. فبينما كان الآخرون يتغنَّون بمناقب «ثوار حمص»، وصفهم سعدي بـ «مرتزقة فرنسيين أرسلهم ساركوزي إلى حمص» و«جهاديين يقاتلون باسمِ دينٍ للتجارة، والدعارة السياسية». وهكذا اكتمل احتشاد المصوبين على تلك الدريئة النموذجية ممن يجربون تعلّم الطعن في قامات مديدة وواضحة. كانوا «رجالاً» شوساً شاكي السلاح في مواجهة سعدي، لكن ما أن تتفحَّص معجمهم في توصيف الغزو الأميركي للعراق، حتى تجده يحفل بالمفردات المخصية أو الخنثى في أحسن الأحوال!: تحرير: تغيير سقوط إلخ. أو زاخرة بالدجل والرياء: «لا ننكر أهمية شعر سعدي لكن مواقفه...!» وما مواقفه؟ إنها ببساطة صرخته ضد احتلال بلده التي سارع المخدَّرون بحشيش الدولار الأميركي في غيبوبة الوعي إلى وصفها بالخرف!
لكن هل أتى على سعدي حين من الدهر لم يكن فيه إلا على هذا الموقف منذ الخمسينيات إلى أيامنا؟
تحوَّله منذ عام 2003 دريئة للطعن، بدا أمراً ممنهجاً، بعدما انتقد الاحتلال الأميركي والحرب على سوريا
لكنه «زمان القرود» بتعبير أبي نواس، فحين تتحدث عن المواقف من «القضايا المصيرية» ستبدو مثل هذه العبارة بالنسبة لدجالي العصر خرفاً أو خرافة أو «لغة خشبية». ومع هذا، لا ينبغي أنْ نذهب مع أبي نواس إلى الأفدح، فنخضع لزمانهم ونقول له: سمعاً وطاعة! لكنِّي أقول إن مواقف سعدي من هذه القضايا ليست طارئة أو وليدة هذا الزمن البُور، إنها في الواقع خضرة وثمار لأشجار تمتد جذورها لعقود، وترتبط بتجاربه الحياتية والنضالية، ففي عشرينياته كان الفتى الشيوعي في دمشق عندما رفضت حكومة شكري القوتلي عرضاً أميركياً للسلام مع إسرائيل والانسحاب من التحالف مع مصر عبد ناصر والاتحاد السوفيتي الشيوعي، وما أعقبه من تهديد تركيا وحلف بغداد بغزو سوريا، فانخرط مع الشيوعيين السوريين في حفر الخنادق حول دمشق في ما عُرف بأسبوع التحصين وحفر الخنادق حول عاصمة الأمويين في خريف عام 1957:
«في الـ 57
حفَرْنا، بأظافرِنا السودِ، خنادقَ حولَ دمشقَ...
بساتينُ الغوطةِ كانت بكثافةِ أدغالِ الأمازونِ
ومن أعلى جبلِ الشيخِ يسيلُ الماءُ زلالاً
بين أصابعَ مُفْعَمةٍ بترابِ الأرضِ.
....
كان زماناً ذهَباً
كنّا في الـ 57...
وكنّا، نحفرُ، مثلَ دمشقَ، خنادقَنا في الروح».
بعد نكسة حزيران 1967، سادت الشعر العربي بل الأدب عموماً لغة يائسة ونبرة انهزامية وسخرية تهكمية تجاه الحكام والشعوب على حد سواء. «بكائية لشمس حزيران» لعبد الوهاب البياتي و«هوامش على دفتر النكسة» لنزار قباني أبرز نموذجين لاتجاهات تلك المرحلة، بل إنّ جيلاً شعرياً عربياً صُنف نقدياً بـ «جيل النكسة» اتّسمت نصوصه بقنوط روحي وتشكيك في الوعي العربي وهويته. في تلك الفترة، كتب سعدي واحدة من عيون أشعاره التي تمزج بين منفاه الشخصي وأمله الجماعي «البحث عن خان أيوب في حي الميدان بدمشق». وفيها يرى بلمحة البصير ملامح أمل وإرهاصات مقاومة مستوحاة من الإرث الحضاري:
«تفتَّح لي خانُ أيوبَ، ما دلّني أحدٌ، غير أني دخلتُ، وبينَ حديقتهِ والدهاليز أبصرتُهُم
يصنعونَ القنابل ...
إنهم إخوتي، يرسمونَ دمشقَ على هضبة الله والاحتلال،
إنهم إخوتي، يرسمونَ على النَّهر أعمدةَ الجامع الأمويَّ جسوراً
جسوراً
جسوراً
جسوراً
جسورا
وقدْ ينسفونَ الجسورَ إلى الناصرة.
سأسكن في خان أيّوبَ، ما دلّني أحدٌ، غير أني اهتديت».
وفي الثمانينيات وفي وطيس الحرب العراقية الإيرانية ورغم موقفه الصريح ضد الدكتاتور وحروبه العبثية، إلا إنه انتفض منتصراً للبلاد دون أن يغفل هجاء الدكتاتور وحروبه، فكتب إثر احتلال القوات الإيرانية لمدينة «حاج عمران» الحدودية قصيدته: «إعلان سياحي عن حاج عمران» بتلك العبارة الصادحة الجارحة «يا بلاداً بين نهرين بلاداً بين سيفين» وصولاً إلى عراق الحصار والحروب والمنفى بل التيه الأكبر في التسعينيات حيثُ بدأت المرحلة الأخطر والأكثر مرارة في تاريخ الشقاق العراقي حول مصير البلاد ومستقبلها. ففي عام 1999، عقد مؤتمر المعارضة العراقية في نيويورك تلاه في عام 2002 مؤتمر المعارضة العراقية في لندن اللذان كانا تمهيداً سياسياً لغزو العراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما عام 2003. ولم يكن الغزو مُسوَّغاً أخلاقياً على صعيد الضمير العالمي، لكنه وجد تمهيداً نوعياً مقروناً بتوطئة بلاغية ممن سميتهم «فقهاء المارينز» وديباجة ثقافية عراقية لتسويغ الغزو أخلاقياً! بل بينهم من أصبحَ كشافة أو طليعة في ذلك الغزو، فقد كتب شاعر عراقي في جريدة «المؤتمر» الصادرة في لندن آنذاك عموداً تحت عنوان «مقترح أخير». وتحت ذريعة أن خيرات العراق (يقصد النفط) بدّدها الدكتاتور في حروبه العبثية وقمعه للشعب العراقي، لخَّص مقترحه الأخير بأن نتيح للأميركان وحلفائهم أن يستولوا على تلك الخيرات ونجرب «التعامل» مع أطماع العالم الخارجي بخيرات العراق! وكتب مثقف آخر بصراحة أكثر في الجريدة نفسها (قادمون في قطار الأميركان أو على حمار طالبان) وسواهما العشرات.
في تلك السنوات، كان سعدي في سنواته الأولى في لندن، وكتب هناك دواوينه «قصائد العاصمة القديمة» و«حياة صريحة» و«شرفة المنزل الفقير» وجميعها كتبت قبل الاحتلال الأميركي للعراق. وفي القصيدة الخامسة من «قصائد العاصمة القديمة» التي اشتهرت باسم «جواميس القيامة»، حذّر من صفقة فاوستية لاغتيال العراق يكون أحدَ طرفيها العراقيون المنفيون في «متاهة لندن» الذين خاطبهم مباشرة ووصفهم أيتاماً في مأدبة مسخَّمة ينتظرون «تجار خيبر» ليبيعوا لهم الأرض والإنسان. في تلك القصيدة - اللحظة اختار سعدي أن يكون الطفل الذي «يخبرهم بما لن يسمعوا»، ثم شبَّههم في قصيدة «رقصة الفالاشا» في ديوانه «شرفة المنزل الفقير» بـ «يهود الفالاشا» ينتظرون «الريح المؤاتية» في المنفى لترحيلهم أو «عودتهم» إلى أرض الميعاد! وكتب في نفس الديوان هجاء بسخرية سوداء لنموذج الحالمين بعرش العراق في قصيدة «أمير هاشمي منفي في لندن». ووصف مؤتمر المعارضة في لندن «عرس بنات آوى». وبعد احتلال العراق بأيام، تزاحم أكثر من 350 مثقفاً عراقياً في سابقة لم تشهدها ثقافة أمة في التاريخ بأن يوقع مثقفوها على رسالة شكر لمحتلي بلادهم، وجهوها لبوش وبلير يعاهدونهما فيها «إن أرواح الجنود الأميركيين والبريطانيين والإيطاليين والإسبانيين والبولونيين واليابانيين والأستراليين والحلفاء الآخرين ستبقى حية بيننا تشهد على أمثولة التعاضد والمساندة بين البشر الذين يعون أن الكوكب الأرضي وطن واحد وأن مصيرهم لم يعد مجزأً»، بينما كتب شاعر عراقي في جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية مقالاً بعنوان: «الأميركيون والبريطانيون أبطال وجنودهم «شهداء» عراقيون» ودعا لإقامة تماثيل لهم لأنهم حرَّروا العراقيين!
أيةُ صرخة أو أي هجوٍ جديرين بهذا التدنِّي الأخلاقي؟ سوى ما كتبه سعدي في ديوانه «صلاة الوثني» الذي صدر بعد الاحتلال الأميركي للعراق مباشرة، وكذلك في كتابَيه النثريَّين «يوميات الأذى» و«يوميات ما بعد الأذى» اللذين ضمَّا مقالاته بعد الاحتلال، كتب بلغة فجة ومباشرة وهجائية مقذعة لأنه رأى تلك الفجاجة ضرورية في هذا الزمن وبأبطاله المزيفين وتليق بهم وبزمنهم، لكنه كتب بأسى أيضاً على نمط «الموَّال» وهو في «القطار الإيرلندي» مُستعيداً لغته وتقنياته وذكرياته في السجون في قصيدة «الأول من أيار» التي كتبها في السبعينيات:
أرضُ السواد انتهتْ للشوكِ والعاقول
كلُّ الجيوشِ اقتضتْ منها وحالَ الحول
يا حسرتي للضمير المشترى المقتول!
لقد كانت محفلاً شريراً ووليمة ضوارٍ وكان سعدي يعرف قدماً ودوماً أنهم ذاهبون إلى تلك الوليمة:
«غادر الشعراء.
-أين؟
إلى الوليمة
-كلهمُ؟
كلُّ الذين عرفتهم»
لكن السؤال الذي لن يكون أخيراً: ما الذي بقي لهم من الوليمة الفاسدة؟ سواء كانوا ضواري أم حواري، أم جواري؟ مخدَّري الوعي أم قتلة؟
وفي المقابل ما الذي يبقى لسعدي الذي عاش بشروطه ورأى وروى ما رأى ليبقى ما قاله حريزاً عزيزاً:
«لكمُ كلُّ ما هو فوقَ الترابْ
ولنا كلُّ ما هو تحتَ الترابْ»
* شاعر عراقي
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا


