
خلال مقابلة معه، يستنكر موران ما ورد في مقابلة أخرى مع ايمانويل ماكرون، ظهرت في مقال نشرته صحيفة «لو موند» تحت عنوان «الإرهاب والشعبوية». آنذاك، كان الرئيس الحالي وزيراً للاقتصاد، صرّح باختزالية يتّسم بها المصرفيون عموماً «الحل الاقتصادي». لا يعلّق موران على القشور. رغم أنه عاصر موجة «السترات الصفر»، ما يهمّه هو البحث عن المفهوم في الأزمة، لأن بقاءها معلقة على حبل رخو لا يخسر المفردة قيمتها الألسنية وحسب، بل يميّع المعنى الذي تكتنفه وهو كثيف في جميع الحالات. هكذا ردّ على التبسيطية الماكرونية بهدوء، معترفاً بالبعد الاقتصادي كأحد ظواهر الأزمة، لكنه ذكّر وزير الاقتصاد ــــ الذي يمثل مجموعة حاكمة في العالم على أي حال ــــ بأنه بات واضحاً، أن الفرد، أو مجموعة الأفراد، لا يُدفع نحو الإرهاب فقط لأنه يتضور جوعاً أو لأنه لا يملك ثمن حذاء. المفارقة أن المقابلة مع موران كانت قبل موجة المقالات التعيسة، التي نظرت إلى «السترات الصفر» نظرة ضيقة ومن الداخل، ولم تأخذ في الاعتبار البعد الحضاري للأزمة.
هناك أزمة عميقة للبشرية وهي لا تدرك أنها أزمة إنسانية. ولكن ما هو أنكى، أن بعضهم لم يتردّد في الحديث عن عولمة سعيدة. في كتيبه الصغير، يمكن أن نجد حيزاً قابلاً للفهم حسب «أزماتنا» العربية الصغيرة ضمن عالم الأزمات الكبير. فالعلاقات المتبادلة نقطة جوهرية لفهم الثورات العربية. هذه العلاقات المتبادلة بين العناصر، الأشياء، الكائنات، تفترض وجود إمكانات ارتباط أو لعبة تجاذبات وانسجامات. ويستعير موران هنا المنهج العلائقي من فوكو، لكن ليس لتحديد ديناميكيات السُلطة، إنما لتفكيك ديناميكيات الأزمة. سرعان ما يكتشف أن انعدام أيّ قوة إقصاء وتنافر، سيؤدي إلى تجمع يسوده الارتباك، ولا يمكن تصور أي نظام. ما يمكن الاستفادة منه في عمل موران هذا، لفهم العلاقة بين الأنظمة والشعوب، يدور حول هذه الشبكة العلائقية تحديداً. ذلك أن وجود «نظام» يفترض الإبقاء على الاختلاف، ما يعني الإبقاء على قوى تحافظ على الأقل على شيء أساسي من العناصر الكافية لتشكيل علاقة متبادلة، ومن ثم الإبقاء على قوى الإقصاء والتفكيك والتنافر متوازنة أو محيدة. وإن كان موران يكتفي بالعرض والتحليل، فإن منهجه برأي كثيرين قد يكون ملهماً للشهوات السُلطوية. بيد أنه يستبق هذه التحليلات ويوضح في أمكنة متعددة أن «كل نظام محكوم بالهلاك والتفكك». وهذه ليست بالضرورة دعوة أناركية كلاسيكية، لأنه يحاول إيجاد مدارك لدمج واستخدام التضادات بطريقة تنظيمية.
قبل فوكو ومنهجه الصارم، يواصل موران استعاراته الفلسفية على نحو متقن: إن الإنسان بما هو شبكة تناقضات يعدّ ما يمكن تسميته بـ«حيوان أزمي». وشبكة تناقضاته هي مصدر إخفاقاته ونجاحاته واختراعاته، وهي مصدر عصابه الأساسي. لكن لكي يستعيد مفهوم الأزمة معناه، تجب مواصلة عملية التأزيم، ووضع مفهوم الأزمة نفسه في أزمة، أي في موقعه الطبيعي.
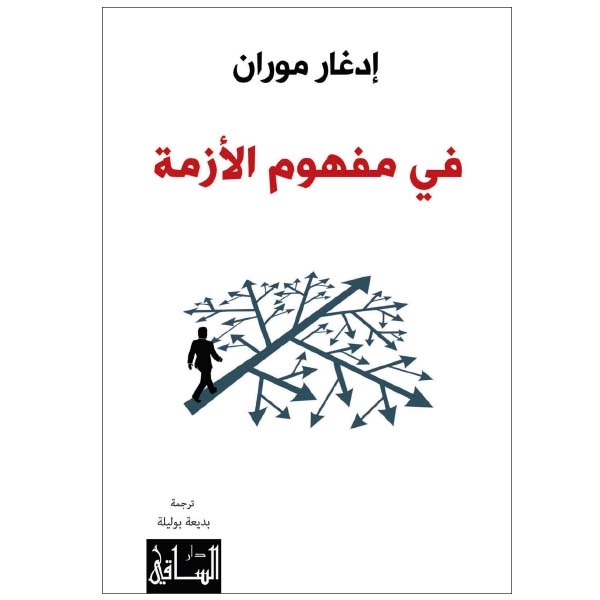
وربما يكون المكان الطبيعي غالباً هو المجتمع. ذلك أنه وفي المجتمعات التاريخية، تصبح بعض الارتجاعات الإيجابية مثل النمو الاقتصادي أو تقلص حدة التوترات داخل المجتمع - رغم حفاظها على سمتها الإيجابية - قابلة لمراكمة آثار جانبية تكون مع بعضها مصادر اضطرابات تتكاتف وتشكّل أزمة. النمو الاقتصادي ليس نمواً على أساس المساواة، والتوتر الاجتماعي لا يضمحل بطريقة عادلة إنما وفق حسابات غير متكافئة. وهكذا تتناسل الأزمات، إضافة إلى ازدياد الفوضى وغياب اليقين، وهما أمران لا مفرّ منهما يتركان أثراً عميقاً بدورهما في النظام. ذلك أن كل نظام حيّ، وبالتحديد عندما يقصد موران الأنظمة الاجتماعية، يتضمن فوضى داخلية، تلعب دوراً في تشكيله وتأسيسه. لكن النظام يعمل في موازاة نقيضه: الفوضى. يعمل بسببها حيث يصير وجودها مكمّلاً لوجوده وسبباً له، ويعمل معها لضخ الحياة في لعبة الوجود بحد ذاته. يستنتج موران أن الفوضى ليست جسماً صلباً يمكن الإشارة إليه، بل إنّ جزءاً منها لا يتحدث، وقابل للانفجار، وهذا الجزء نفسه مصحح ومدمج. الأزمة هي طفرة الفوضى في النظام على حساب الأجزاء الأخرى، بما فيها الحتميات والاستقرار والقيود الداخلية.
العلاقات المتبادلة نقطة جوهرية لفهم الثورات العربية
لغير المهتمين بالفلسفة، سيبدو الكتاب غامضاً، ولكنه للمهتمين بالفلسفة قد يبدو غامضاً أيضاً. ولكن الغموض لا يسبب أزمة، على الأقل بحسابات موران نفسه. فنحن في مجتمعات تتطور بسرعة، وهذا التطور يؤدي إلى اضطرابات وإلى غياب الاستقرار. لا يشير الكاتب إلى ذلك، لكن الغموض الذي يرافق التطور، يدفع إلى الخوف، وقد يكون الخوف في الحاضر هو سبب الأزمة، قبل أن يستوي في شكله الحقيقي كأزمة خالصة بعد تبين تداعياته. التطور المستمر، انطلاقاً من لحظة معينة، يمثّل أزمة أيضاً.
من الناحية العملية، وكجزء من عملية الالتفاف على الأزمة، يحاول موران التأسيس لإطار نظري جديد، أو لمبحث خاص في العلوم، هو «علم الأزمات». لكن الطريق ما زال طويلاً للعلم الذي يتحدث عنه المفكر الفرنسي، خاصة أنّ هذا العلم الذي يقصده، يجب أن يتضمن طريقة ملاحظات شبه سريرية، تكون بذاتها مرتبطة بأخلاقيات. كل ميادين العلم والعالم يجب أن يبحث في الأزمات، فالعالم بحد ذاته أزمة. وربما تكون الأزمة الأصعب هي عدم الاعتراف بوجود أزمة، مثلما أن موت النظام كي يصير تاماً، يتطلب إعلان هذا الموت.


