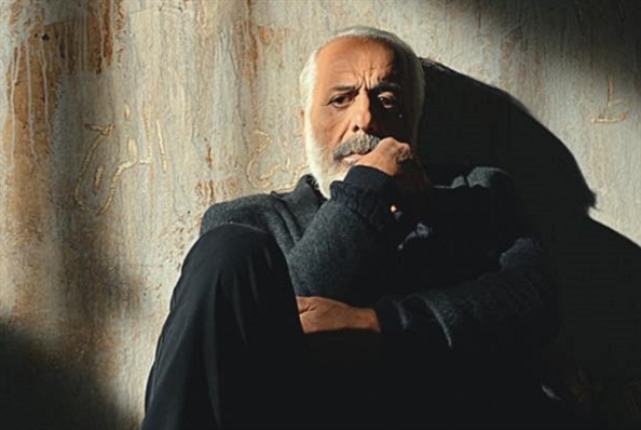عائلة الأستاذ زياد يعاندها القدر، وتعبث بمصائرها الحرب، فتصيب شاباً وتقطع له ساقه، وتُفقد الصهر نظره، لكنّها تعجز أن تجهز على صبر الأستاذ العصامي، واعتكافه في قريته حتى بعد أن توضع له إشارة على باب بيته من المسلحين هم أنفسهم طلابه الذين أفنى عمره مقابل تعليمهم. المصير المحتوم يأتي بعد أن تقع ابنته في غرام شاب يلتحق بالمسلحين، فيجابه خياره برفض حبيبته. وفي ليلة تخلّيه عن أصوليته وقراره إلباسها محبس الخطوبة، يقتحم المسلحون المكان، ويقتادونه مع حبيبته. سيتوه المشاهد هنا عند النقلة إلى المكان الآخر الذي لجأ إليه زياد وهو يتأهب لدخول المسلحين ليلة زفافه على مديرة المدرسة هناك. نعود برفقة بزياد الذي يلاحق أثر ابنته، فيجدها قد سلكت درب السماء مشنوقة مع حبيبها ومعلقة في ساحة القرية. هنا تقرر ابنته الثانية السفر مع حبيبها في البحر، فتبتلعها المياه الإقليمية كما فعلت مع الكثير من مواطنيها. تتجلى عند هذا المفصل المقولة القاسية لزياد وهو يردّد بصوت الراوي: «أنا بغل طاحون الحرب... قدّمت ابنتيّ واحدة للقبر، والثانية للبحر».
أسهم الفيلم في التعريف بمعاناة جرحى الحرب
فعلياً يكمن الجوهر الحكائي والذروة الدرامية في النهايات المصنوعة لتعدل مزاج المتفرّج، وتجعله يعيد تقييم ما شاهده، بعد استهلال ممل، لافتقاره التصعيد الدرامي اللازم، وانصرافه نحو المقولات المثقفة بعيداً عن بناء حكاية تسهم في جذب المشاهد وشدّه وتوريطه في اللعبة، وصولاً إلى النهايات الصادمة. إضافة إلى ذلك، غرقت بعض الحوارات في التعبير الإنشائي المستهلك، الذي لم يأخذ في الاعتبار تقلبات الحالات الإنسانية والنفسية عند الشخصيات ورجوعها في لحظات الغضب مثلاً إلى حالتها الفطرية، بعيداً عن مدى ثقافتها أو مستوى تحصيلها العلمي. في المقابل، أتاحت مناورات الفيلم ومحاولاته القبض على الجدة والطزاجة التعريف بمعاناة جرحى الحرب بدءاً من الضرير الذي يرى بعيني رفاقه، وصولاً إلى شخصيتين تتناوبان على تبادل ساق اصطناعية. على المستوى الأدائي، بدت التجربة موفقة لكل نجومها، فيما لفت محمد الأحمد مشاهديه بمقترح متماسك لأداء شخصية الضرير. كذلك، أعطت نور علي طاقة مضافة من خلال إيمانها العميق بما تقدّمه، وجرعات الصدق الواضحة في أداء سهل وبسيط ومقنع من دون تكلف أو افتعال وتصنّع. كذلك، حقق جابر جوخدار الغاية من الأداء من دون ترك فرصة لاكتشاف خدعة الساق المبتورة وتركيب واحدة اصطناعية بدلاً منها. ورغم حبس المخرج في حقل واضح المعالم بسبب المخطط الإنتاجي، وربما إجباره على الخوض في مواضيع مهما افترقت تظلّ متشابهة، إلا أنه يمشي بشريطه هذا خطوة واضحة في البناء المتمايز للهوية البصرية والحلول الإخراجية. لا شيء هنا يشبه أفلامه السابقة، كما أن التسلسل الحكائي يفقده الإمكانيات الوافية لاستعراضات مبالغة في حركة الكاميرا. مع ذلك، ظلت اللغة البصرية عبارة عن منجم للدلالة، معتمدة في بنائها وإيحاءاتها على مشاهد واقعية من التغريبة السورية، مرّة لنزوح جماعي، ومرات لوداعات موحلة، وفراقات متكرّرة. أما لجهة التنقل بين الزمانين والمكانين، فقد تم تبنّي حلّ كلاسيكي سهل يمكن التقاطه رغم التشابه الصريح في البيئتين اللتين يقدمهما الفيلم والزمنان أيضاً.