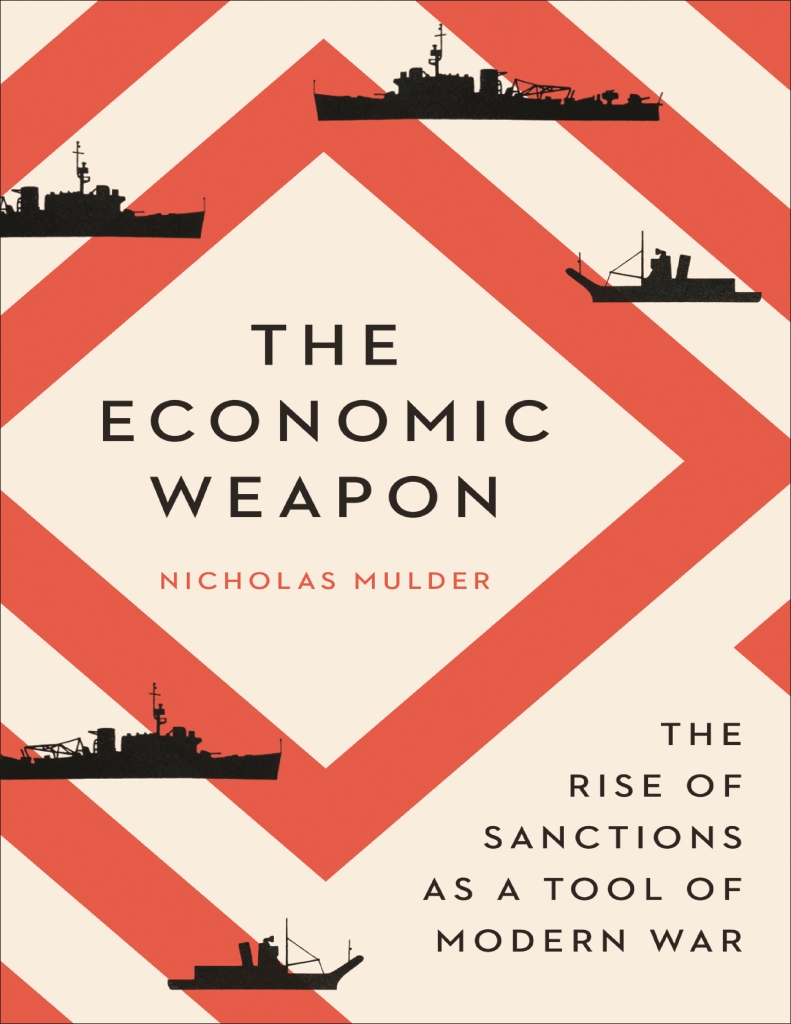
أراد المؤمنون بالأممية، أو «الأمميون»، بين الحربين العالميتين، الحفاظ على السلام. لكن بما أنهم لم يتمكنوا من محو ذكرى معاناة المدنيين التي سبّبتها الحصارات في زمن الحرب العالمية الأولى، قرروا تبني إرث العقوبات بدلاً من ذلك. كان هذا هو أصل فكرة الردع بالعقوبات. إن معرفة أهوال الماضي من شأنها أن تُبقي منتهكي القانون في المستقبل تحت السيطرة. عمل الردع بالعقوبات على الحفاظ على السلام في البلقان خلال العشرينيات. لكن بعد الكساد الكبير، مع تصاعد التنافس الإيديولوجي والعسكري، تعرّضت البلدان إلى ضغوط عدة.
لم يتخلَّ «الأمميون» عن الإكراه الاقتصادي كوسيلة لفرض الأمن الجماعي في الأربعينيات. لكن كان عليهم خوض حرب عالمية أخرى أكثر تدميراً قبل أن يتمكنوا من وضع سياسة العقوبات على أُسُسٍ أكثر صلابة.
بعيداً من كونهم دعاة سلام، كان «الأمميون» الليبراليون في أوائل القرن العشرين قلقين من استخدام القوّة. في نظرهم، حطّمت الحرب العالمية الأولى الاعتقاد القديم بأن الناس مسالمون بطبيعتهم وأن حكامهم هم العدوانيون. كان ابتكار العقوبات هو بمثابة اعتماد شامل على الحرب الاقتصادية لتخويف الشعوب ولكبح أمرائها. وقد حوّل أنصار العقوبات في فترة ما بين الحروب، مفهوم الدولة الليبرالية، ودافعوا عن عصبة الأمم، وهاجموا الحياد، وشجبوا الأعمال العدائية، وبرّروا سياسة التهديد وتطبيق الإكراه ضد المدنيين. كان هذا تحدياً سياسياً هائلاً، وليس من المستغرب أن هذا المشروع لقي مقاومة منذ البداية.
لكن تقبّل العقوبات لم يكن قط مسألة قانونية فقط. منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح من الواضح أن العقوبات تعتمد على أساس الموافقة العامة. يمكن للإكراه الاقتصادي أن يجد مكاناً في السياسة إذا كانت أهدافه وأساليبه تتمتع بالشرعية. وقد أعطت المنظّمات المتعدّدة الأطراف، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، العقوبات، شرعية لم تستطع عصبة الأمم بين الحربين العالميتين أن تعطيها. ونظراً إلى أن العقوبات أصبحت أداة مقبولة لدى المؤسسات الدولية الليبرالية، فقد تراجعت عقَبات استخدامها.
يؤكد تطبيع العقوبات كجزء من الواقع اليومي للسياسة الدولية على عواقب صعود الولايات المتحدة كقوّة عالمية في القرن العشرين. ومن المفارقات التاريخية أن الدولة التي عارضت بشدّة العقوبات الاقتصادية، بين الحربين العالميتين، كانت أكثر مستخدميها نهماً على مدى العقود السبعة الماضية.
تشكّلت العقوبات الأميركية من خلال ثلاثة عوامل: هيمنتها العسكرية الفريدة، والتحول الإيديولوجي الناتج عن سياسات الحرب الباردة، ودور الأسواق المالية الأميركية في الاقتصاد العالمي. فرضت الأسلحة النووية والقوّة الجوية الاستراتيجية، تصوّر الردع على نطاق عالمي ووجودي، وهو الشيء الذي كافح السلاح الاقتصادي بين الحربين لإبرازه. لكن الأسلحة النووية أعطت أيضاً «حروب السلام» الاقتصادية فرصة جديدة للحياة. فقد أدّى خطر التصعيد النووي إلى عودة أشكال القوّة التي لا تشعل حرباً بالمعنى التقليدي، إلى الواجهة، كطرق لإضعاف الدول المعارضة. فاستخدمت الكتلة الغربية الرأسمالية قوتها الاقتصادية لطحن النمو الطويل الأمد للكتلة الشرقية الاشتراكية. وقد حدث هذا الاحتواء من خلال تدابير متعدّدة مثل إنشاء «لجنة التنسيق لضوابط الصادرات المتعددة الأطراف» (CoCom). وعلى مستوى السياسة الوطنية، طوّرت حكومة الولايات المتحدة عمل لجنة التحكّم في الأموال الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة. وخلال الحرب الكورية، تمت إعادة تسميتها وتوسيعها إلى «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» (OFAC)، وهي الوكالة التي لا تزال تشرف على سياسة العقوبات الأميركية حتى يومنا هذا. في وقت كتابة هذا الكتاب، كانت هذه الوكالة تفرض عقوبات على أكثر من ستة عشر ألف فرد ومنظمة.
في الوقت نفسه توسّعت أهداف الضغط الاقتصادي أيضاً. فقد ركّزت عقوبات ما بين الحربين العالميتين على الهدف الخارجي المتمثّل في وقف الحرب بين الدول. إلا أن العقوبات بعد عام 1945 كان لها أهداف داخلية تخصّ الدول المستهدفة، مثل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وإقناع الأنظمة الديكتاتورية بإفساح المجال للديمقراطية، وخنق البرامج النووية، ومعاقبة المجرمين، والضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، أو الحصول على امتيازات أخرى. ونظراً إلى أن المعايير الدولية الليبرالية قد تم تحديدها من قبل دول التحالف العابر للأطلسي، فإن أهداف العقوبات هي مؤشر إلى الاهتمامات السياسة الخارجية المتغيرة لهذه الدول. فاستهدفت عقوبات وحصارات الحرب الباردة الدول الاشتراكية مثل الاتحاد السوفياتي والصين الشيوعية وكوريا الشمالية وكوبا وفيتنام. كما دفعت الثورة الإسلامية الإيرانية، إلى حملة ضغط اقتصادي أميركي على الجمهورية الإسلامية استمرت أربعة عقود وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، وكان لها تأثير متباين على أهداف وسياسات طهران. بالإضافة إلى دول إسلامية أخرى فُرضت عليها عقوبات دولية وأميركية كبيرة مثل السودان بعد عام 1989 وليبيا بعد عام 1992. شكّلت هذه الجهود جزءاً من تحول أوسع في التسعينيات نحو احتواء وإسقاط «الأنظمة المعارضة».
تنبثق الهيمنة الأميركية بالقدر الأكبر من ريادتها الدولية في الهياكل المؤسسية والتنظيمية والتكنولوجية والمالية، وهي مجموعة من القدرات التي أصبح صانعو السياسات ينظرون إليها على أنها أدوات لـ«فن الحكم الاقتصادي». التمويل، بشكل خاص، هو قناة قوية للضغط. تماماً كما رأى هاوتري، ستراكوش، وكينز مدينة لندن كمركز أساسي للعقوبات في العشرينيات، فإن الدور المحوري لـ«وول ستريت» في النظام المالي العالمي منذ السبعينيات، قد وفّر أدوات ضغط كبيرة أمكن لصانعي السياسات استغلالها. ويعود هذا الأمر لكون الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى والوسيلة الأكثر شيوعاً للتجارة العالمية وإصدار الديون، وتندرج شريحة واسعة من الأسواق والشركات الدولية تحت الولاية القضائية الأميركية بطريقة أو بأخرى. وقد تعمّق هذا الاعتماد كسلاح من خلال التدخّلات غير المسبوقة للاحتياطي الفيدرالي منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008. واليوم، أصبحت المصارف العالمية وتمويل الشركات في طليعة أدوات تنفيذ العقوبات. إن حدود استخدام واشنطن لهذه القوّة المالية هي قيود سياسية، ولا تعتمد على بنية تحتية بطبيعتها. وقد أظهر صانعو السياسات في الولايات المتحدة براعة ملحوظة في إتقان العولمة الاقتصادية. لكن التحدّي الذي يواجهونه هو ترجمة هذه المهارة التقنية إلى نتائج مفيدة في العالم الحقيقي.
يقودنا هذا إلى نقطة أخيرة بشأن العقوبات: الفرق بين الآثار الاقتصادية والنتائج السياسية. يتكرّر الجدل السياسي حول العقوبات كل عقد تقريباً، منذ إنشاء عصبة الأمم في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كان في جوهر هذا النقاش السؤال الدائم: هل العقوبات الاقتصادية مُجدية؟ بينما يختلف معدل النجاح اعتماداً على الهدف، فإن السجل التاريخي واضح نسبياً: معظم العقوبات الاقتصادية لم تنجح. في القرن العشرين، كان استخدام واحد فقط من بين كل ثلاثة استخدامات للعقوبات «ناجحاً جزئياً على الأقل». ويتوضّح أن الأهداف الأكثر تواضعاً للعقوبات كان لديها فرص أفضل للنجاح. ولكن ما توضّحه البيانات المتاحة أيضاً أن تاريخ العقوبات هو إلى حد كبير تاريخ مليء بخيبات الأمل.
استخدمت الكتلة الغربية الرأسمالية قوتها الاقتصادية لطحن النمو الطويل الأمد للكتلة الشرقية الاشتراكية
لكنّ التركيز على ما إذا كانت العقوبات لها فعالية في تحقيق أهدافها فذلك سيكون بمثابة إخفاق في التقاط آثارها الهائلة على التاريخ السياسي والاقتصادي للعالم. من الضروري التمييز بين هذه الجوانب. يقدم تاريخ عقوبات ما بين الحربين العالميتين أمثلة ممتازة على التناقضات والعلاقة بين الفعالية والتأثيرات الاقتصادية. غالباً ما اعتبر مراقبو فترة ما بين الحربين التأثير المرعب للحصار على أوروبا الوسطى كدليل على أن هذه السياسة كانت ضرورية لنصر الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. وكانت التأثيرات الاقتصادية تُربط بالفعالية من دون التحقيق في الروابط المعقّدة بينهما. كان الخلط مفيداً سياسياً لأنه عزّز الثقة في قدرة عصبة الأمم على الحفاظ على السلام بسلاحها الاقتصادي. مع ذلك لم تكن التأثيرات الاقتصادية شرطاً مسبقاً للفعالية.
الجانب نفسه من العقوبات الاقتصادية الذي يجعلها جذابة فلسفياً لليبرالية العالمية، أي اعتمادها على المنطق الإنساني الاقتصادي (Homo Economicus)، هذا الجانب نفسه يحد أيضاً من بروزها. العقوبات الاقتصادية لا تعكس القوة المادية فقط. إنها تعرض القيم السياسية والاجتماعية والثقافية. لا شك في أن العقوبات ستعمل بشكل أفضل في عالم يتسم بالعقلانية بشكل تام، ولكن هذا ليس العالم الذي نعيش فيه فعلاً. يتخذ معظم الناس في معظم الأماكن اختيارات جماعية على أساس مجموعة واسعة من الاعتبارات. قد يكون السلاح الاقتصادي شكلاً من أشكال السياسة، لكن بوسائل مختلفة. ولكن في نهاية المطاف، إن غرس العداء في نسيج الشؤون الدولية والتبادل البشري له فائدة محدودة في تغيير العالم.
* من كتاب «السلاح الاقتصادي: صعود العقوبات كأداة للحروب الحديثة»


